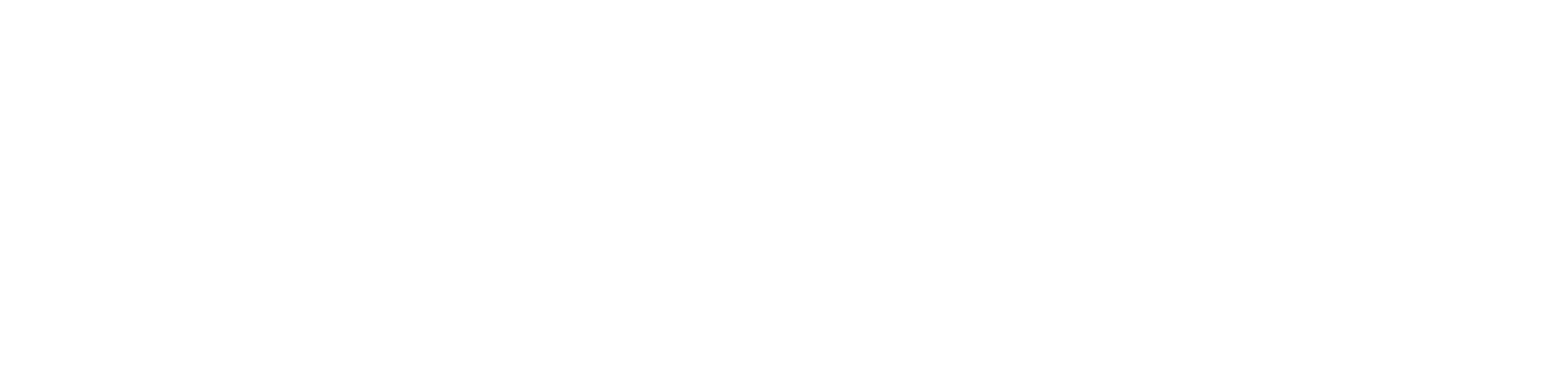آفة سوء الظنّ وآثارها الاجتماعية
الخطبة الأولى
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم.
إن أخطر ما يواجه المجتمع ويقوض أسسه ودعائمه وأركانه هو أن يدّب فيه داء سوء الظن وأن يسود الخوف والتوجس والريبة بين أفراده ومجموعاته، تصوروا مجتمعاً تسيء فيه الزوجة الظن بزوجها أو الزوج بزوجته، أو الأخ بأخيه أو الجار بجاره أو العامل بعماله، أو الحاكم بمحكوميه أو المحكومين بحاكمهم أو الجماعة تلك.. فمن الطبيعي أن هذا المجتمع لن يعرف الاستقرار ولن يكتب له البقاء.
وقد أشار القرآن الكريم في الآية التي تلوناها إلى أن آثار سوء الظن لا تقف عند نتائجه المدمرة على تماسك المجتمع حتى ورد في الحديث: "مَنْ غَلَبَ عَلَيهِ سُوءُ الظَّنِّ لَم يَترُكْ بَينَهُ وَبَينَ خَلِيل (صديق) صُلحَاً".. ومن هنا جاء ربط القرآن بين سوء الظن والتجسس والغيبة.
فسوء ظنه يدفع بصاحبه إلى التجسس على من أساء به الظن وغيبته والتحامل عليه وصولاً إلى بهتانه.
والمقصود بسوء الظن هو أن يحكم الناس بالسوء على نيات بعضهم البعض أو ما يصدر منهم من أقوال وأفعال أو موقف من دون أن يستندوا في ذلك إلى دليل أو حجة.. هم يحكمون في كل ذلك على الظن أو على الشك أو الاحتمال.
وأسباب سوء الظن كثيرة قد تعود إلى سرعة الأخذ بالأقاويل والشائعات والحكم على المشاهدات، والكثير هم الذين يبنون أحكامهم على ما قيل أو ما رأى بدون تدقيق وبحث وعلى الظن والشبهة.. وقد يعود ذلك إلى سوء سريرة الظان فيعكس السلبيات التي يعاني منها في سلوكه أو في أخلاقه أو في إيمانه على الآخرين ويراها فيهم.. فلأنه كاب أو خائن أو غشاش يرى الناس من حوله كاذبين وغشاشين وخائنين.
وقد ينشأ سوء الظن من أسلوب التعميم الذي يعتمده البعض في محاكمة الناس.. حيث يعممون التجارب المرة التي عاشوها مع الآخرين على بقية الناس بدون أساس.. فهم إن أحسنوا إلى بعض الناس وساعدوهم وبادلهم أولئك بالإساءة سرعان ما يحكمون على كل الناس بأن لا خير فيهم ولا يساعدون بعد ذلك أحداً.. وإن أقرضوا أحداً من الناس ولم يفِ فلا يقرضون بعد ذلك أحداً… وهكذا إذا خانهم البعض أو أساء إليهم، تراهم يعممون ذلك على كل الناس..
وربما يكون السبب في سوء الظن النظرة السوداوية التي تحرم بعض الأفراد من رؤية مظاهر الخير في المجتمع.. فلا يرون خيراً في الناس.. ففي نظرتهم أن الكل سيئون.. كلهم لصوص.. كلهم شريرون.. يشككون في دوافع الناس ولا يرون من الناس إلا أسوأ المحامل دون أن يكلفوا أنفسهم النظر إلى الإيجابيات الموجودة لدى كثير من الناس.
ولمواجهة هذه الآفة جاء التحذير من الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}.
ولذلك ورد في الحديث: "إِيّاكُم وَالظّنُّ؛ فَاِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الكِذبِ".
وقد جاء التحذير من ذلك عن رسول الله(ص) حين كان يطوف بالكعبة وهو يقول لها: "ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك.. ثم قال(ص): "والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك".. ثم فسر رسول الله(ص) الحرمة بثلاثة أشياء: مال المؤمن ودمه وأن لا يظن به إلا خيراً"..
ورد في الحديث: "إذا اتهم المؤمن أخاه إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء".
وقد ورد أيضاً: "آفة المؤمن سوء الظن".. "إياك أن تُسيء الظّنّ فإنّ سوء الظّنّ يُفسد العبادة و يعظّم الوزر".
ولأجل مواجهة هذه الآفة رسم الإسلام الإطار الذي ينبغي أن يحدد تعاملنا مع الظواهر الاجتماعية أو الاستماع إلى أي حديث أو متابعة أي فعل.. حيث يقول الله سبحانه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً}.. فالأحكام لا بد أن تصدر على أساس اليقين والقطع.. وقد ورد الحديث: "احمل أخاك المؤمن على سبعين محمل حسن".. "ولا تظننّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً، وأنت تجد له في الخير محملاً".. فلا تسرع في الحكم على المواقف والكلمات والأشخاص، بل لا بد من التفتيش دائماً عن إمكانية وجود وجه حسن لهذه الظاهرة أو لهذا الموقف أو لتلك العلاقة.
والحديث القائل بأن ما بين الحق والباطل أربع أصابع الحق: الحق أن تقول رأيت والباطل أن تقول سمعت..
وقد ورد عن رسول الله(ص) عندما جاء إلى رجل يسأله عن شروط الحكم على الأشخاص أو الجهات أو المواقف قال، وكانت الشمس في وضح النهار على مثل هذه فاشهد وادع..
وهذا المبدأ مبدأ عدم سوء الظن بالناس هو الذي انتهجه الإسلام بتشريعاته وأحكامه حين أخذ بمبدأ أصالة الصحة واعتبر أن أفعال الناس محكومة بالصحة حتى يثبت العكس، وأن الأصل في الإنسان الطهارة وأن كل شيء طاهر حيث تثبت النجاسة ، وأن الغرض في يد الإنسان دليل ملكيته له، وأن سوق المسلمين محكوم بالتذكية، فالشريعة لم تأخذ بكل الظنون أو الشكوك التي قد ترد في كل هذه الحالات ما لم يثبت عكسها.
ولكن هناك نقطة هامة لا بد من الإشارة إليها هنا، وهي أن عدم الأخذ بسوء الظن لا يعني أن يكون الإنسان ساذجاً وبسيطاً.. فيقبل كل كلام الناس ولا يرى إلا الخير فيهم حسبما توحي به ظواهر أفعالهم وتصرفاتهم.. فهناك في المجتمع من لا يشجعون الناس على حسن الظن بهم وهم على حق..
وفي المجتمع من يتلونون وخادعون ويظهرون بغير صورتهم الحقيقية وإن كان ذلك ليس هو القاعدة في التعامل بل الاستثناء.
ومن هنا ودفعاً لكل ذلك دعت الأحاديث إلى إبقاء الحذر موجوداً مما قد يخفونه للتغيير الذي يحصل إليه..
ومن هنا ورد في الحديث: "لا تثقنَّ بأخيك كلّ الثقة، فإنّ صرعة الاسترسال لا تُستقال". وأيضاً ما أشار إليه الإمام علي(ع) حين قال: "إذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر".
ويبقى السؤال ماذا لو حصل سوء الظن من الإنسان رغم السعي للتحرز منه.. هذا السؤال أجاب عنه رسول الله(ص) عندما قال: وإذا ظننت (ظناً سيئاً) فلا تحقق، وهو يعني أن لا تتعامل أو تغير تصرفاتك على أساس سوء الظن، بأن تبقى تتواصل مع من أسأت الظن معه وتحسن إليه ولا تتكلم عنه إلا بخير.. وأن تدعو له بهذا يقطع الإنسان حبل الشيطان الممدود له في مثل هذه الحالة.
أيها الأحبة:
لقد أراد الله أن يكون قلب المؤمن سليماً.. بأن لا يحمل السوء لأحد من الناس واعتبر ذلك مدخلاً لفلاح الإنسان عند وقوفه بين يدي الله: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}..
فالإنسان حتى يبلغ الموقع الكبير عند الله لا بد أن يكون سليم الاعتقاد وسليم الظنون.. ومن هنا ورد في الحديث عن رسول الله(ص): أي الناس أفضل.. قال: "كل مخموم القلب صدوق اللسان"…
وعندما قيل له صدوق اللسان نعرفه لكن من هو مخموم القلب؟ قال: "التقي النقي الذي لا غل في قلبه لأحد ولا حسد..". فالمؤمن يفرح دائماً لإخوانه ويظن بهم خيراً ويحمل أمورهم على أحسن المحامل ولا يترقب عثراتهم ولا يظن بهم الظنون.
أيها الأحبة:
لنفتح قلوبنا بالخير لكل الناس ولنتأسى بما كان عليه المسلمون أيام رسول الله(ص) حين كان أحدهم يرى الصورة الجميلة للآخرين، فإن كان هو خيراً من الآخرين في الظاهر، فإنه يرى غيره خيراً منه في الباطن.. وإن رأى من هو أكبر منه يقول هو خير مني لأنه أقدم مني في الإسلام.. وإن رأى أصغير منه يقول: هو خير مني لأن معاصيه أقل من معاصي.. فهو دائماً يرى الخير في الآخرين..
وفي ذلك تأكيد على احترام الإنسان لإنسانيته.. وعلى أن صورته المشرقة هي الغالبة دائماً.. ومع الأسف يصر البعض على تغييبها.. على رغم الكرامة التي منحها الله للإنسان، وهو مدلول الآية الكريم: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الخطبة الثانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بما أوصى به أمير المؤمنين(ع) حين قال: "اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون عن البقاع والبهائم".. لقد ربط الإمام(ع) بين تقوى الله والاهتمام بالشأن العام المتعلّق بالعباد والبلاد، وحتى بالحيوان، فلا يمكن للإنسان أن يكون تقياً وينأى بنفسه عما يحدث من حوله، بحيث يكون أقصى ما يقوم به هو أن يتابع الأخبار، ويتأسّف على ما يحصل من ظلم للعباد، وتدمير للبلاد، ومن فساد وانهيار للقيم والأخلاق.
كان عليّ(ع) يدعو إلى تحمّل المسؤوليّة في تغيير الواقع الفاسد والمنحرف والظالم، لصناعة واقع أفضل، وكلٌ عليه أن يؤدّي دوره في هذا المجال، فالأدوار متاحة بالكلمة والموقف، من خلال تأييد الحقّ والعدل والحرية، وبرفض الواقع الفاسد والظالم، من خلال التّشهير بالظّالمين والمفسدين، وعدم القبول بهم، وبأن لا يكون في ذلك ابن ست وابن جارية.
إنَّ الاهتمام بالشّأن العام ليس اختيارياً، بل هو فريضة وواجب ومسؤولية سنُسأل عنها، كما سنسأل عن الصّلاة والصّيام والحجّ..
إنَّ خلودنا إلى الراحة في ظلِّ ما نعيشه من معاناة، أفسح المجال للعابثين بأن يتحكَّموا بالبلاد والعباد.. وقد آن الأوان لنكون صنّاعاً لحاضرنا ومستقبلنا. نعم، هذا الأمر يفرض علينا تضحيات جمّة، ولكن مهما بذلت أثمان في سبيله، فهي أخفّ مما سندفعه إذا بقينا على هامش هذا الواقع من حولنا. بهذا العزم وبهذه الروحيّة، نستطيع أن نصنع واقعاً جديداً، وأن نواجه التّحديات..
لبنان
والبداية من لبنان، حيث بات واضحاً أن لا حلول منتظرة لأزماته السياسيّة والاقتصاديّة من الخارج، في ظل احتدام الصراع الدولي والإقليمي، والانشغال عن الملف اللبناني، ولكن ذلك لا يعني أن هذا هو قدر اللبنانيين، فهم قادرون على كسره واجتراح الحلول إن قرروا الخروج من استثمار ما يجري في الخارج من أحداث..
يستطيع اللبنانيون أن يغيروا واقعهم عندما يكون رهانهم على وحدتهم وعلى الخروج من أسر كل التجاذبات وشد الحبال الذي بات يعقِّد كل شيء، وما ملف النفط ببعيد.. ومتى حصل ذلك، فلن تعود جلسات الحوار التي تجري جلسات روتينية لتبريد الأجواء وتجميد الفتن أو لتقطيع الوقت، بل للتفكير الجدي في اجتراح الحلول لكلّ الأزمات، سواء انتخاب رئيس للجمهورية، أو القانون الانتخابي، أو النفط، أو موضوع الكهرباء، أو تلوث البيئة وغيرها من الملفات العالقة، وما أكثرها!
إنّ من حقّ اللبنانيين أن يعيشوا في وطن يحفظ حقوقهم، أسوة بغيرهم، ومن حقهم أيضًا على كلّ من هم في مواقع المسؤوليّة، أن يوقفوا هذه الكارثة الّتي لم تعد تقف عند حدود الانهيار السّياسيّ والاقتصاديّ أو المالي، إنما قد تصل بسرعة إلى انهيار منظومة القيم والأخلاق، والتي يفترض أن يكون لبنان رائداً فيها…
وفي هذا المجال، وحتى لا تبدو الصورة مأساوية، لا يعدم البلد من نقاط ضوء نشهدها في هذه المرحلة، سواء فيما يتعلق بالوضع الأمنيّ، حيث يحافظ البلد على حد معين من الاستقرار، بفعل الجهود المستمرة التي تبذلها القوى الأمنية، والمتابعة لأدق التفاصيل في الداخل وعلى الحدود، وبفعل العين الساهرة للمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وكل الذين يكيدون للبنان، أو في المبادرات الجادّة، كما هو عمل لجنة الاتصالات النيابية في ملف الإنترنت غير الشرعي، والذي تسبب ويتسبّب بخسائر فادحة لحقت بخزينة الدولة وبلغت نصف مليار دولار…
وهنا، ننوّه بمشروع التغطية الاستشفائية للمسنين، التي أُعلِن عنها مؤخراً، رغم أنها مغامرة، كما عبّر عنها البعض، ولكن ينبغي الخوض فيها، ونحن نأمل أن تسلك طريقها إلى الواقع.. إلى غير ذلك من المبادرات، والتي مع الأسف، لا تنطلق من خطّة عامّة وشاملة على المستوى الحكومي.
وفي المجال البيئيّ والصّحّيّ، نأمل التحرّك الجادّ والسّريع لمعالجة التلوّث في حوض الليطاني أو بحيرة القرعون، وعدم تمييع هذه المسألة الخطرة من خلال تحويلها إلى اللجان، ولا سيّما بعد الحديث عن نعيهما، رغم الأضرار البيئيّة والصّحيّة والاقتصاديّة الناتجة من استمرار هذا التلوّث الذي بات يهدّد حياة المواطنين وصحّتهم وأرزاقهم.
إنّنا لا نعدم الوسائل للخروج من هذا النفق المظلم الَّذي نعانيه، إن قرّر من هم في مواقع المسؤولية تحمّل مسؤولياتهم، ولم يأتِ من يعرقل اندفاعهم.
إنّ حالة عدم الاستقرار التي يعيشها لبنان، هي حال المنطقة برمّتها على اختلاف بلدانها، حيث تتأجّج الصراعات والانقسامات فيها، وتتراوح أسباب ذلك بين عبث الأيادي الخارجية التي تسعى إلى تعزيز نفوذها، وتعتبر المنطقة بقرة حلوباً وأسواق لمصانع الأسلحة لديها، ومخطّطات التقسيم والفتنة الدّاخليّة الّتي تتمّ، مع الأسف، بأيادٍ عربية وإسلامية، وبعناوين مختلفة، والتي بات من الواضح أن نيرانها لن تقف عند حدود معينة عندما تشتعل، وستحرق أيدي الذين أشعلوها وعملوا على إذكائها.
العالم الإسلامي
وانطلاقاً من النزيف المستمر في سوريا والعراق واليمن، والآن في تركيا، نرى أنَّ إضعاف أي بلد عربيّ وإسلاميّ هو إضعاف لكلّ هذا الواقع العربيّ والإسلاميّ.. وهو خدمة مجانية للعدوّ الصّهيونيّ، الّذي لا نحيّده عن المسؤوليّة في كلّ هذه الفتن، والَّذي يسعى جاهداً ليكون الأقوى في هذه المنطقة وفي هذا العالم.
لقد آن الأوان لأن يرى العالم العربي والإسلامي بأجمعه مدى الاستهداف الذي يتهدّده، والاستنزاف الذي يتعرض له، ما يتطلّب المسارعة في طي هذه الصفحات السوداء التي أدمت الجميع، وفتح صفحات جديدة تسمح له بأن يقوي بعضه بعضاً، بدلاً من أن يضعف بعضه البعض الآخر، وذلك بتحصين الداخل والحدّ من تدخلات الخارج.
وهنا، نقف عند مظاهر التوحّش الّتي تشهدها سوريا، والتي كان آخرها الجريمة التي ارتكبتها إحدى المنظّمات الإرهابيّة، والّتي توصف بالمعتدلة، بحقّ الفتى الفلسطيني اليافع في حلب، الذي تمّ ذبحه بعد تعذيب شديد. إن هذه الجريمة تشير إلى مدى الجنون والانحدار الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه واقعنا، ما يتطلَّب من الجميع عدم الاكتفاء باستنكار هنا أو هناك، وإدراجها في خانة الأخطاء الفردية، أو الاقتصار على المطالبة بالتّحقيق في أسبابها، للتخفيف من وقعها وعدم مواجهة المرتكبين، بقدر ما يتطلب استنفاراً على كلّ المستويات، والمباشرة في مواجهة هذه الظّاهرة الإرهابية التي لا تهدد بجرائمها سوريا فحسب، أو منطقة معيّنة، بل كلّ دول العالم.
وأولى السّبل إلى ذلك، هي الإسراع بالتّسويات الهادفة إلى إيقاف هذا النّزيف، وإخراج هذا البلد من معاناته المستمرة، والتي ستنتج مثل هذه الظواهر وأكثر منها إن استمرّت.
المكتب الإعلامي لسماحة العلامة السيد علي فضل الله