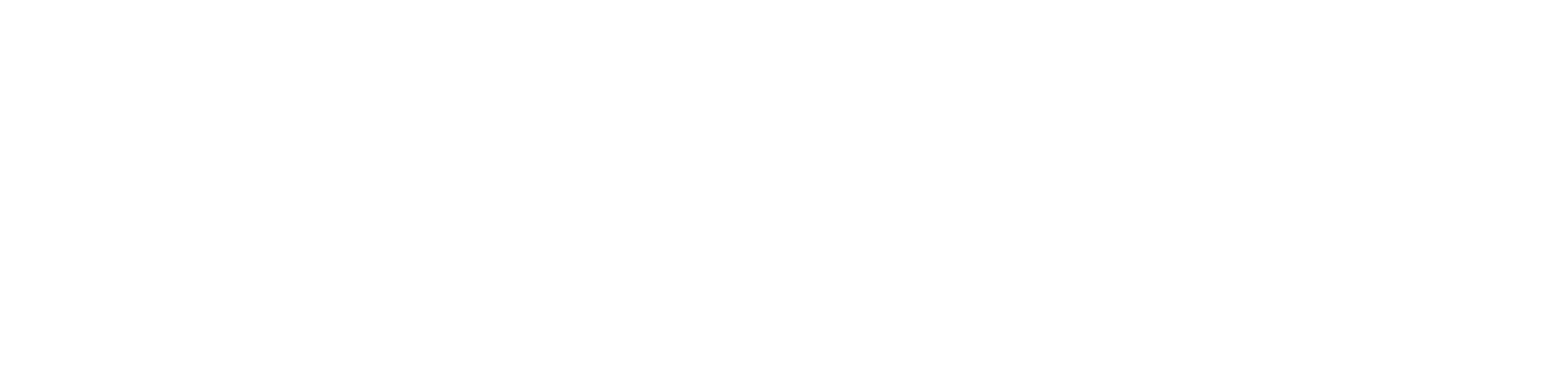المودّة في القربى
ألقى العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبتيه:
الخطبة الأولى
قال الله سبحانه وتعالى: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ ،الله غَفُورٌ شَكُورٌ} صدق الله العظيم.
يدعو الله سبحانه وتعالى رسوله في هذه الآية إلى أن يبلغ الناس أنه (ص) لا يريد منهم أجراً مادياً أو معنوياً على الجهود التي بذلها، والدور الذي قام به من أجل هدايتهم إلى الطريق المستقيم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، وهو من تعب وعانى وأوذي حتى قال: "ما أوذي نبي مثلما أوذيت"، إنما جل ما يريده منهم مقابل كلّ ذلك، هو المودة في القربى.
من المقصود بالقربى؟
قد يبدو مستغرباً أن يطلب رسول الله (ص) من أمته هذا الطلب، أو أن يأمره الله به، ولكنّ هذا الاستغراب يزول عندما نعرف من هم ذوو القربى الذين أمرنا الله بمودّتهم، وكيف تكون المودة، فمن هم ذوو القربى؟
قد يرى البعض أن المقصود من القربى هم أقارب رسول الله (ص) من جهة أبيه أو أمه، ولكن هذا ما لا يمكن أن يصدر عن رسول الله بأن يدعو إلى مودّة أقاربه، وهناك من أقاربه من كان لايزالون على الشرك ويعادونه في رسالته، وهذا لا يقبل به الله، وهو ما نلحظه في قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِ،الله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ،الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}، وقوله سبحانه وتعالى: { لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ}.
لذا، نجد القرآن الكريم نزل ليندّد بأبي لهب ويذكره بالاسم، لأنه وقف في وجه رسالة رسول الله، وأصرَّ على الشرك، من دون أن يأخذ بالاعتبار كونه عم رسول الله (ص).
وفي المقابل، قال رسول الله (ص) عن سلمان الفارسي: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ»، فرسول الله ما كان يأخذ بالاعتبار علاقاته الشخصيّة أو العائليّة أو القبليّة، كانت حساباته دائماً رساليّة، وهذا ما أشار إليه الإمام علي (ع) عندما قال: "إن وليّ محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدوّ محمد من عصى الله وإن قربت قرابته".
ولكنّ الصحيح هو ما أجمع عليه أغلب المفسّرين، أن المراد من ذوي القربى هم الصفوة الطاهرة من أهل بيت رسول الله (ص)، وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الواردة من مصادر المسلمين جميعاً، فقد ورد عن أحمد بن حنبل، وهو إمام المذهب الحنبلي، لما نزلت على رسول الله الآية: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}، قال له أصحابه: ومن قرابتك يا رسول الله؟ قال: "علي وفاطمة وأبناؤهما". قال رسول الله ثلاثاً للتأكيد".
وقد ورد أنّ الإمام الحسن خطب في الناس بعد أن بايعوه الخلافة، ومما قال: "أنا من أهلِ البيت الذين افترض الله مودّتهم على كلّ مسلم، فقال تبارك وتعالى لنبيّه (ص): {قل لا أسألكم عليه أجرا إلاّ المودّة في القربى}.
وقد أورد السيوطي أنه عندما أسر علي بن الحسين (ع) وأوقف بقيّة سبايا كربلاء على أبواب الشام، تجمّع الناس وبينهم رجل كبير من أهل الشّام، فقال: "الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم، وأراح البلاد من رجالكم، وأمكن أمير المؤمنين يزيد منكم"، وطبعاً هذا نتيجة الدعاية الأموية التي راحت تبث بين الناس أنهم من المشركين.
هنا، سمع الإمام علي بن الحسين (ع) مقولته، فتقدم منه وقال له: هل عرفت هذه الآية: {قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى}؟ قال الشيخ: قد قرأت ذلك، ولكن ما دخلكم؟ فقال له الإمام زين العابدين (ع): "فنحن القربى يا شيخ". أجاب الشيخ: بالله إنكم هم؟ فقال عليّ بن الحسين (ع): "تالله إنّا لنحن هم من غير شكّ"، فبكى الشيخ ورمى عمامته، ورفع رأسه إلى السماء وقال: ،اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد من جنّ وإنس، ثم قال: هل لي من توبة؟ فقال له: "نعم، إن تبت تاب الله عليك، وأنت معنا".
وإلى هذه الآية أشار إمام المذهب الشّافعي عندما قال:
يا آلَ بَيتِ رَسولِ اللهِ حُبَّكُمُ فَرضٌ مِنَ اللهِ في القُرآنِ أَنزَلَهُ
يَكفيكُمُ مِن عَظيمِ الفَخرِ أَنَّكُمُ مَن لَم يُصَلِّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ
إذاً المقصود بأولي القربى هم: هذه الصفوة الطيّبة من آل رسول الله، ممن حباهم الله بتربيته ورعايته، فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. وقد أشار إليهم رسول الله (ص): "إني تارك فيكم الثّقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض".
وقوله (ص): "إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك".
وهذا التفسير هو الذي يظهر أنّ الأجر الذي أراده رسول الله (ص) من المؤمنين بمودّة ذوي القربى، لم يكن أجراً ذاتياً أو لقرابة عائلية أو قبلية لمصلحة أمّته، كما قال الله سبحانه: {قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ}، بل لكون هذه الصفوة هم صمام أمان الأمّة من الانحراف، وهذا ما أثبته التاريخ وما سيثبته المستقبل، ومودتهم هي تقدير لهم على هذا الدور الذي قاموا به وسيقومون به في نفوس المسلمين وحياتهم:
كيف السّبيل لمودّتهم؟!
ويبقى السؤال: كيف هو السبيل لمودتهم؟
هل يكون فقط بالاكتفاء بحبهم وإبراز العاطفة عليهم، فنبكي ونحزن لما أصابهم أو نفرح بفرحهم؟!
المودة هي أبعد من ذلك، صحيح أنها تبدأ بالعاطفة وإبداء المشاعر، ولكنّها ينبغي ألا نقف عندها، بل تتحوّل إلى مواقف وسلوك تتمثّل على أرض الواقع، وهذا ما حرص عليه أهل البيت (ع) دائماً، عندما كانوا يؤكّدون أن حبهم هو في حبّ المشروع الذي لأجله بذلوا دماءهم وقدّموا التضحيات، فكانوا يقولون: "أحبونا حبّ الإسلام"، "لا تنال محبتنا إلا بالعمل والورع"…
وإلى هذا أشار الإمام الباقر (ع) لأحد أصحابه، فقال له: "يا جابر! أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟! فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يُعرفون يا جابر إلا بالتّواضع والتخشع والأمانة، وكثرة ذكر الله، والصوم، والصلاة، والبرّ بالوالدين، والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة، والغارمين، والأيتام، وصدق الحديث، وتلاوة القرآن، وكفّ الألسن عن النّاس، إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء".
قال جابر: فقلت: يا بن رسول الله، ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة، فقال (ع): "يا جابر! لا تذهبنّ بك المذاهب، أحسب الرّجل أن يقول: أحبّ علياً وأتولاه، ثم لا يكون مع ذلك فعّالاً؟ فلو قال: إني أحب رسول الله (ص) – فرسول الله (ص) خير من عليّ (ع)، ثم لا يتبع سيرته، ولا يعمل بسنّته، ما نفعه حبه إياه شيئاً، فاتّقوا الله، واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته.
يا جابر! فوالله ما يُتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعاً فهو لنا وليُّ، ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوّ، ولا تنال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع".
شيعة الأئمّة قدوة للنّاس!
لقد كان أئمة أهل البيت (ع) يريدون لشيعتهم ومن يودّهم بأن يكونوا قدوة للناس، أن يكونوا علامة فارقة في مجتمعاتهم وأوطانهم، يضرب بهم المثل في العلم والعبادة وحسن الخلق والبذل والعطاء والتضحية، وهذا مبعث رضاهم.
فقد ورد عن الإمام الصادق (ع): "فإن الرّجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث، وأدّى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفريّ، فيسرني ذلك، ويدخل عليّ منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك، دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل: هذا أدب جعفر".
وهم أرادوا ذلك، لا في تعاملهم فيما بينهم وداخل مجتمعاتهم، بل في تعاملهم مع من يختلفون معهم في المذهب والعقيدة.
فقد ورد في الحديث عن الإمام الحسن العسكري (ع)، في العلاقة مع الذين يختلفون معهم في المذهب: "صلّوا في عشائرهم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدّوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق في حديثه، وأدى الأمانة، وحسّن خلقه مع الناس، قيل: هذا شيعي، فيسرّني ذلك. اتّقوا الله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً، جروا إلينا كلّ مودة، وادفعوا عنا كلّ قبيح".
وقد ورد في الحديث: "كونوا دعاة إلينا بالكفّ عن محارم الله واجتناب معاصيه واتباع رضوان الله، فإنهم إذا كانوا كذلك، كان الناس إلينا مسارعين".
جعلنا الله ممن يودون أهل هذا البيت الطاهر حباً وسلوكاً ومواقف، وأن نكون زيناً لهم لا شيناً عليهم، نجر إليهم كلّ مودّة، وندفع عنهم كل قبيح، وبذلك تكون المودة، إنه سميع مجيب الدعاء.
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الخطبة الثانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بالدّعاء الذي دعا به الإمام الحسين (ع) عندما تحلَّق حوله الأعداء في كربلاء من كلّ جانب، يريدون قتله وقتل أصحابه وأهل بيته، حيث اكتفى آنذاك بأن توجَّه إلى الله سبحانه وتعالى قائلاً: "اللّهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقةٌ وعدة. كم مِنْ همّ يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك، وشكوته إليك، رغبةً مني إليك عمّن سواك، ففرَّجته عني وكشفته، فأنت وليّ كلّ نعمة، وصاحب كلّ حسنة، ومنتهى كلّ رغبة".
لقد أراد الإمام الحسين (ع) بهذا الدّعاء أن يظهر طبيعة علاقته بالله، فقد كان يرى الله أنيسه وموضع ثقته وأمله ورجاءه، لهذا لم يهن ولم يضعف، رغم خذلان الناصر.
وقد قال عنه أعداؤه وهو في قلب المعركة: "والله، ما رأيت مكثوراً قطّ قد قُتل وِلده وأهل بيته وأصحابه، أربط جأشاً، ولا أمضى جناناً، ولا أجرأ مقدماً منه. والله، ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وإن كانت الرجالة لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وعن شماله انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب…".
هذا ما نتعلَّمه من الإمام الحسين (ع)، وهذا ما نراه فيه، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه العلاقة بين المؤمن وربّه، لنتحصَّن بها في مواجهة التحدّيات، فنكون أكثر قوةً وعزماً وإرادةً، وأكثر قدرةً على مواجهة التحديات.
انتفاضة الشّعب
والبداية من لبنان، الَّذي كان قبل أيام تحت رحمة الحرائق الَّتي أتت على مساحات واسعة من الأراضي الخضراء. وقد أظهرت الكارثة مدى قصور الدولة وإهمالها وعدم قدرتها على مواجهة ما حدث أو على مجاراة الناس الَّذين هبّوا للمساعدة وإطفاء الحرائق، وأظهروا وحدتهم وتضامنهم وتكافلهم.
لقد كنّا أمام فصل جديد من فصول عجز الدولة، التي بدلًا من أن تتحمَّل المسؤوليّة، بدأت سلسلة تقاذف المسؤوليّات فيما بين أطرافها، إلى المستوى الّذي جرى استخدام البعد الطائفي في إطار الصراع الجاري بين مواقع السلطة.
في هذا الوقت، وبعد أن توفّرت الظّروف لإيقاف الحرائق البيئية في البلد، يصرّ البعض على إيقاد الحرائق السياسيّة، من خلال الإبقاء على السجالات في الشارع ومن على المنابر، بدلاً من نقلها إلى داخل المؤسسات، التي هي المكان الأنسب لدراسة كلّ هذه القضايا، انطلاقاً من مصلحة البلد، وبعيداً من الشعبوية التي باتت تمثل السلاح الأمضى للقوى السياسية لشد عصب جمهورها، كما هو الأمر في قضية النازحين السوريين أو العلاقة مع سوريا أو غير ذلك من القضايا، ولا سيما أنَّ كلّ المتساجلين هم شركاء في الحكومة أو المجلس النيابي.
إنَّ مسؤوليّة القوى السياسيّة أن تكون أمينة على مصالح جمهورها، فلا تحوّله إلى قنابل متفجّرة في وجه بعضه البعض، لحساب مصالح سياسيّة أو طائفيّة أو مذهبيّة لا تسمن ولا تغني من جوع.
والأمر نفسه في التعامل مع موازنة العام 2020، ففي الوقت الَّذي كان اللبنانيون ينتظرون أن تفي الدّولة بوعودها، وأن تحمل هذه الموازنة بشائر البدء بمعالجة جادة للأزمات التي يعانونها على المستوى الاقتصادي والمالي، بإجراء إصلاحات جادة في بنية الاقتصاد اللبناني، وإزالة مكامن الفساد والهدر والمحسوبيات والصفقات وفوضى التعيينات التي باتت تثقل كاهل اللبنانيين، فوجئ اللبنانيون بعودة الدولة إلى الأسلوب الَّذي اعتادت عليه، وهو مدّ يدها إلى جيوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع المزري الَّذي وصلوا إليه، والتحذيرات من كلّ الحريصين على استقرار هذا البلد، فكانت القرارات الأخيرة التي أدّت إلى أن يشعر اللبنانيون بأن لا خيار لهم إلا النزول إلى الشارع، رغم معرفتهم بتداعيات هذا النزول، ومن يمكن أن يستغلّه، وحتى أن يفقده صفاء الأهداف التي كان لأجلها.
وحسناً فعلت الدّولة عندما تراجعت عن الخطأ وسارعت إلى إلغاء بعض هذه الإجراءات، ولكن هذا لم يعد يكفي لإزالة النقمة الشعبية واستعادة الثقة التي أصبحت مفقودة بالدولة وبكلّ رموزها. إن على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار ما جرى، بعد أن أصبح واضحاً أنَّ هناك أساليب جديدة في تحريك الشارع ليس بالمقدور ضبطها، وأن خطوطاً حمراء كانت موجودة تمّ تجاوزها، وأنَّ اللغة التي كانت تستخدم في تبريد الشارع من خلال إرهابه أو تخويفه لم تعد ذات شأن، وباتت عنده إجراءات شكليّة.
إنَّ على الدّولة أن لا تجدّد الرّهان على أنّ هذا الشَّعب يسهل إسكاته بدغدغة مشاعره وأحاسيسه الطائفية أو المذهبية أو بتخويفه من الآخر، لقد أصبح أكثر وعياً وتوحداً، ولم تعد تلك هذه الأساليب ذات جدوى.
هل يدخل البلد في المجهول؟!
لذلك، ندعو الدولة، ولا سيّما من يحرصون على الإصلاحات فيها، ونحن لا نشكّك بوجودهم، إلى القيام بكلّ الإجراءات التي تعيد إلى اللبنانيين الثقة بهم، وإن كان الأمر لم يعد بسيطاً، وأصبح بحاجةٍ إلى عمليات جراحية تستأصل جذور الأزمة.
إنّنا لا نريد أن يدخل البلد في المجهول، لكنَّ الكرة الآن في ملعب الطبقة السياسيّة بكل عناصرها ومكوّناتها. الكلّ مسؤولون، ولا يجوز لأيّ مسؤول أن يتهرب من تحمل المسؤوليّة، والكلّ لا بدّ من أن يتعاونوا لإنقاذ البلد من الانهيار. إن الساعات القادمة ينبغي أن تكون حاسمة، والعلاج غير ميؤوس فيه، شرط أن يؤخذ القرار بالخروج من دولة المزرعة إلى دولة يشعر فيها الإنسان بكرامته وعزته، بعيداً من كلّ الاعتبارات الأخرى.
لقد آن الأوان لاتخاذ الإجراءات الجذرية التي تستهدف مكامن الفساد الكبرى، وخصوصاً المؤسَّسات المالية ومحميات الكثير من المسؤولين الذين صاروا أثرياء على حساب الدولة والمواطنين، حتى فرغت الخزينة العامة، وإلا فإن الهيكل سوف يسقط على رؤوس الجميع.
صرخة تتخطّى كربلاء
وأخيراً، يتوجّه المسلمون غداً لزيارة الإمام الحسين (ع) كتعبير عملي عن الحبّ والوفاء لهذا الإمام الذي قدَّم حياته من أجل أن يوقظ الناس من سباتهم، ويخرجهم من جهلهم ومن صمتهم، إلى فضاء مليء بالعزة والحرية والمواقف الكريمة، ليمتلكوا العزيمة والإرادة التي لا تسمح لأحد أن يستفرد بهم أو أن يستعبدهم أو أن يعطوا إعطاء الأذلاء ويقروا إقرار العبيد.
إنَّنا لا نحتاج إلى التأكيد أنَّ هذه الحشود الَّتي اجتمعت ليست كما يصوّرها البعض، لحساب مذهب في مواجهة مذهب، أو دين في مواجهة دين، بل هي في مواجهة كلّ الظّالمين والمستكبرين والفاسدين والمستأثرين بأموال الشعوب، والمعطّلين للقوانين عندما تكون على حساب الكبار. إن هذه الحشود لن يقف صوتها في كربلاء، بل سيمتدّ إلى كلّ أرض عطشى، إلى القيم، إلى العدل والحرية والكرامة والإنسانية، ولسنا عن ذلك ببعيدين.