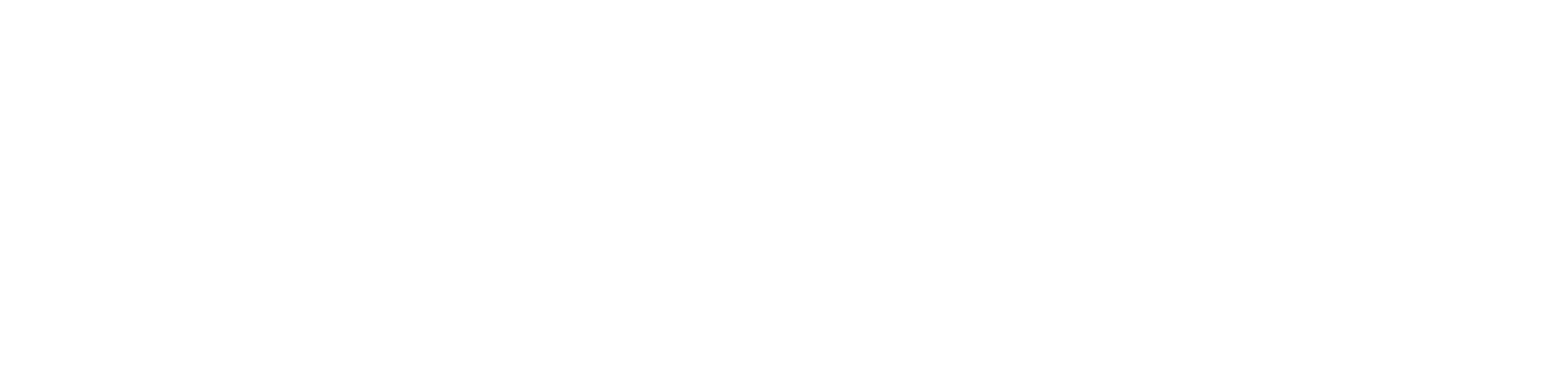السّكينة صفة المؤمنين
الخطبة الأولى
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَللهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيم}. صدق الله العظيم.
يواجه الإنسان في الحياة الكثير من التوتّرات التي قد تنتج بفعل الابتلاءات التي يتعرَّض لها هو شخصيّاً أو مَن حوله، أو بفعل التحدّيات التي تهدِّد وجوده أو أمنه أو كرامته أو إيمانه…
ومن الطبيعيّ أن تنعكس هذه التوترات على تصرّفاته وأفكاره وآرائه، فقد يفقد معها رزانة الشخصيّة ووقارها، وهدوء النّفس وسلامة التّفكير والمنطق السّليم.
ومن هنا، تدعو الحاجة إلى تأمين كلّ الأجواء والشّروط التي تساهم في تبديد هذه التوتّرات، وإزالة المخاوف ودواعي القلق، ليكون الإنسان قادراً على التّفكير السليم واتخاذ الموقف المناسب، أو التحرّك من قاعدة نفسية وروحيّة راسخة، تنبذ كلّ عناصر القلق والخوف والاضطراب.
سكينة المؤمنين
وفي هذا المجال، تردَّد مفهوم السكينة كثيراً في القرآن الكريم والأحاديث الشَّريفة، وهي تعني الطّمأنينة والوقار ورزانة التَّفكير وهدوءه، إزاء ما يتعرَّض له الإنسان من الشَّدائد والابتلاءات والمحن…
فالسَّكينة إذا نزلت على القلب، اطمأنَّ بها، واكتسب الوقار، وسكنت إليها الجوارح، وانطلق اللِّسان بالصَّواب والحكمة، وحال بينه وبين الوقوع في الزَّلل والخطأ لدى اتخاذ المواقف والقرارات، وأوجدت في الإنسان إرادةً وعزماً على الفعل والمبادرة، وثباتاً في مواجهة التحدّيات.
وقد أشار الله سبحانه وتعالى في الآية الّتي تلوناها إلى مصدر هذه السَّكينة، عندما قال: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَللهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيم}. فالسَّكينة منحة من الله ينزلها على قلوب المؤمنين، وهي لا تصل بالمجّان، بل بفعل إيمانهم عندما يعيشونه صادقاً عميقاً؛ الإيمان الّذي يجعلهم يستحضرون الله في كلِّ حين، كما هو الله في جلاله وعظمته وقدرته وعلوِّه وجبروته ورحمته، فلا يرونه بعيداً منهم، بل هو كما قال لعباده، قريب منهم.
يكفي أن يدعوه حتى يستجيب لهم، وأن يتوكَّلوا عليه حتى يكفيهم، وأن يستندوا إليه حتى يجدوه نعم السّند ونعم الظّهير، وإذا تعثَّرت خطواتهم فهو يقيلهم، وإذا دعوه أجابهم: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيع}. لذا، هم يرضون بقضائه مهما كان هذا القضاء، وببلائه مهما كان هذا البلاء، وبحكمه مهما كان هذا الحكم.
وهو ما ورد في الحديث القدسيّ: "ما خلقت خلقاً أحبَّ إليَّ من عبدي المؤمن، وإنّي إنَّما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يُصلح عبدي عليه، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي، أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضائي، وأطاع أمري".
سكينة الأنبياء
وقد أشار القرآن الكريم إلى العديد من مظاهر السَّكينة التي أنزلها الله على الأنبياء والمؤمنين، فهي صفة من صفات النبيّ إبراهيم (ع). ولقد عبَّر عنها يوم جاءه الأمر الإلهيّ بترك زوجته وولده في الصّحراء القاحلة، حيث لا ماء ولا طعام ولا بشر، ولم يشعر بالخوف والجزع، لأنّه كانت لديه ملء الثقة بأنّ الله لن يتركهما لمصيرهما، لذا اكتفى بالقول: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ}.
وهذه السّكينة هي التي عاشت في قلب هاجر، فهي بعدما أخبرها زوجها النبيّ إبراهيم (ع) بأنّه سيتركها، اضطربت وخافت مما قد يصيبها ويصيب ولدها، ولكنّه عندما قال لها إنّ الله معك، عاشت السّكينة، وقالت إذاً لن أبالي ولن أخاف.
وهذا ما ملأ قلب النبيّ موسى (ع) ومعه بنو إسرائيل، عندما لاحقهم فرعون وجنوده، بعد محاولتهم النّجاة بأنفسهم من طغيانه وجبروته، وكادوا يومها يصلون إليهم بعدما بلغوا شاطئ البحر، جاء يومها بنو إسرائيل إلى نبيِّهم موسى (ع) فزعين قائلين: {إِنَّا لَمُدْرَكُونَ}، فقال لهم بلسان السَّكينة التي كانت في قلبه: {كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}.
وهذه السّكينة كانت حال رسول الله محمد (ص)، حين تعرّض إلى ما تعرَّض له من شدائد ومحن، ونال ما ناله من الأذى من حصار وضغوط واتهامات بأنّه ساحر ومجنون، وأنّه يفرّق بين المرء وزوجه… ولم يضطرب آنذاك، ولم يتوتّر ولم يتراجع، بل اكتفى بأن يقول: "اللّهمّ اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون". وعندما قيل له: ادع عليهم والله يستجيب لك، قال: "لعلّ الله يُخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً".
وقد أشار إليها القرآن الكريم عندما تحدَّث عن هجرة رسول الله (ص) من مكَّة إلى المدينة، فقد لاحقته قريش، ووصلت برجالها إلى فم غار ثور الّذي كان يحتمي فيه رسول الله (ص) وصاحبه، ولكنَّ رسول الله (ص) الواثق بربِّه، كان آنذاك بمنتهى السَّكينة، قائلاً إنَّ الله معنا، ومادام معنا، فهو يكفينا. {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَ}.
وقد تجلّت هذه السّكينة في العديد من معارك المسلمين المصيريّة، فبعد معركة أحد، جاء خبر إلى المسلمين أنَّ قريش قرَّرت أن تستفيد من انتصارها على المسلمين في المعركة، وتتأهّب للدّخول إلى المدينة، يومها خرج المسلمون كلّهم، لم يخشوا قريش رغم جبروتها، ورغم كلّ الآلام التي أصابتهم، ما اضطرَّها إلى أن تتراجع عمّا كانت ستقدم عليه. وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ الله وَالله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}.
وتجلّت أيضاً في معركة حنين، يوم تعرَّض المسلمون لكمين محكم من المشركين، بحيث تفرَّقت صفوفهم بسببه. يومها، أنزل الله السَّكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وتحوَّلت المعركة من هزيمة كادت تلحق بالمسلمين إلى نصر، والّذي أشار إليه الله سبحانه: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ* ثُمَّ أَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}.
وقد أشار الله إلى أنَّ إنزال السّكينة على قلوب المؤمنين، لا يقتصر على حالات الشدَّة، بل هي حاضرة في قلوب المؤمنين في حالات التوتّر والانفعال؛ بها يواجهون استنفار العصبيَّات، وحميّة الجاهليّة والتوتّر، ليتحرَّكوا من خلالها، لا من موقع ردِّ الفعل، بل من موقع الإيمان والتَّقوى، وذلك قوله: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَ}.
علامة الإيمان
أيّها الأحبَّة: في زمن القلق والتوتّرات والانفعالات والعصبيّات، وزمن التحدّيات والشَّدائد، نحن أحوج ما نكون إلى هذا الهدوء النّفسيّ، إلى السّكينة والوقار، وإلى طمأنينة القلب، حتّى نقدر على التّعامل مع كلّ هذه الأجواء القاسية، وعلى النّجاح في تجاوزها.
فالسَّكينة هي مظهر لإيماننا وعلامة له، بها نقيس إيماننا، فلا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمناً، إلّا إذا كان رابط الجأش في الشَّدائد والصّعوبات، حافظاً لسكونه ووقاره عند الزّلازل والهزّات، غير خاضع للانفعالات والحساسيّات، وغير مهتزّ أمام البلاء والآلام.. فالمؤمن في كلِّ هذه الحالات، يبقى صابراً ثابتاً واعياً حكيماً، يقول عند البلاء: {هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيم}.
وقد ورد في صفات المؤمن: "في الزّلازل وقور، وفي المكاره صبور". وقد سئل الإمام الصّادق (ع): بأيّ شيء يعلم المؤمن أنّه مؤمن؟ قال: "بالتّسليم لله، والرّضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط".
ومتى بلغنا ذلك، فإنّ نفوسنا ستبلغ القمّة الّتي لا قمّة بعدها، نفوس لا تكسرها العواصف، ولا تهزّها زلازل الحياة، ولا ظروف الواقع السياسي أو الاقتصادي أو الأمني القاسية.
نفوس اطمأنّت بذكر الله، وينطبق عليها قوله سبحانه: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله أَلَا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}.
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الخطبة الثانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بما أوصت به الصّدّيقة الطاهرة فاطمة الزّهراء (ع) ولدها الإمام الحسن (ع)، فقد ورد في سيرتها أنها كانت جالسة يوماً في مصلاها تدعو الله كعادتها، وكان إلى جانبها ولدها الإمام الحسن (ع)، وهو آنذاك لم يتجاوز السنوات السّبع، فكانت (ع) تدعو لجيرانها كلّ جارٍ باسمه؛ المسافر منهم تدعو له بالعودة غانماً سالماً، والمحتاج تدعو له بسدّ حاجاته، والمريض بشفائه، والمهموم بكشف غمّه، والضالّ بالهداية له، لم تنسَ أحداً منهم، الكلّ كان حاضراً في بالها وهي بين يدي ربها.
سألها الإمام الحسن (ع) يوماً مستغرباً: يا أمّاه، أراك لا تدعين لنفسك، وأنت أحقّ بالدّعاء لما أنت عليه من مرض وكرب وغمّ، ولما تواجهينه من ظلم، فأجابته الزّهراء (ع) بكلمتها التي أرادت أن تطبعها في قلب ولدها الصّغير، وأن تطبعها في قلوبنا، لتكون مساراً لنا وقدوة: "يا بنيّ، الجار قبل الدّار".
إنّنا في ذكرى وفاة السيّدة الزّهراء (ع) التي مرَّت علينا في الثّالث عشر من شهر جمادى الأولى، أحوج ما نكون إلى أن نعبِّر عن وفائنا لها، لا بدموعنا فقط، بل بأن نستهدي سيرتها، بأن نحسن إلى جيراننا بكلّ دواعي الإحسان، كما كانت تحسن، وقد أشار رسول الله (ص) إلى موارد هذا الإحسان، فقال: "إذا استعانك فأعنه، وإذا استقرضك أقرضه، وإذا افتقر عد عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنَّيته، وإذا أصابته مصيبة عزَّيته، وإذا مات اتَّبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الرّيح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإذا اشتريت فاكهة فاهدِ له، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده".
إنَّنا أحوج ما نكون إلى استهداء هذه القيمة، لنعزّز علاقاتنا الاجتماعيّة ونقلّل من التوترات التي تحدث بين الجيران، ولنعبّر بذلك عن إيماننا. وبذلك نكون أكثر تماسكاً وقدرةً على مواجهة التحدّيات.
متى تنتهي المعاناة؟!
والبداية من لبنان، الَّذي تزداد فيه معاناة اللّبنانيّين على الصَّعيد الاقتصاديّ والمعيشيّ، وفي توفير الخدمات من طبابة وكهرباء ومحروقات وغاز، وفي التدنّي المستمرّ وغير المسبوق في سعر صرف اللّيرة اللبنانيّة لدى الصرّافين أمام الدولار الأميركي الّذي بات يترك تأثيراته في ارتفاع سعر السّلع التي يحتاج إليها المواطنون، وعدم قدرتهم على تحصيل المدّخرات التي أودعوها في البنوك سوى ما تتصدّق به عليهم، والذي أصبح سبباً للمشاكل والتوترات داخلها، ويخشى من آثارها وتداعياتها على المصالح والمؤسَّسات.
ويُضاف إلى ذلك الخوف المتزايد من تطوّرات ما قد يجري على مستوى المنطقة، والتي لن يكون لبنان بمنأى عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، ومما قد يقدم عليه العدوّ الصهيونيّ الّذي ينتظر الفرصة السّانحة للانقضاض على مواقع القوّة في هذا البلد وعلى مناحي الاستقرار فيه.
لا حكومة إلّا بالتَّوافق!
ورغم كلّ هذا الواقع، لم تبصر الحكومة التي ينتظرها اللّبنانيون النّور بعد أن وعدوا بها خلال أسابيع، وحتى خلال أيّام، وهي لاتزال رهينة التجاذبات على الأسماء والحصص والمواقع، حيث يسعى كلّ فريق يشارك في تأليف هذه الحكومة إلى تحسين مواقعه من خلالها، وأن تكون له الحصّة الأوفر فيها، إضافةً إلى ما أثير مؤخَّراً من جدل حول طبيعة الحكومة التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة؛ لتكون قادرة على التعامل مع هذه التطوّرات ذات الطابع السياسي والأمني، وضرورة تطعيمها بالسياسيّين، ما يجعل عملية التأليف في حال المراوحة مع كل التبعات التي قد تترتب على ذلك على صعيد الوطن والمواطنين.
ونحن وسط كل هذه المعاناة والإحباط الذي يعيشه المواطنون، والظروف الصّعبة التي ينتظرها الوطن، نعيد دعوة القوى السياسيّة إلى ما كنا دعونا إليه من الإسراع في تأليف حكومة تحظى بثقة اللّبنانيّين بكلّ تنوّعاتهم ومكوّناتهم، وتسهيل ذلك عمليّاً، لا من خلال الكلام فقط.
وأيّاً كانت مسمّيات هذه الحكومة، فقد أصبح واضحاً، وبما لا يقبل الشّكّ، أن لا فريق واحداً، مهما بلغت إمكاناته وقدراته، باستطاعته العمل على حلّ الأزمات التي يعانيها الوطن والمواطن، فقد جرب اللبنانيون حكومة اللون الواحد التي أثبتت التجارب فشلها وعدم قدرتها على الوصول إلى الحلول المنشودة، ولا يتحمّل الوطن تجارب جديدة.
إنّ هذا البلد لا يحكم إلا بالتوافق. وطبعاً، لا نريد بذلك التوافق الذي أصبح مرادفاً للمحاصصة وتقاسم الجبنة بين المواقع السياسية، فالمرحلة التي نمرّ بها لا تحتمل التجاذبات والمناكفات والصراعات والمحاصصات وتقاسم المواقع لحسابات خاصّة أو طائفيّة أو مذهبيّة، فلبنان يحتاج إلى تضافر جهود كلّ القوى الفاعلة فيه، والعمل معاً من أجل إنقاذ بلد بات يتداعى، ولا تستطيع أيّ من القوى السياسية الهروب من مسؤوليّته، فكلّ من كانوا في مواقع المسؤوليّة معنيون بإنقاذه، والذين أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه مسؤولون عن إخراجه مما يعانيه، وإن لم يفعلوا، فلن يرحمهم الحاضر، وسيكونون لعنة المستقبل.
تداعيات الاغتيال
ومن لبنان، ننتقل إلى تداعيات الجريمة الّتي أدّت إلى استشهاد قائد فيلق القدس اللّواء قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس ورفاقهم، حيث شاهدنا وشاهد العالم الحشود المليونيّة التي شاركت في تشييع الشّهداء، والتي أظهرت مدى حضور هؤلاء في النّفوس، وهي أكّدت أن عمليات الاغتيال لن ترهب الأمّة التي ترى الشهادة وساماً على صدرها، بل تزيدها تماسكاً وقوّةً وعزّةً وعنفواناً وحضوراً أكثر في الساحات.
لذا، كان طبيعياً أن يحصل الردّ، وأن يكون بالصّورة التي حصل فيها، وبالوضوح الّذي تمّ فيه، فهو جاء ليؤكّد خياراً أخذته الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران على عاتقها، ومعها كلّ القوى التوّاقة إلى الحرية، بأنها لن تقبل أن تكون مكسر عصا عند أيّ محطات أو منعطفات سياسية.
لقد جاء الردّ حيث لم يتجرأ عليه أحد، ليؤكّد أنّ عهد الاستضعاف والخضوع والسّكوت على استباحة الأرض والمقدَّسات والأرواح قد ولَّى، وأنَّ الزّمن القادم ينبغي أن يُبنى على أساس احترام إرادة الشعوب وحقّها في الحياة، وأن تحقّق خياراتها في أراضيها ومقدّراتها وثرواتها، فهذه الشعوب توّاقة إلى الأمن والسلام، وهي تريده للآخرين، ولكنّها تريد الأمن العزيز والسلام الذي يؤخذ ولا يعطى بمقابل.
لقد أثبت هذا الردّ أنَّ العدوان، ومهما بلغ حجمه، لن يستطيع ليّ ذراع الشعوب وإخضاعها إن أصرَّت على التمسّك بمبادئ العزّة والحريّة والكرامة، مهما بلغت التضحيات. وينبغي لنا، وفي ظلّ التهاويل والانفعالات التي تفرض علينا إعلامياً وسياسياً، وحتى أمنياً، أن نحصّن أنفسنا كي لا تستبيحنا التحديات وتهزمنا، وبذلك نحصّن ساحتنا ونقوّي مواقعنا، وليكن رائدنا قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}.