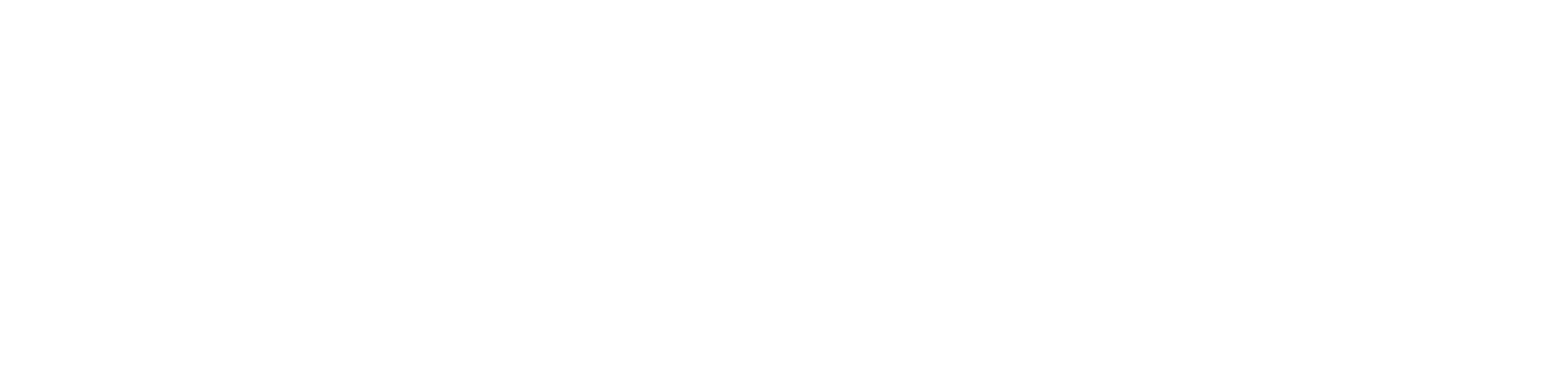تأثير العقل الجمعي على فكر الانسان
ألقى سماحة العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبتيه:
الخطبة الأولى
قال الله سبحانه: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ}.
هذه الآية بيّنت واحداً من الإساءات الَّتي تعرَّض لها رسول الله(ص) خلال دعوته، عندما اتُهم ظلماً وعدواناً من قريش بأنه مجنون. وبدون تدقيق ومحاكمة لهذا الاتهام، راح الناس الآخرون يردّدون ما سمعوه…
لم يرد الله للنبي(ص) أن يردّ هذه الإساءة بمثلها، ولا أن يدافع عن نفسه، بل عمل، كما علمه الله سبحانه، على أن يعالج لديهم طريقة التّفكير والمنهجيّة الّتي تساعدهم على الوصول إلى القرار الصّائب..
ولذلك، قال لهم ما أشارت إليه الآية الَّتي تلوناها: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ}، أي ليكن قيامكم في ذلك لله، لا لحساب أحد.. {مَثْنَى وَفُرَادَى}، أي واحداً واحداً، أو على الأكثر اثنين اثنين، {ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا}، لتدرسوا جيداً، وبتمعن وبهدوء، فكر ما يطرح عليكم، {مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ}.
لقد وعى رسول الله(ص)، وبتوجيه من الله سبحانه، أنَّ فكر الإنسان عرضة دائماً لتأثيرات المجتمع من حوله، والذي يبدأ محدوداً بالأهل والأقارب والرفاق.. ويمتدّ بعد ذلك ليكون بحجم المجتمع ووسائل التأثير التي يعتمد عليها، وهو الذي يسمى بالعقل الجمعيّ، فالجماعة غالباً ما تساهم في صياغة عقول الأفراد، وتقولبهم بطريقتها، وتدفعهم إلى أحد خياراتها الفكرية والأخلاقية والسلوكية.
وخطورة هذه التأثيرات أنها تنفذ إلى فكر الإنسان وتتسلَّل إليه من دون وعي منه.. لذا عندما تريد أن تناقشه في رأي تبناه في مسألة، أو موقف اتخذه تجاه جماعة أو جهة، تجد من الصعوبة بمكان أن تزحزحه عنه، أو أن تبدل قناعاته، فهو استسلم لما هو عليه، أو قرر أن يستسلم حتى لا يكون فرداً نافراً من الجماعة التي ينتمي إليها، حتى إنّك تراه يبرر ما يراه من أخطائهم، حتى لا يكون خارج هذه الجماعة، سواء كانت عائلة أو طائفة أو حزباً أو جمعية أو أية جماعة ينشد إليها الإنسان في حياته.
وهذا ما أشار إليه الشاعر الجاهلي:
ومَا أنَا إلا من غَزِيَّةَ إنْ غوَتْ ******* غوَيْتُ وإنْ تَرشُدْ غزَّيَةُ أَرْشُدِ
ويشهد لذلك الواقع في الكثير ممن ينقلون البندقية من كتف إلى كتف، أو يبدلون مواقعهم بدون قناعة منهم بما يبدلون إليه، فقد بتنا نجد من حولنا أشخاصاً قضوا حياتهم في الدعوة إلى الوحدة والحوار، ورفض كل طروحات الانقسام المذهبي أو الديني أو السياسي، وتقبل الرأي الآخر، ولكن سرعان ما يتبدّل رأيهم بين ليلة وضحاها، فيخرجون على الإعلام ليبثوا سمومهم ويكفّروا الآخرين، وقد يقومون بأكثر من ذلك، فما الذي تغيّر عندهم؟ طبعاً، ليست القناعات الشخصية، بحيث ما عادوا يرون في الوحدة قوة للمجتمع أو الأمة أو الوطن، بل تقولبت آراؤهم وفق تأثيرات العقل الجمعي الّذي خضعوا له، وأرخوا له عقالهم، وألغوا لحسابه كل قناعاتهم.
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المنطق عندما تحدث عن الذين واجهوا الأنبياء والرسل: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ} وقوله سبحانه: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ}.
وقد أشار إلى ذلك الإمام الكاظم عندما قال لأحد أصحابه: "لا تكن إمَّعة، فقد نهى رسول الله(ص) الرجل أن يكون إمعة… وعندما قيل له: وما الإمَّعة؟ قال: قال(ص): لا تقولن أنا مع الناس، وأنا كواحد من الناس.. إنما هما نجدان: نجد خير، ونجد شر، فما بال نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير".
ولا تقف التأثيرات في عقل الإنسان وتفكيره وقراراته على ما يسمى بالعقل الجمعي، بل ترى من يخضع فكره لأشخاص يلقي عليهم ثوب القداسة، فيتعصَّب لهم ويستسلم لمنطقهم، من دون أن يضع في حساباته أن هؤلاء ليسوا معصومين، فهم قد يصيبون ويخطئون وقد يتبدلون ويتغيرون.
والبعض قد يخضع لمنطق السلطة؛ سلطة المال، أو سلطة الموقع، أو سلطة القوة، فلا يعود له قرار أو موقف تجاهها.. ويرى ما تراه، وأنها هي التي تهديه إلى سبيل الرشاد، ويبدل مواقفه لحسابها…
وقد يخضع البعض وينحاز لردود الأفعال ضد من يخالفونه في الدين أو المذهب أو الموقع السياسي الآخر، فهو لا ينطلق من وحي ما فيه مصلحة مجتمع أو أمة، أو من مواقف ثابتة بناها، بل مواقفه تنشأ من فعل نكاية بالآخر، أو معاكسة له، فإذا أيد الآخر هو يعارض، وإذا وقف مع جهة، هو يقف مع من يعاكسها وغير ذلك مما يخضع له.
أيها الأحبة:
إن حجم التأثير هو الدافع.. فنحن لا نعيش في جزيرة معزولة.. وحتى لو أردنا، فقد أصبح العالم مفتوحاً مشرّعاً على كل الرياح العاتية التي تهب في كل مكان.. من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل والإثارات الفكرية والأخلاقية التي تنتجها مراكز التوجيه والدراسات.. والعادات باتت تنتقل من مكان إلى آخر بدون استثناء…
إن مواجهة كل ذلك يحتاج إلى توفر عدة شروط:
أولاً: الوعي؛ أن نعي أننا وأفكارنا وإدراكاتنا نتيجة لعوامل كثيرة وتأثيرات متعددة، بعضها ليس بالتماسك الفكري الذي نصوره لأنفسنا.. قد يكون مما صنع لنا ودخل عقولنا خلسة وبدون استئذان ما أو تمحيص، قد يكون مما زين لنا بثوب الحق وهو ليس كذلك.. إن علينا أن نعي أن أفكارنا وإدراكاتنا ليست حقيقة، هي إذاً دعوة للتواضع والنظرة إلى الآخر بشكل مختلف.
ثانياً: العمل على عزل العوامل التي تحيط بنا، فعندما ترى نفسك ذاهباً في اتجاه فكري محتد وضاغط، لا بد من أن تعمل على تفكيك هذه الآراء والتصرفات وعزل العوامل الدخيلة علينا…
نعم، من السذاجة، وكما بات واضحاً بمكان، أن نتوقع من أنفسنا أو من غيرنا عزل كل العوامل والتأثيرات، فهذا محال.. ولكن في مواجهة العصبيات والكراهية وأذى الغير.. علينا أن نبذل مجهوداً كما بين رسول الله عن الله، كما ذكرت الآية التي بدأنا بها الخطبة، بأن نفكر بكل ما يرد إلينا.. أن نضع كل ما يرد إلى أسماعنا وأبصارنا على طاولة البحث والنقد وتحت المجهر، بعيداً عن ضجيج المجتمع وضغوط المال والسلطة والأشخاص، لتكون خياراتنا وفقاً لقناعاتنا لا لقناعات الآخرين.. ولا يمنع أن نأخذ من الآخر، بل هو مطلوب.. فقد نأخذ من الآخرين وقد نستفيد منهم، ولكن بعد أن ندقق ونفكر..
لقد أراد الله أن نكون أحراراً في الدنيا، ولا بد من أن نكون أحراراً؛ أحرار الجسد وأحرار الفكر، وأن نكون في قمة العبودية لله.. أن نكون في كل ذلك له وحده.. وأن نتذكر الحقيقة التي قد تغيب عنا عندما نعير عقولنا للآخرين أو نكون صدى لهم.. إننا سنقف وحدنا بين يدي الله فيما كل الآخرين سيتنصلون منا ولن يغنوا عنا من الله شيئاً، كما قال سبحانه: {وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً} {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً}.
وقال سبحانه: {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ}.
أيها الأحبة: لا بدّ من أن نحذر من المقولات التي تصدر عن البعض.. أن لا تكون مقولاتنا.. لا أستطيع السيطرة على نفسي.. الظروف المحيطة بي أقوى مني.. إذا لم أنسجم مع الآخرين فيما يفكرون، فسأكون غريباً عنهم..
هذه المقولات لا ينبغي أن تصدر على مستوى الفكر والرأي والقناعات.. فالحياة لا تحيا ولا تستمر إلا بالاستثنائيين الّذين لا يخضعون للسائد والمشهور وللجو العام.. فإذا اقتنع الإنسان بصلاح عمل، فلا ينبغي أن يعير آذاناً صاغية لكلام الناس، وإذا اقتنع ببطلان عمل فعليه أن لا يهتم بما يقولون.. فكثير من الناس لا ينطلقون من حجة دامغة أو برهان، وأكثرهم يطلقون الكلام على عواهنه، أو يتكلمون بما لا أساس له.
أيها الأحبة: إنّ التزام المنهجية السليمة في التفكير هو قيمة عليا بغض النظر عما قد تصل إليه من نتائج.. فالإنسان لا يؤاخذ بخطئه عقلاً وشرعاً ما قد دام قد بذل جهداً للوصول إلى الحقيقة.. ولهذا يُعذر المجتهد عندما يخطئ.. والاجتهاد لا يقف عند حدود الفقه، بل يمتد إلى كل المساحات…
فمصيرنا ومصير الحياة من حولنا مرهون بالتفكير الموضوعي الجاد البعيد عن التعصب للأفكار والمصالح…
لذا، رأفة بأنفسنا وبالحياة، لنعطِ عقولنا فرصة للتفكير بحرية، بأن لا نقيدها بالأفكار المسبقة أو الأهواء أو العصبيات… أن نعطي لأنفسنا الوقت الكافي حتى نفكر وندرس ونراجع ونحاكم كل شيء يقدم لنا، لنخرج من ضجيج الواقع الذي يحيط بنا، والصخب الذي نعيشه، إلى هدوء الفكر..
لنتقِّ الله في سلامة فكرنا، فإننا سنسأل عنه، ومن أين أتينا به، وكيف حركناه، فهذا هو ما أراد الله عندما قال:
{وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}.
اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُوبِنَا، وَحَرَكَاتِ أَعْضَائِنَا، وَلَمَحَاتِ أَعْيُنِنَا، وَلَهَجَاتِ أَلْسِنَتِنَا.. فِيْ مُوجِبَاتِ ثَوَابِكَ، حَتَّى لاَ تَفُوتَنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ بِهَا جَزَآءَكَ، وَلا تَبْقَى لَنَا سَيِّئـةٌ نَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابَكَ.
الخطبة الثانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، والتقوى هي أن نعبده وأن نخضع له، وقد بيّن لنا ذلك الإمام الجواد(ع)، الَّذي نستعيد ذكرى ولادته في العاشر من هذا الشَّهر، عندما قال: "من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان النّاطق يؤدي عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس".
فأنت عندما تصغي إلى إنسانٍ، ينشدّ إليه فكرك وقلبك، فأنت تعبده لأنَّك تخضع فكرك له، وبالتالي مواقفك وسلوكك وحركاتك، فإن كان ينطق عن الله ويعبِّر عنه، فأنت في حالة عبادة لله، أما إذا كان ينطق بغير ما يريده الله، بحيث يكذب عليه، أو عمّن يعبرون عنه، أو يسيء إلى أحكامه وشريعته، أو يخرِّب على الإنسان أخلاقه وقيمه، فأنت هنا تعبد الشيطان.
ولذلك، أيها الأحبة، عندما تصغون إلى أحد، أكان خطيباً أم واعظاً، مباشرةً أو عبر شاشات التلفاز أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتّشوا عمّن يمثِّل في فكره، حتّى لا يخدعنا أحد ونقع في مصيدة شيطان هو بصورة إنسان، وبذلك نكون أصحاب وعي في الدّين والسّياسة والاجتماع وكل مفاصل الحياة، وبذلك نواجه التحدّيات…
لبنان
والبداية من لبنان، حيث مرَّت علينا الذكرى الواحدة والأربعون للحرب الأهليّة المشؤومة، التي اكتوى اللبنانيون بنيرانها، ولم تنتهِ آثارها على العديد من الصعد، حيث لا يزال مصير عدد كبير ممن خُطفوا أثناءها مجهولاً، رغم أنَّ أغلب رجالات الحرب هم الَّذين يحكمون البلد. ونحن عندما نستذكر هذه الحرب، فإننا لا نستذكرها لنكء الجراح أو لإعادة فتح ملفاتها السوداء، وإن كنا نتمنّى لو أن الذين أداروا الحرب وارتكبوا ما ارتكبوه خلالها، لم يُكافأوا، بحيث يتصدرون المواقع العليا في طوائفهم أو على مستوى الوطن.
إننا نستذكرها حتى نعي تلك الصفحات السوداء، لكي نعتبر منها، وكي لا تتكرر بأشكالٍ جديدة، وحتى يكون لدينا المناعة، فلا نكون ضحايا لحروب الآخرين على أرضنا، وحتى لا يُلدغ المرء من جحرٍ مرتين فيما كنا نعتقد أنها حرب مقدسة، حيث اعتقد الأفرقاء الَّذين دخلوا في الصراع آنذاك، أن كلاً منهم قادر على أن يُحدث تغييراً في البلد لمصلحته أو لمصلحة طائفته، وأن يُمسك بقرار البلد إلى حيث يريد، من خلال استقوائه بهذا البلد الإقليمي أو ذاك، أو هذا المحور الدولي أو ذاك، ولكن سرعان ما كشفت الأيام أنهم جميعاً لم يكونوا سوى أدوات في صراع المحاور الإقليمية والدولية، التي كانت تقدّم الدّعم لمواصلة الحرب، لا لسواد عيون هذه الطائفة أو تلك، أو هذا الموقع السياسي أو ذاك، بل لتصفية حساباتها ولتمرير مشاريع كانت تُرسم للمنطقة، وعلى رأسها تصفية القضيّة الفلسطينيّة، وبعد أن صفيت الحسابات، وتحقّقت الأهداف المرجوّة من هذه الحروب، ومن دون النظر إلى كل آلام الناس وجراحهم، وآهات المعذبين فيها، جلس القادة اللبنانيون بكل طوائفهم في الطائف، وبنده الوحيد كان إخماد نار الحرب التي أكلت أخضر لبنان ويابسه، واكتشف الجميع أنهم خدعوا لأنهم استكانوا للخوف الذي زُرِع فيهم، أو لأحلام التغيير التي منّوا أنفسهم بها، وأنهم لم يكونوا سوى وقود لحرب الآخرين على أرضهم.
إنَّنا نخشى كثيراً أن تتكرَّر هذه التجربة مجدداً بصور وأشكال أخرى، في ظلّ تنامي الاحتقان الطّائفيّ والمذهبيّ والسياسيّ والتخويف، حيث يعمل البعض على تخويف المسلمين من المسيحيين، والمسيحيين من المسلمين، وتخويف السنّة من الشيعة، والشيعة من السنة، وتخويف المواقع السياسية من بعضها البعض، ووسط احتدام الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة الذي يشكّل البيئة الخصبة لإدارة الصّراع الدّاخليّ وفق مصالح الكبار، التي قد تقتضي التصعيد تارةً والتبريد تارةً أخرى.
إنَّ الأمان القائم في لبنان قد يُفقد، والغطاء الإقليميّ والدوليّ الموجود فيه قد يُثقب، فيجد اللبنانيون أنفسهم أمام دمار الحجر والبشر، ويكررون أخطاء الماضي. وحتى لا نكرّر المأساة مجدداً، علينا أن نصغي إلى لغة العقل، وأن نعزّز لغة الحوار الهادئ ولغة التواصل، وأن نبرّد الخوف المصطنع، ونبني دولة الإنسان لا دولة الطّوائف؛ الدَّولة القويّة العادلة البعيدة عن الاستئثار والمحاصصة والفساد، فالفساد والغبن والاستئثار والهيمنة هي مشاريع حرب ولن تصنع سلاماً.
القمة الإسلامية
في هذا الوقت، تأتي القمة الإسلاميَّة وسط احتدام الصراع الذي يجري بين العديد من دولها، وفي ظلّ تنامي المشاعر المذهبية وبروز المنطق التكفيري، الَّذي أفسح المجال واسعاً للتدخّلات الدوليّة التي باتت شبه متحكّمة بمسار الحرب الدّائرة في المنطقة.
إننا في الوقت الذي نأمل أن تساهم هذه القمة في فتح قنوات الحوار بين الدّول المتصارعة، ومدّ الجسور فيما بينها، والمساهمة في تبريد الجبهات المشتعلة في أكثر من بلد، وتوحيد الطاقات لمواجهة الإرهاب، نخشى أن تساهم في زيادة الشرخ، وتعميق الصّراعات، وإذكاء النيران في القلوب والنفوس.
لقد آن الأوان للعالم الإسلاميّ أن يعي أنَّ مشكلته ليست في هذا البلد العربيّ أو الإسلاميّ أو ذاك، بقدر ما هي في الّذين قرروا استنزافه في الصراعات الدائمة، حتى يبقى بقرة حلوباً لمصانع أسلحتهم، ولتعزيز ثرواتهم، وليكون الكيان الصهيوني هو الأقوى.
لقد وجدت منظَّمة التَّعاون الإسلاميّ كنتيجة لإقدام الكيان الصّهيونيّ على إحراق المسجد الأقصى، لتشكّل قوّة رادعة لهذا العدوّ ولكلّ أعداء الأمة الإسلامية، فهل تؤدي هذا الدور أو أصبحنا كالذين تحدَّث عنهم القرآن الكريم: {بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى}؟! فلا يمكن لمؤتمر منطلقه فلسطين إلا أن يكون حريصاً على أولئك الَّذين وقفوا في وجه كيان العدو الصهيوني، وسجلوا نصراً عزيزاً، وشكّلوا نموذجاً يُحتذى به، ولا يمكن لمؤتمر عنوانه الوحدة والتضامن، إلا أن يمدّ جسور التّواصل فيما بين المسلمين، وهذا هو الضّمان لقوّة هذا العالم العربيّ والإسلاميّ، الَّذي لا يقوى بتجمّع الضّعفاء، بل بتجمّع الأقوياء…