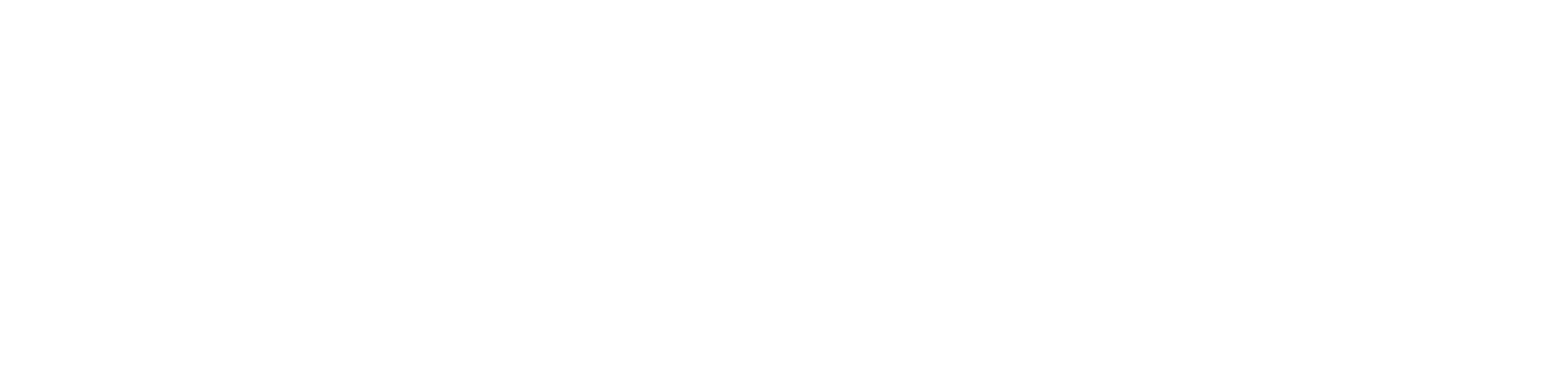بالعودة إلى عاشوراء نستعيد معاني الرحمة بين المسلمين
ألقى سماحة العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبتيه:
الخطبة الأولى
لم يتحدَّث الله سبحانه وتعالى عن رسوله كما تحدَّث عن رحمته: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}[التوبة: 128]. ورحمة رسول الله كانت خياره، ومن قبل أن يُبعث نبيّاً، وبقيت السّمة الأبرز في شخصيَّته لما بعد المبعث، ولهذا كانت الرَّحمة عنواناً له ولرسالته {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}[الأنبياء: 107].
سيرةٌ ملؤها الرّحمة
وإنَّنا بحاجة إلى أن نستعيد الحديث عن رحمة رسول الله ونحن نعيش أجواء كربلاء، ففي غمار تلك الرّحمة تربّى الحسين، ونهل من معين قلبٍ اتّسع لهموم الإنسان، حتّى وإن كان عدوّاً. فهو الرّحمة بعينها، هو التّراحم والمرحمة، ومهما قلّبت في سيرته العطرة، فإنّك لن تعثر على موقف خلا من الرّحمة في ظاهره أو في أبعاده، في الحرب أو السّلم، مع القريب أو البعيد، مع من آمن به ومن لم يؤمن… إنّه مدرسة في الرّحمة للعالم أجمع. ومن سيرته الطّاهرة أنّه:
كان يجالس الفقراء والمساكين ويؤاكلهم، عطفاً منه ومواساة.
وكان حريصاً على أن يتفقّد أصحابه واحداً واحداً، فإن كان أحدهم غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده… لقد كان(ص) يبذل المجهود ليوصل إليهم محبّته وعطفه الخالص لوجه الله.. وهو رسول الله وخير خلق الله.
أمّا الصّغار، فلطالما دعا للرّحمة بهم، وهو من كان يقول: «ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا»، وكان لا يقبل بأن يساء إلى الأطفال، أو أن يقسى عليهم ولو من خلال نبرة صوت، حتّى وإن أساؤوا إلى طهارة مسجده بعض الأحيان، كما حصل في أحد الأيّام في مسجده في المدينة.. وكان يعتبر أنّ النّجاسات هي بقع نزيلها بالماء، ولكنّ البقع الّتي تحدث في قلوب الصّغار جرّاء القسوة، من الصّعب إزالتها..
وكما الصّغار، كذلك اهتمّ رسول الله بكبار السّنّ، ودعا إلى توقيرهم لسنّهم، فهم إن لم يكونوا الأسبق إسلاماً، فإنّهم الأكثر تجربة وخبرة في الحياة، وهو الّذي قال: «ليس بمسلم من لم يوقّر كبيرنا».
والرّسول(ص) لم يكن في سلوكه التّراحميّ هذا يريد أن يسجّل موقفاً تربويّاً نظريّاً، بل كان يتألّم حقيقةً لآلام الآخرين من حوله ويشفق عليهم. وقصّته مع جاره الّذي طالما آذاه بوضع النّفايات والأوساخ في طريقه معروفة، إذ إنَّه(ص) لما علم يوماً بمرضه، عندما لم يجد الأوساخ موضوعةً كالعادة، أسرع إليه ليطمئنّ عليه، من باب رحمته بالضّعفاء من حوله. والمرض، كما الفقر كما الذّل، هي حالات ضعف لأصحابها. حتّى الّذي يظلم ويؤذي هو ضعيف، لهذا كان دعاؤه للّذين حاربوه: «اللّهمَّ اهدِ قومي فإنّهم لا يعلمون».. لذلك عندما قيل له ادع على المشركين، قال» :إنّي لم أُبعث لعّاناً، وإنّما بُعثت رحمةً مهداة«.
وبقي رسول الله هكذا، لم تغادره الرّحمة حتى عندما صار جيشه يعدّ بالآلاف، كما حصل عند دخوله مكّة فاتحاً، إذ سأل أهلها يومها عندما اجتمعوا إليه: "يا معْشَرَ قريش، ما ترون أنّي فاعل بكم؟"، قالوا: "خيراً، أخٌ كريم وابن أخ كريم"، فقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطّلقاء". وأكثر من هذا، لقد اقتضت رحمة رسول الله وشدّة عطفه ورحمته، أن يبكي على الّذين لم يؤمنوا، لما سيؤول إليه حالهم عندما يقفون بين يدي الله، حتّى نزلت هذه الآية لتخفّف عنه: {فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ}[فاطر: 8].
ولم تقف حدود رحمة رسول الله عند الإنسان، بل امتدّت إلى كلّ ذي روح من الحيوان.
وتعالوا نتأمّل هذه الحادثة الّتي رواها ابن مسعود قائلاً: كنّا مع النبيّ في سفر…، فرأينا حُمّرَةً معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحُمّرةُ فجعلت تَعْرِشُ، فلمّا جاء رسول الله، تأمّل هذه العصفورة، ورآها حيرانة، فأدرك بإحساسه ما تعانيه، وقال لهم هذا الكلام العاطفيّ: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها».
هذا هو قلب رسول الله الّذي مُلئ رحمة وعطفاً، رقّة وإشفاقاً، حتّى إنّ دموعه كانت تنساب لمشهد إنسان يتعذّب أو يتألّم، أو لموت إنسان عزيز، وهو من بكى ولده إبراهيم عندما توفّي، وعندما قيل له: يا رسول الله، أنت تبكي؟ اعتقاداً منهم أنّ البكاء يتعارض مع الصّبر، قال: إنّها الرّحمة.. ثم قال: «إنّ العين لتدمع، وإنّ القلب ليحزن، ولكن لا نقول ما لا يرضي الله».
وهو الّذي أنزل فاطمة بنت أسد أمّ عليّ إلى قبرها وبكاها قائلاً: «رحمك الله يا أمّي، كنت أمّي بعد أمّي»، وهو الّذي بكى أمّه وبكى خديجة وبكى الحمزة.
هذه الرّحمة هي الّتي جعلته يبكي الشّهداء، مع أنّه يعلم أنّهم أحياء عند ربّهم يرزقون..
فاجعة كربلاء
ونحن في أجواء رحمة رسول الله، نعيش فاجعة كربلاء، ونتساءل بحرقة: تُرى، هذا القلب الحاني، الممتلئ عطفاً ورحمة، كيف كان حاله وهو في عليائه، يشهد تلك الأجساد من أهل بيته وأصحابه، وقد ملأت رمضاء كربلاء، ومزّقتها السّيوف؟
كيف بقلب رسول الله وهو يرى فاطمة ابنته وبضعته الّتي طالما قال عنها: «من أذاها فقد أذاني»، وقد فُجعت بولدها وسبيت ابنتها؟
كيف بقلب رسول الله العطوف الحنون، وهو يرى الثلّة الطّاهرة المؤمنة المجاهدة، تُعاقَب هي وأطفالها ونساؤها بالعطش والحصار والرّماح والسّيوف؟
وكيف به وهو يرى رأس الحسين(ع) مرفوعاً على الرّماح، الحسين الّذي طالما قبّله ووضعه في حجره وأركبه ظهره ليؤنسه وليفرحه مع أخيه الحسن؟
نقولها لكلّ المسلمين: قد لا نحتاج في الحديث عن الحسين(ع) وكربلاء إلى أن نبيّن الكثير، أو نفنّد الظّروف الّتي أدّت إلى ذلك، وندخل في التّحليلات والاستنتاجات، يكفينا أن نذكّر ببعض ما قاله رسول الله(ص) عن الحسين(ع)، ورسول الله لا يتحدّث عاطفةً، ولا ينطلق من حسابات خاصّة، وهو الّذي لا ينطق عن الهوى.. أقوال لطالما كرّرها على مسامع المسلمين: «حسين مني وأنا من حسين»، «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»، «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا».
«اللّهمّ إنَّك تعلم أنّي أحبّه»، ومن هنا شرعيَّة منطلقات الحسين وأهدافه وشعاراته وشرعيَّة الأسلوب الّذي اتّبعه.
من هنا، على كلّ المسلمين، وليس بعض مذاهبهم فقط، أن يقفوا عند كلّ ما أنتجه ذلك اليوم الأسود من عاشوراء، ويزيلوا الغشاوة الّتي تمّ وضعها، وأن يعوا أنّ ما حدث ليس مشكلة بين فئتين أو عائلتين؛ بين بني سفيان وبني هاشم، المشكلة هي مشكلة هؤلاء المسلمين مع رسولهم الّذي أوصاهم بهذه الوصيّة: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[الشّورى: 23].
العودة إلى قيم عاشوراء
أيّها الأحبّة.. لقد شكّلت عاشوراء مفترقاً وانفصالاً ما بين هدف الرّسالة وغايتها، ألا وهي الرّحمة، وبين الهويّة الشكليّة بأن يكون الإنسان مسلماً. فأيُّ مفارقة هذه، وأيّ مأساة هي أن ينزع المسلمون عنهم ثوب الرّحمة، ويعودوا ليلبسوا ثوب التعصّب وأغلال الأحقاد والضّغينة، ولا سيَّما مع بعضهم البعض، مع أنَّ الرَّسول أوصاهم بأن لا يعودوا بعده كفّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض.
لهذا، لا بدَّ من أن تكون هذه الذّكرى حاضرةً لدى الجميع، لا أن يتربَّى عليها بعض أجيال المسلمين دون البعض الآخر، المطلوب أن يدخل مضمون عاشوراء إلى الوجدان والعاطفة والعقل، كي يتعلّم المسلمون:
ـ أنّه إذا غابت الرَّحمة، لم يبق لهم شيء يربطهم برسول الله سوى الاسم.
ـ وإذا غابت الرَّحمة، حوَّلوا دينهم إلى سلاح مفزع وخطير.
ـ وإذا غابت الرّحمة بينهم، سلّط الله عليهم من لا يرحمهم.
ـ وإذا غابت الرّحمة، خسروا الدّنيا والآخرة.
الرّحمة مفردة باتت ـ وللأسف ـ غريبة في عالم المسلمين الّذين يأخذون أبعد المسافات عنها، وإلا بماذا نفسّر أن يروّع مسلم مسلماً، أن يقتل مسلم مسلماً؟! وليس هذا فقط، بل أن يختار من الأساليب أشنعها وأبشعها، ثم لا يستحي، بل يتباهى. وليس هذا فقط، بل يسجّل فعلته ويصوّرها ليريها للعالم كلّه..
فأيّ قسوة هذه، وأيّ ضياع نعيشه؟
أيّها الأحبّة: إنّنا نرى بعض مآسي كربلاء يُعاد إحياؤها بشكلٍ أو بآخر في بلاد المسلمين، باستهداف الأبرياء والمظلومين، وباستهداف أصحاب الحقّ ورافضي الظّلم ومستنكري المنكر، وباستهداف كلّ من يحمل قيم "لا أعطيكم بيدي إعطاء الذّليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد".
فلنعد كمسلمين إلى عاشوراء، إلى ما جرى فيها، لعلّ ذلك يساهم في استعادة معاني الرّحمة المفقودة بيننا اليوم، الرّحمة الّتي أرادها الله للمسلمين، والّتي جسّدها رسول الله وأرادها أن تكون عنواناً لأصحابه. {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ}[الفتح: 29].
عظّم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين وأصحابه.
والسَّلام على الحسين، وعلى أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين.
والحمد لله ربِّ العالمين.
الخطبة الثّانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ومن التَّقوى أن نستهدي بعاشوراء، فهي ليست ذكرى في التّاريخ تنتهي بانتهاء أيّامها، فيذهب كلّ منّا إلى بيته بعد العاشر من محرّم وينساها، بل هي حاضر ومستقبل تتكرّر كلّما تكرَّرت أسبابها الّتي أشار إليها الإمام الحسين(ع) في بيان ثورته: "ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشّيطان، وتركوا طاعة الرّحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر".
إنَّ الحسين(ع) ليس ثائراً في التّاريخ فحسب، بل هو إمام وقدوة للأحرار وكلّ المسلمين، ولذلك، ستبقى عاشوراء تستصرخنا وتدعونا إليها ما دام الشّيطان يتحكَّم بالعقول والقلوب والنّفوس، فيُعصى الله، ويُساء إلى دينه وشريعته، وما دام الحلال يُحرَّم والحرام يُحلَّل في واقعنا، حيث تنقلب المقاييس وتتغيّر وفقاً للأهواء، وما دام هناك من يستهين بمصالح العباد والبلاد، وما دام المال العام يبذّر ويُستأثر به، وما دام هناك ابن ستّ وابن جارية أمام القانون والقضاء وفي العالم، وما دام هناك إنسان يُظلم ويُستعبد، وطاغية يتجبَّر، وحقّ يُداس.
أيّها الحسينيّون، أيّتها الزينبيّات، لا يريد الإمام الحسين(ع) منّا أن نذرف الدّموع عليه فقط، أو أن نلبس السّواد لأجله، إنما يريد إلى جانب كلّ هذه المظاهر، أن نجدّد شعارات عاشوراء فينا، ويريد من كلّ فردٍ منّا أن يقول: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر كالحسين، أريد الإصلاح في أمّة رسول الله(ص)، أنا لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظّالمين إلا برماً. وعند مواجهة التحدّيات يقول: "والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذّليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد، هيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون!". وعندما يعاني يقول: "هوَّن ما نزل بي أنّه بعين الله".
ينتظر الإمام الحسين(ع) منّا هذه المواقف العزيزة الّتي نحتاج إليها لنصلح واقعنا ونواجه التحدّيات، ولا سيَّما أنّ المشهد العربي والإسلامي لا يزال قاتماً، والأمّة الّتي أرادها رسول الله أن تكون خير أمّة أخرجت للنّاس، تعاني التمزّق والانقسام، وعبث الاستكبار بمصالحها ومقدّراتها.
أزمة سوريا بين الحلّ والعرقلة
والبداية من سوريا، حيث تستمرّ معاناة إنسان هذا البلد، سواء في الدّاخل أو الخارج. وفي الوقت الّذي نسمع أحاديث عن أمل وتفاؤل بحلول قادمة تنهي نزيف الدّم والدّمار، بعد أن شعر الجميع بعدم إمكانيّة حسم الصّراع عن طريق الحلّ العسكريّ، لا زال هناك في هذا العالم من يراهن على إطالة أمد الأزمة في هذا البلد، لاستنزافه أكثر، ليأتي الحلّ ضمن حلول الملفّات الأخرى العالقة في المنطقة، أو لفرض واقع تقسيميٍّ في المنطقة على أساس طائفيّ أو مذهبيّ، ما يجعل المنطقة في مهبّ رياح الفتنة، فهناك من لا يفكّر إلا في التّنفيس عن أحقاد ذات طابع طائفي أو مذهبي أو سياسي.
ومن هذا المنطلق، نجدّد الدّعوة لكلّ الأطراف السوريّين، من الحكومة والمعارضة وكلّ الغيارى على البلد، أن يفرضوا حوارهم على كلّ العالم من حولهم، وأن يمدّوا أيديهم إلى بعضهم بعضاً، حرصاً على بلدهم وإنسانهم، فالفرصة ما زالت سانحة للحوار.
وعلى المعنيّين في الدول العربية والإسلامية، أن يبذلوا كلّ جهودهم من أجل مساعدة السوريّين على إجراء هذا الحوار، وعدم عرقلة أيّة مساعٍ للتسوية، بالتشدّد في طرح الشّروط، أو الرهان على تغيّر الظّروف على الأرض في هذه الدّولة الكبرى أو تلك، فالتشدّد يستدعي التشدّد، والرّهان يسقط تلو الرّهان، والعنف يستدعي عنفاً مضادّاً، وقد باتت الحاجة ماسّةً إلى معالجة هذا الملفّ، فإذا استمرّ على حاله، ستكون تداعياته خطيرة على كلّ العالم العربي والإسلامي، ولا سيَّما الدّول المحيطة بهذا البلد، كلبنان والأردن والعراق.
مصر: احترام خيار التّغيير
أمّا مصر، فإنّنا نأمل أن تخرج مما تعانيه، وأن تنتقل من مرحلة الملاحقات والاعتقالات، إلى مرحلة الحوار الجدّيّ وبناء الدّولة والوطن، مما انطلقت ثورة الشّعب المصريّ على أساسه. ومن هنا، نعيد التّشديد على ضرورة احترام خيار هذا الشّعب وتطلّعه نحو التّغيير، بعيداً عن أيّ استئثار أو تشفٍّ أو انتقام، لتسترجع مصر دورها الرّياديّ على المستوى العربي والإسلامي.
فلسطين: مفاوضات بلا أفق
ونتطلَّع إلى فلسطين، الّتي يواصل العدوّ فيها سياسة الاعتقال والقتل والاغتيال والاستيطان، إلى جانب عدوانه المستمرّ على القدس والمسجد الأقصى، في الوقت الّذي تستمرّ المفاوضات التي لا يريد العدوّ الصّهيونيّ منها سوى الدّيكور، وتجميل صورته أمام العالم، زاعماً أنّه يريد السّلام، وأنَّ الفلسطينيّين هم سبب العلّة، فيما يتابع كلّ مشاريعه الاستيطانيّة وتهويد فلسطين، وهو في ذلك غير آبه بتهديدات المفاوض الفلسطيني بترك المفاوضات، ولا بالضّغط الأميركي الّذي لن يأتي. وكلّ العالم بات يعرف أنَّ أكثر ما يمكن توقّعه، هو تكرار الدّعوة إلى تجميد الاستيطان، وتطييب خاطر الفلسطينيّين ببعض المعونات الأميركيّة الّتي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي هذا السّياق، يأتي التّقرير الدّولي الّذي يعلن اغتيال الرّئيس الفلسطيني ياسر عرفات، عبر تسميمه بمادّة البولونيوم، ليؤكّد الطبيعة الغادرة لهذا العدوّ الصّهيونيّ، الّذي كان يمدّ يداً للسّلام ويقتل باليد الأخرى، ونحن نأمل أن يكون ما حصل درساً لكلّ من يفاوض هذا الكيان، واختباراً لهذا العالم الّذي ننتظر كيف سيتعامل مع هذه القضيّة، رغم أنّنا نعرف سلفاً، أنّه لن يكون جادّاً في إجراء تحقيق دوليّ عادل، أو في تشكيل محكمة دوليّة لمحاكمة هذا الكيان على جريمته.
لقد بات العالم العربي بحاجة إلى وقفة داخليّة مع الذّات، لرفض خيار الفوضى والانقسام الّذي يضرب قلب هذا العالم، وللتّخطيط ورصد كلّ الإمكانات لاستعادة الأمن في بلداننا وتوحيد شعوبنا، من خلال صياغة التّفاهمات والمصالحات السياسيّة، ما يعزّز قوّة الأمّة، ويدعم الشّعب الفلسطيني لاستعادة القدس وتحرير فلسطين.
لبنان أسير رهانات الخارج
أمّا لبنان، فلا يزال أسير رهانات الخارج، والخطاب المتشنّج الّذي يزيد من توتير السّاحة الداخليّة ويعمّق جراحاتها، في ظلِّ سعي بعض الدّول لجعله ورقةً يتمّ التّداول بها في ساحة المساومات، ليكون أسيراً لهذه الدّولة أو تلك، بعيداً عن إرادة اللّبنانيّين، في الوقت الّذي تستمرّ أزماته السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة والمعيشيّة. ومن هنا، ندعو الجميع إلى أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم تجاه هذا البلد، وأن يرأفوا به، فقد جرّبنا رهانات الخارج والسّقوف العالية والكلام التّهديديّ والوعيد، ولم ينتج ذلك إلا المزيد من الفتن، وتعميق الهوّة بين اللّبنانيّين، وتشريع البلد على رياح الآخرين العاتية ومصالحهم، وها نحن نعاني من نتائجها.
فلنجرّب المراهنة على إنساننا ووحدتنا وحوارنا، وعلى تعميق القواسم المشتركة بيننا، وإزالة الهواجس، ولنبتعد عن التّعامل مع بعضنا بعضاً وفقاً لسياسة المنتصر والمهزوم. ونحن في هذا المجال، مع كلّ حوار بين المواقع السياسيّة المختلفة، شرط أن يكون مقدّمة لحوار جامع وشامل يوحّد اللّبنانيّين، فهذا هو السّبيل الوحيد للخروج من أزماتنا، ولا سيّما أنّنا لا نزال نعاني الخطر الدّاهم الّذي يهدّد أمننا؛ خطر العدوّ الصّهيونيّ الّذي تمثّل أخيراً بالتجسّس الفاضح على طول حدود هذا البلد مع فلسطين المحتلّة، الأمر الّذي يستدعي تحرّكاً واسعاً من الجميع، وخصوصاً أولئك الّذين يتحدّثون عن السيادة واستقرار البلد.
إنّنا نخشى على لبنان من حالة الهروب إلى الأمام من كلّ الأزمات الأمنيّة والاقتصاديّة الّتي يعيشها، ونخشى أن تزحف إلينا تداعيات المنطقة الّتي تبدو مقبلة على شتاءٍ حارّ، وعلى مزيد من الصّراع والفتن. ولذلك، فإنّ المطلوب هو المسارعة في معالجة كلّ الملفّات والاستحقاقات، قبل أن ندخل في متاهة الأزمة السوريّة والأنفاق المظلمة لأزمات المنطقة.