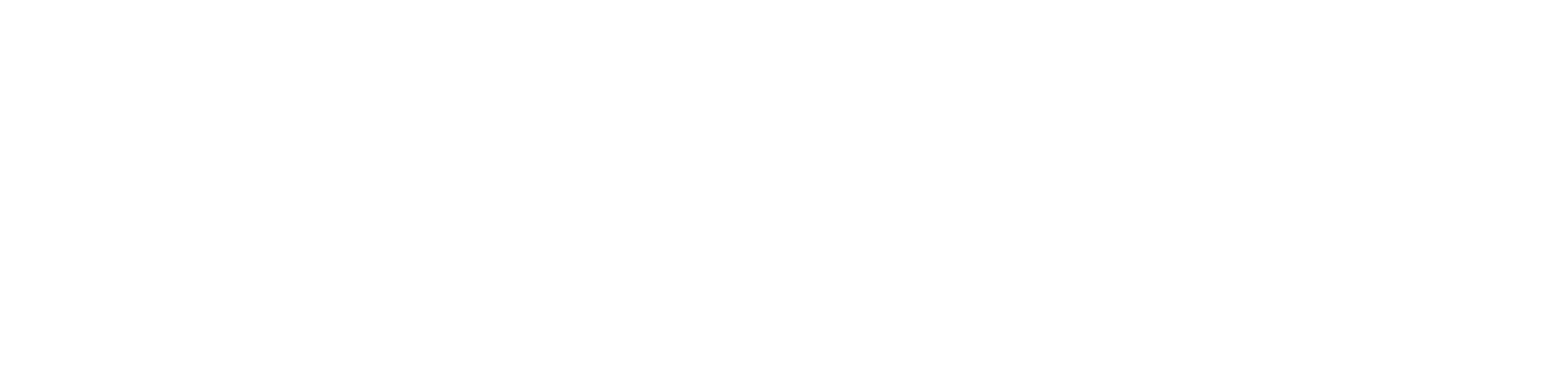الرَّسول الّذي سجَّل أعظم مثالٍ في العفو والرَّحمة
|
{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}[الفتح: 1-2]. يوم فتح مكَّة لم يكن يوم فتح مكّة الّذي نعيش ذكراه في العشرين من شهر رمضان، يوماً عاديّاً كباقي أيّام الفتوحات في التّاريخ. صحيح أنّه لم يستغرق شهوراً أو سنوات، لكنّ الفاتح ليس كالآخرين، ولا النّتائج شابهت ما عرفه التّاريخ في مثل هذه المعارك. صحيح أنّه كان عملاً عسكريّاً، لكنّه كان العمل العسكريّ الّذي زاوج بين الأخلاق والحرب، والتّوفيق بين الغاية والوسيلة. كان باختصار يوم عزّة ونصر، وفي الوقت نفسه، يوم رحمة وتواضع. ويوم الفتح هذا كان حصيلة سنوات من جهاد رسول الله(ص) وأصحابه، سنوات من المعاناة والصّبر والثّبات واليقين بأنّ الله ناصرهم. لم تُرق خلال تلك السّنوات نقطة دم هدراً. كلّ الصّبر على النّفي والإبعاد، وكلّ التضحيات كانت أقساطاً من ضريبة الفتح، لا شيء جاء مجّاناً. في صلح الحديبية الّذي حصل بين قريش والرّسول(ص)، أُبرِم اتّفاقُ عدم اعتداء بين الطّرفين، وكان ينسحب على الحلفاء أيضاً، لكنّ غرور قريش وصلفها، دفعاها إلى نقض هذا الاتّفاق، عندما حرَّضت وأعانت حليفتها قبيلة بني بكر على قبيلة خزاعة حليفة الرَّسول(ص)، حيث هاجموها، وقتلوا منها عدداً من الرّجال. وجنت على نفسها قريش، لأنَّ خزاعة طلبت من الرَّسول(ص) النّصرة، ولم يتردَّد الرَّسول في طلب الحماية والرّدع، وقرّر(ص) أن يغزو مكّة، ولا سيّما عندما نزلت عليه الآيات واعدةً إيّاه بالنّصر المؤزّر: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}[النصر: 1-3]. توجّه الرّسول(ص) على رأس جيشه إلى مكّة في العاشر من شهر رمضان، وأحاط سيره بكتمان شديد، حتّى وصلها بعد 10 أيّام، وعسكر على مشارفها. مفاجأة استراتيجيّة لم يقرع الرّسول(ص) طبول الحرب، ولا أعلن عن نيّته، جمع عشرة آلاف مقاتل، واتخذ تدابير مكّنته من إحراز مفاجأة استراتيجيّة. التّدبير الأوّل، وهو أنّه في ليلة الفتح، طلب الرّسول من كلّ مقاتل أن يوقد ناراً، وفوجئت قريش بهذا البحر من الأضواء. وأوّل انطباع كان هو ضخامة الجيش ورهبته. التّدبير الثّاني، تمثّل بأن طلب الرّسول من عمّه العباس أن يستدرج أبا سفيان عمّ النبيّ(ص)، كي يشاهد بأمّ العين جيش المسلمين عدّة وعديداً، وأخيراً ينصحه: إلحق بقومك سريعاً وحذّرهم. ووصل أبو سفيان ليقول للعبّاس: “لقد صار ملك ابن أخيك عظيماً”. ولأنّ قرار الرّسول كان أن يدخل مكّة من دون قتال وإراقة دم، لهذا، وهو التّدبير الثّالث الّذي اتخذه الرّسول، أراد أن يترك الباب مفتوحاً للتّوبة وللتّراجع، وأن يحيّد النّاس عن الدّخول في مواجهة، ليس من قبيل الخوف، بل من قبيل توفير الدّم والقتل، فأعلن أنّ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن لم يحمل السّلاح فهو آمن. التّدابير هذه أثارت بلبلةً عند قريش: ترهيب وتوهين نفسيّ، بعده أدلّة، بعدها طمأنة الرّسول للنّتائج إن لم يحاربوا.. وهكذا أخمدت إرادة القتال عند زعماء قريش، وخصوصاً أبا سفيان، الّذي عمل بنصيحة العبّاس، فأتى مكّة وهو يصرخ: يا معشر قريش، هذا محمّد قد جاءكم بما لا قِبل لكم به. من دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وهكذا أسلست قريش قيادها، وتخلّت عن غرورها، وفتحت مكّة ذراعيها لتستقبل يتيمها، يدخلها تحت رايات النّصر، وصيحات “الله أكبر”. النّصر نعمة وابتلاء أيّها الأحبّة: إنّ النّصر نعمة من عند الله سبحانه، لكنّه ابتلاء وامتحان يظهر معدن الإنسان، ويكشف طينته. فعلى مرّ التّاريخ، كان من يملك السّلطة والقوّة أقلّ النّاس تواضعاً ورحمة، وعند كلّ نصر يأخذهم العُجْب والكبرياء. كيف دخل محمّد بن عبدالله مكّة فاتحاً؟ وصل(ص) إلى منطقة «ذي طوى»، وهي مرتفع يشرف على مكّة وبيوتها، وفي هذه المنطقة، توقّف(ص) قبل سنوات وهو متخفّ، خارجاً منها مطارداً. تأمّل البيوت، تأمّل مكّة، ها هي الآن ملك يمينه، لكنّه لم يأتها غازياً شاهراً سيفه، بل فاتحاً قلبه ليغمرها برحمته.. دخل مكّة متخشّعاً، مطأطئاً رأسه خضوعاً وشكراً لله عزّ وجلّ.. لم يشمخ بأنفه ويتعال ويرفع هامته تيهاً وعزاً وتشوّفاً. كان ككلّ الأنبياء والمؤمنين، عزَّتهم من العزيز الرَّحيم، لهذا لم يستسلم لذلّ؛ ذلّ فقر أو عصبيّة أو ظلم أو صنميّة، ولذلك لم تكن عزّته عزّة مستأجرة أو مؤقّتة، أو قابلة للخلع أو المساومة أو التّجزئة. لهذا ظلّ محمّد بن عبدالله محمّداً اليتيم والفاتح، المطارَد والمنتصر، لم يغيّره اليتم، كما لم يغيّره المجد ولا الزّمن، رفضت قريش دعوته، حاربته، أنزلت به شتَّى أصناف العذاب، فهل ذلَّ أو استكان أو فكَّر للحظة في أن يعيد النَّظر في مشروعه؟! ظلّ عند قسمه: “والله لو وضعوا الشَّمس في يميني، والقمر في شمالي، على أن أترك هذا الأمر ما تركته، حتّى يظهره الله أو أقتل دونه”. هذا القسم تُرجم إلى سعي وجهاد، وها هم تلامذته وأصحابه والسّاعون في طريق الله، في طريقهم إلى دكّ حصن الشّرك، وتطهير الكعبة من آثام قريش ووثنيّتها… ولأنّ العزّة ليست تكبّراً أو تفاخراً، وليست بغياً أو عدواناً، لذلك لا عزَّة من دون رحمة، والله وصف ذاته بالقول: {وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[آل عمران: 62]. لهذا لم يكن يوم فتح مكَّة يوم عزَّة فحسب، بل يوم عزَّة ورحمة. بلغه أنَّ سعد بن عبادة، وهو أحد حملة ألوية الجيش الإسلاميّ، يصيح ويهتف: اليوم يوم الملحمة، اليوم تُسبى الحرمة، عندها أمر عليّاً(ع) ـ وهذا ما أكّده الشيخ المفيد ـ أن يأخذ منه الرّاية ويدخل بها مكّة دخولاً رقيقاً ويقول: “اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة، اليوم أعزّ الله قريشاً”. خلق عظيم لم ينس رسول الله ما فعلته قريش وطغاتها به وبأصحابه، ولا يوم قتلوا سميّة وياسر أمام ولدهما عمار.. قريش هذه فرضت عليه وعلى أصحابه وبني هاشم حصاراً دام ثلاث سنوات، حتّى أكلوا ورق الشّجر ونبات الأرض، وعانوا الجوع والاضطهاد. ولكن هل قابل السيّئة بالسيّئة؟ لا لم يفعل، لقد أرسله الله رحمةً للعالمين، فهل بإمكانه أن يكون سيف نقمة عليهم؟ إنّ الرّأفة والرّحمة خلق إلهيّ، زرعه الله في ذلك القلب الّذي حمل همّ من آمن برسالته وهمّ من وقف في وجهه، حمل همّهم وحزن لأجلهم.. ما أروع هذا الخلق! إذ لم يكن في قلبه رحمة عليهم فقط، بل كان حزيناً لأجلهم، وكان الله يتدخّل ليخفّف عنه، فيقول له: {فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ}[فاطر: 8]. لذلك لم يقتصّ من وحشيّ قاتل عمّه حمزة، ولا علّق مشنقة لتلك الّتي لاكت كبده. محمّد العطوف الرّؤوف، الّذي تعلّم الرّحمة من ربّه، لم يجاز الذّنب بالذّنب. إنّنا نستغفر لوالدينا، لمن نحبّ، لمن هم أعزّاء على قلوبنا، أمّا أن يطلب الإنسان المغفرة لخصم حاول قتله وشطبه من لائحة الأحياء، فإنّه سموّ ما بعده سموّ، ورحمة ما بعدها رحمة. محمد بن عبدالله كان يتعالى أن تمرّ في ذهنه فكرة الحقد أو الكره أو الانتقام، كان رحمة خالصة أهداها الله للنّاس، وكان(ص) يقول: «اللّهم اهدِ قومي فإنّهم لا يعلمون». ولم يطلب الهداية لهم فحسب، بل سأل الله أن يعذرهم لأنّهم لا يعلمون. وسجّل الرّسول(ص) المنتصر أروع مثل في العفو عند المقدرة، فهو لم يؤلّف محاكم ميدانيّة لمحاكمة من طغا، ولا عذَّب وقهر ولاحق من أساؤوا إليه، فبعد أن حطّم(ص) الأصنام في الكعبة وطهّرها من رجس الأوثان، صلّى بالكعبة، ووقف على بابها وقريش صفوف في المسجد ينتظرونه، فقال لهم: “يا معشر قريش، ما تظنّون أنّي فاعل بكم؟”، فأجابه سهيل بن عمرو قائلاً: “نظنّ خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم”، فأجابه: “اذهبوا فأنتم الطّلقاء”. وأكمل هذا العفو بأن أمر الجيش بأن لا يتعرَّضوا لأحد، وأن لا يريقوا دم إنسان. قيادة الرَّحمة إنّه يوم الانتصار الحقيقيّ، وقد قاد هذا الانتصار والفتح محمد الإنسان قبل محمد القائد. قيادة محمّد(ص) لم تكن قيادة سيف، ولا قيادة تبحث عن كمالها خارج ذاتها وخارج انتمائها إلى الله.. قيادة محمد لم تكن قيادة قتل، ولا كانت نبوّته نبوّة قطع رؤوس وبقر بطون، ولا نبوّة حقد وسفك دماء.. قيادة محمّد لم تكن قيادة شرذمة وتقسيم وسعي إلى المصالح.. قيادة محمد كانت قيادةً همُّها هموم الأمّة، ومصالح الأمّة، والبحث عن أدوية لأمراض الأمّة. أين نحن اليوم مما يحدث في ساحات الأمّة؟ أين المسلمون اليوم من رحمة نبيّهم وعطفه ورقّة قلبه ورأفته:{مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ}[الفتح: 29]… كم يحتاج المسلمون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى إعادة التعرّف إلى نبيّنا من جديد والاقتداء به، لا أن ننتمي إليه شكلاً ونغفل المضمون والمحتوى، لأنّ ما يجري اليوم ينبئك بأنّ المسلمين قد شطحوا وأضاعوا هدف بعث نبيّهم الّذي قال: “إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، والرّحمة هي على رأس الأخلاق. فهلا نكون جديرين بنبيّنا، فنحيا حياة أفضل وننال شفاعته يوم الحساب؟! والله المستعان، والحمد لله ربِّ العالمين. بسم الله الرّحمن الرّحيم الخطبة الثّانية عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله؛ التَّقوى الَّتي جعلها الله هدف الصِّيام عندما قال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة:183]. إنَّ التَّقوى هي المقياس الَّذي نقيس به أنفسنا، لنعرف مدى استفادتنا من هذا الشّهر ومدى تأثيره فينا. والتّقوى تعني أن يكون الله خيارك في الحياة، فتحرص على أن تتواجد حيث يريد الله، وأن تبتعد عن كلّ ما ينهى عنه. وعندما تكون التّقوى هي غاية الصِّيام، نستطيع القول أن لا فائدة من صيام الَّذين لا تزال شهواتهم وغرائزهم وانفعالاتهم وعصبيّاتهم هي الّتي تحرّكهم. ولا فائدة من صيام الأنانيّين الَّذين لا يتحسَّسون آلام الفقراء والأيتام والمعذّبين والمضطهدين، وهمّهم أن يكونوا بخير ولا مشكلة عندهم فيما يعانيه الآخرون. ولا فائدة من صيام الَّذين لا يعيشون المسؤوليَّة عن العباد والبلاد، وحتّى الحيوان. أيّها الأحبّة، إنَّ قيمة هذا الشَّهر بنتائجه علينا، فلا نجعل من صيامنا صيام الَّذين أشار إليهم الحديث: “رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش”. فلنستفد من بقيَّة هذا الشَّهر، حتّى نعوّض تقصيرنا إن قصَّرنا، كما يقول الإمام الصَّادق(ع): “اللّهمّ أدِّ عنّا حقّ ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلّمه منّا مقبولاً، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين”. أيّها الأحبَّة، بالتَّقوى نستطيع أن ندافع عن قضايانا، وقد تعلَّمنا من كلّ تاريخنا، أنَّ الأتقياء وحدهم هم الّذين يدافعون عنها، ولا سيَّما قضيّة القدس، حيث نلتقي في آخر جمعة من شهر رمضان بيوم القدس العالميّ، الَّذي دعا الإمام الخمينيّ إلى إحيائه، لتبقى هذه القضيَّة حاضرةً في النّفوس والعقول، فلا تضيع وتُنسى وتُهمل وتخضع لسياسة التّسويات والأمر الواقع، أو تصبح على هامش القضايا الأخرى. الوحدة تحت راية القدس وفي هذه المرحلة الَّتي يسعى فيها السّاعون إلى إشغالنا بقضايانا الخاصّة، أو إبعاد بوصلتنا عن الاتجاه الصّحيح، لنصبح في مواجهة مع هذا البلد العربيّ أو ذاك البلد الإسلاميّ، أو لنغرق في مهبّ رياح الفتن الطائفيّة والمذهبيّة والخلافات السياسيّة، نحن مدعوّون إلى التزام منطق الوحدة تحت راية القدس؛ قدس المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وقدس الأنبياء ومكان تلاقيهم، حيث تتلاقى الأصوات والسَّواعد والجهود على شعار: “يا قدس إنّنا قادمون، لنزيل عن كاهلك الاحتلال والقهر والإذلال والهوان”. قد يكون هذا الشّعار بالنِّسبة إلى البعض غير واقعيّ وغير منطقيّ، في ظلّ اختلال موازين القوى لمصلحة الكيان الصّهيونيّ، وفي ظلّ كلّ الترهّل الّذي يعانيه العالم العربيّ والإسلاميّ. قد يكون هذا الأمر صحيحاً إذا استسلمنا لواقعنا، ولكنَّ الصّورة ستتغيَّر إذا قرّرنا أن ننفض عنّا غبار الهزيمة، وعملنا على صناعة القوّة المدعومة بحسابات الله وتأييده ونصره. لقد استطعنا في ماضينا القريب أن نقدّم أكثر من نموذج في القدرة على هزيمة هذا العدوّ، من خلال المقاومة في لبنان وفلسطين، وهذه النّماذج قابلة لأن تتكرّر، وتصبح خياراً تتلاقى عليه الشّعوب العربيّة والإسلاميّة، ولا سيَّما تلك المنتفضة على قهرها وإذلالها وإسقاط العنفوان وعناصر القوّة فيها. إنَّ إخلاصنا لقضيّة القدس، لا بدَّ من أن يدفعنا إلى تعزيز كلّ عناصر القوّة وعدم التّفريط فيها، سواء كانت القوّة قوّة جيش أو قوّة مقاومة أو قوّة شعب.. إنَّنا مدعوّون في هذه المرحلة الّتي يُراد فيها أن تسقط الجيوش العربيّة والإسلاميّة، وأن تعبث الفتن بكلّ واقع شعوبنا، وأن يصوّب على منطق المقاومة والمواجهة للعدوّ، أن نكون الواعين، فلا نسقط في فخّ ما يريده الآخرون. رفض المفاوضات ومن هنا، وانطلاقاً من الحرص على القدس وفلسطين، نرفض حصر الاستراتيجيّة الفلسطينيّة بالمفاوضات بين السلطة الفلسطينيّة والكيان الصّهيونيّ برعاية أميركيَّة، لأنّنا لا نرى أيّ جدّية عند هذا الكيان لتقديم أيّ تنازلات للشعب الفلسطيني، بل هو يسعى من خلال هذه المفاوضات إلى تجميل صورته، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال مشروعه الاستيطانيّ. إنَّ هذه المفاوضات تجري في ظلّ انعدام وزن عربيّ وإسلاميّ، وانقسام فلسطينيّ حادّ. ومن هنا، نعيد دعوة السلطة الفلسطينيّة وكلّ الشّعب الفلسطيني، إلى إبقاء رهانهم على توحيد جهودهم، ورصّ صفوفهم، فاللّغة الّتي يفهمها هذا العدوّ، هي لغة الانتفاضة ولغة المقاومة، وهذه اللّغة هي الّتي أخرجت الأسرى من سجونه، وهي الّتي أعادت الأرض، وهي الّتي ستعيدها. العالم العربيّ تحت المعاناة وانطلاقاً من الحرص على القدس وفلسطين، لا بدَّ من العمل الجادّ لوقف هذا النزيف المستمرّ الّذي يغطّي أكثر من ساحة في العالم العربي والإسلامي، حيث لا يزال نزيف الدّم مستمرّاً في العراق، من خلال التّفجيرات الوحشيّة الّتي تطاول الآمنين في شوارعهم ومساجدهم وحسينيّاتهم. ومع الأسف، يتمّ هذا من دون أن تنطلق الأصوات الشّاجبة لهذه الأعمال، أو المبادرات السّاعية للعمل الجادّ لإخراج هذا البلد من محنته. وهذا الأمر هو ما نشهده في سوريا، ولكن بشكل أكثر دمويّةً، حيث لا يزال هذا البلد يعاني هجمةً على دوره وموقعه، في ظلِّ انعدام فرص الحوار، ولا يزال البعض يراهن على الحلّ العسكريّ واستقدام السّلاح والمسلّحين، فيما السَّبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، هو الحوار الجادّ والموضوعيّ بين كلّ الحريصين على هذا البلد ودوره الرّياديّ. والأمر نفسه هو الّذي نخشاه على مصر، حيث يرتفع صوت التّهديد، الّذي قد يؤدّي إلى هدر المزيد من الدّماء، ما بات يستدعي تدخّلاً من كلّ القوى الواعية والفاعلة، لمنع وصول الأمر إلى مرحلةٍ نشهد فيها مجازر تطيح بوحدة هذا البلد وأمنه واستقراره. لبنان: لحلّ القضايا العالقة ونصل إلى لبنان؛ هذا البلد الّذي بات أحوج ما يكون في هذه المرحلة إلى حوار داخليّ تعالج فيه كلّ القضايا بحسّ المسؤوليَّة؛ الحوار الّذي يقي هذا البلد سلبيّات التحدّيات الّتي تواجهه في الدّاخل وفي محيطه، إضافةً إلى خطر العدوّ الصّهيونيّ، ولا سيَّما بعدما دخل على خطِّ هذا البلد العابثون بأمنه، سواء من خلال التّفجيرات أو الصّواريخ الّتي كان آخرها أمس، والّتي لا نرى فيها إلا سعياً لدقّ إسفين الفرقة بين اللّبنانيّين، مستغلّين خطاباً من هنا أو انتقاداً للجيش من هناك، أو ما يجري في المحيط، فيما الهدف هو العبث بأمن اللّبنانيّين، كلّ اللّبنانيّين. ومن هنا، فإنّنا ندعو كلّ المسؤولين للارتفاع إلى مستوى المسؤوليّة، والسعي سريعاً لعلاج كلّ القضايا العالقة، سواء تلك الّتي تتعلّق بتشكيل الحكومة، أو بالحكم، أو القضايا المتعلّقة بالواقع الاقتصاديّ الصّعب. أيّها المسؤولون، كونوا بمستوى الجدّيّة، لأنَّ الواقع القائم يحمل مخاطر كبيرة، هي انعكاس للصّراع الكبير الّذي تعيشه المنطقة، ومن الطَّبيعيّ أن لا يكون لبنان بمنأى عنه، وليكن حرصكم على حفظ كلّ ما يقوّي هذا البلد، من خلال الحرص على هيبة جيشه وقوّة مقاومته ووحدة شعبه. أوّل أياّم العيد وأخيراً، لا بدّ من أن نشير، وبناءً على المبنى الفقهيّ لسماحة السيّد(رض)، إلى أنّ يوم الخميس القادم هو أوّل أيّام عيد الفطر السّعيد، سائلين المولى أن يتقبّل أعمالكم بأحسن القبول، وأن يبلغ بنا إلى رضوانٍ من الله وفوزٍ بالجنّة…
|