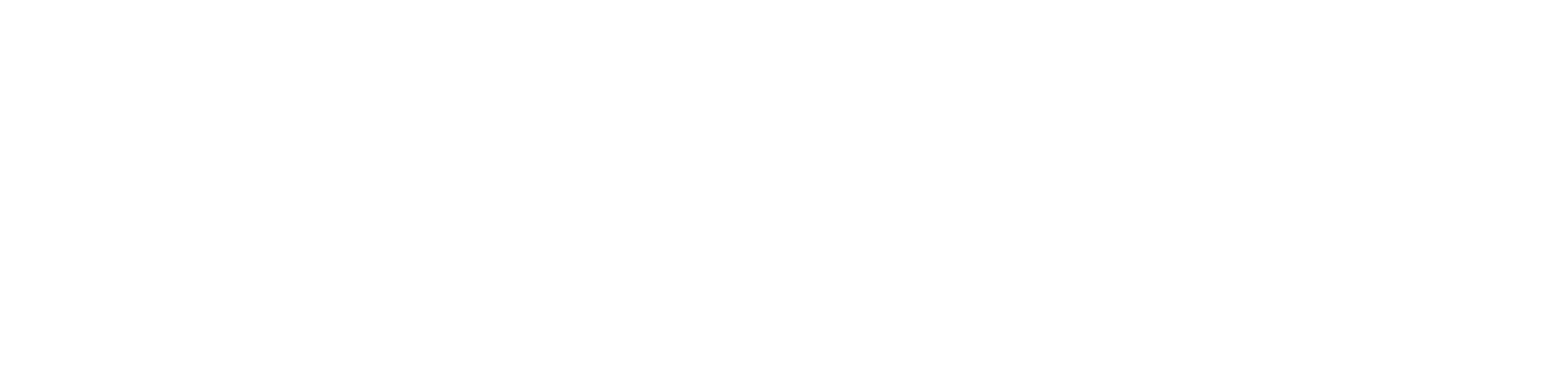حبّ عليّ(ع) معيارٌ للإيمان
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ألقى سماحة العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبتيه:
الخطبة الأولى
لا زلنا في أجواء عيد الغدير، هذا اليوم الّذي مرَّ علينا في الثَّامن عشر من شهر ذي الحجَّة.. وفي هذه المناسبة، أجدِّد التّهئنة والتّبريك لكم ولكلّ المسلمين بحلول هذا العيد الّذي شكّل محطّة أساسيّة وهامّة في المسار الإسلاميّ.
وهنا، وفي إطار الحديث عن هذا اليوم المبارك، لن نستفيض في مجريات هذا الحدث، الّذي حصل بعد عودة رسول الله(ص) من حجّة الوداع وعند غدير خمّ.. فالوقت لن يتّسع، ولكن ما سأقف عنده، هو العلاقة الّتي تربطنا بهذا اليوم، والأهداف الّتي أرادها رسول الله من هذا الاجتماع الاستثنائيّ على مستوى المكان والزّمان..
يوم الغدير، أيّها الأحبّة، هو إعلان الولاية لعليّ، هو تأكيد تولّينا له(ع)، ولنسله من الأئمّة المعصومين الأطهار، وقد حفر في نفوسنا ووجداننا، حبّاً خالصاً، حبّاً نابعاً من القلب والعقل والرّوح، والحديث في حبّ عليّ يطول ويطول..
والحبّ، أيّها الأخوة والأخوات، لا يعرف التعصّب، والحبّ الّذي لا يقوم على معرفة ووعيٍ يكاد يكون تعصّباً، وعليّ(ع) والأئمّة من بعده حاربوا هذا الحبّ المقنّع..
فأن تحبّ عليّاً(ع) بحقّ، فهذا يعني التّوْق إلى الكمال الإنساني في العبوديّة لله، ونصرة الحقّ والعدل، والسّموّ في الخُلُق الحسن، ومكارم الأخلاق…
إنّ رجلاً كعليّ(ع) كان يُمثّل تحدّياً لكلّ إنسان عايشه وعاصره، فإمّا أن تقتفي دربه وتحذو حذوه لتقترب من نموذجه، أو أن تكون نقيضه، لهذا يقول الفخر الرّازي فيه: "من اتخذ عليّاً إماماً لدينه، فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه".
والحديث عن الإمام عليّ(ع) "محنة للمتكلّم"، كما يقول الجاحظ، "فإن وَفَى حقّه غلا، وإن بخسه حقّه أساء".
أن تحبّ عليّاً بإخلاص، فهذا يعني أن تعرف عليّاً الإمام، وعليّاً الإنسان، وعليّاً الحاكم، وعليّاً الأب والزّوج والجار والمجاهد والزّاهد والعالم، وتطول اللائحة…
عليّ(ع) ما زال يلهمنا كلّ يوم، كلّ ساعة، عند كلّ صلاة، وعند كلّ مهمة، ويلهمنا في كلّ موقف للبطولة والعزّة والمسؤوليّة، ما دمنا نعرف كيف نقرأ التّاريخ ونتتبّع مسيرته مع رسول الله(ص)، وبعد رسول الله(ص).
وكيف لا نحبّ عليّاً، وقد رسم لنا في كلّ خطوة سبل ارتقاء الإنسان بإنسانيَّته إلى قمّة الكمال، عملاً بقول رسول الله(ص): "إنَّما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"؟!
كيف لا نحبّه، وهو القويّ القادر الشّجاع، الذي لم تحوّله قوّته ليكون جبّاراً أو طاغوتاً، وهو الذي كان ينهى أصحابه عن السبّ والشّتم، حتى لو كان المعني خصماً وعدوّاً، ويقول: "أكره لكم أن تكونوا سبّابين".
عليّ كان لا يعرف الحقد، كان يقول لأصحابه: "إذا قدرت على عدوّك، فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه".
أيّها الأحبّة: من يتجوّلْ في سيرة عليّ ويقلّب أوراقها، سرعان ما يكتشف أنّه كان من أكرم النّاس وأزهد النّاس؛ عاش مع الفقراء لكنّه حارب الفقر، وهو القائل: "لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته"، وعاش مع المحرومين لكنّه حارب الحرمان… عاش مع الجهّال وحارب الجهل بحلمه وعلمه، وقال لهم: "سلوني قبل أن تفقدوني". كان الحاكم الّذي جاع مع شعبه، إذ رفض أن يميّز نفسه، أو أن يعيش بمستوى أعلى من أفقر فقير، وشعاره: " لو شئت لاهتديت الطّريق إلى مُصفّى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة، ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشّبع"، "أأقنع من نفسي بأن يُقال هذا أمير المؤمنين، ولا أُشاركهم في مكاره الدّهر، أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش؟".
هذا الإمام العظيم عاش عظمته ليكون قدوةً وأسوة ونبراس هداية، مقتفياً بذلك خطوات الرّسول(ص). لذلك لا يمكن لك أن تحبّ عليّاً وترضى بظلم أو ذلّ، ولا معنى لحبّ عليّ وأنت تناصر منحرفاً أو فاسداً، ولا يمكن لك أن تحبّ عليّاً وتفكّر أن تسلب نملةً ولو جلب شعيرة، فكيف إن واليت عليّاً وأحببته، ثم كنت وبالاً ونقمةً على من حولك في التعدّيات والاستفزاز والاستقواء؟ ما رأي عليّ في هذا؟
عليّ كان يربّي أصحابه على أنّهم أصحاب الحقّ والعدل والحبّ والرّحمة، وأصحاب الأهداف الكبيرة، كان يُربّيهم لا ليكونوا أزلام عليّ وأنصاره، وأصحاب زعامته وشخصه، بل أصحاب الرّسالة ومبادئ الرّسالة. والفرق كبير كبير بين قائد لا يعبأ بالزّعامة، وبين زعيم لا يعبأ بالقيادة.. وهكذا كان عليّ.
لقد شكّل عليّ الحاكم استفزازاً للكثيرين، لأنّه رفض أن يمارس السياسة لعباً على الحبال، وتحايلاً ومكائد وشطارة، أُبعد عن الخلافة، فأصرّ أن تكون معارضته في إطارها الرّساليّ، وفي خدمة الإسلام، لذلك رفض النّصر بالجور، والحكم بالخديعة، والاستقواء بفاسد أو فاجر أو تاجر فرص، كأبي سفيان يوم السّقيفة، عندما جاءه محرّضاً على استعمال القوّة لاسترداد حقّه في خلافة رسول الله، فزجره عليّ(ع)، لأنه عرف مراده، وسالم لتسلم أمور المسلمين.
أيّها الأحبّة: إنّنا نحبّ عليّاً لأنّ الله تعالى أحبّه وأكرمه، ولأنّ الرّسول(ص) أحبّه.
لقد كتب الله تعالى لعليّ كرامة لم ينلها أحد من النّاس، فقد وُلد في بيت الله، في الكعبة، ونشأ في دار الوحي وفي أحضان الرّسول(ص)، عاش في كنفه، يشمّ عبق النبوّة، ويعيش لحظات نزول الوحي، يصلّي أوّل صلاة خلف الرّسول(ص)، وتتكامل فيه ملامح الوصيّ والربيب والأخ، وفيه نزلت آية المباهلة : {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}. ويتّفق المفسّرون على أنّ الآية نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين(ع)، ونحو ستّين من كبار أهل السنّة قالوا إنّ كلمة (أنفسنا) إشارة إلى عليّ، و(نساءنا) إشارة إلى فاطمة، و(أبناءنا) إشارة إلى الحسن والحسين(ع)، وهذا فضل لا يلحقهم فيه بشر، وشرف لا يسبقهم إليه خلق.
وفي عليّ(ع) نزلت: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}. وقصّتها أنّه تصدّق وهو راكع بخاتمه لسائل دخل المسجد، وهذا بشهادة أربعة وعشرين حديثاً عن طرق السُنّة، وتسعة عشر حديثاً عن طرق الشّيعة، وقد أرَّخ حسان بن ثابت ـ شاعر الرّسول ـ هذا الحديث في إحدى قصائده، إذ يقول:
فأنت الّذي أعطيتَ إذْ كنتَ راكع زكاةً فَدَتْكَ النّفس يا خيرَ راكعِ
فأنزل فيك اللهُ خيرَ ولاية وبيّنها في مُحْكمات الشّرائعِ.
وكيف لا نحبّ رجلاً لم ينسَ تاريخ الرّسالة توهّجات سيفه يوم بدر، وحمايته للرسول(ص) يوم أُحد، بعد أن فرّ من فرّ، وهرب من هرب.
وتاريخ الرّسالة لا ينسى يوم الأحزاب، حين اجتاز عمرو بن ودّ الخندق، وراح يتحدّى المسلمين، فجبن من جبن، وصمت من صمت، وخنس من خنس. وحده عليّ امتشق سيفه وقال للرّسول: أنا له يا رسول الله!
ونحن هنا لا نعشقه لأنّه شجاع ومقدام فحسب، بل لأنّه كان يُمثّل في تلك اللّحظة، كما قال الرّسول(ص): "برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه".
ويوم خيبر، يقدّم الرّسول(ص) شهادة أخرى في عليّ، يومَها عجز من عجز عن الوصول إلى حصن النّفاق والفتنة، وأخيراً يقرِّر الرّسول أمراً، ويقول: "والله لأعطينّ الرّاية غداً رجلاً يحبُّ اللهَ ورسولَه، ويُحبُّهُ اللهُ ورسولُه، كرّار غير فرار". وتتطاول الأعناق، ويرجو كلّ واحد أن يكون هو صاحب الرّاية، لكنّ الرّسول يستدعي عليّاً، وحين يسلّمه الرّاية، يدعو الله تعالى: "اللّهمّ إنّك تعلم أنّه خير أهلي وأرومتي، فاردده عليّ سالماً".
حبّ عليّ، أيّها الأحبّة، كان حتّى في زمن الرّسول(ص) معياراً لإيمان الرّجل، والرّسول نفسه كان يخاطب عليّاً: "يا عليّ، لا يبغضك مؤمن، ولا يحبّك منافق".
وفي حديث عن أبي ذرّ قال: "ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ بتكذيبهم الله ورسوله، والتخلّف عن الصّلوات، والبغض لعليّ بن أبي طالب".
هذا القليل ممّا كانه عليّ(ع)، الّذي كان كنزاً من العزّة والإباء، والتّضحية، والتّواضع، والزّهد، والاستقامة، والشّجاعة، والحكمة، والبلاغة، والكرم والسّخاء، و…
فإنّ كنّا اليوم نرضع حبّه مع الحليب، فليس هو حبّ عابد لوثنه، ولا حبّ متعصّب لزعيم، بل هو حبّ العشق، وحبّ العارف بقدر حبيبه. عليّ(ع) كان قمّة وقامة عالية، ولأنّه يعرف نفسه، ويعرف قدره ودوره وتكليفه، فقد دعانا أن نحبّه حبّ العارف لدليله، لذلك قال: "هلك فيّ اثنان؛ محبٌّ غال، ومُبغضٌ قالٍ".
جعلنا الله من المحبّين العارفين، والمقتدين لا المغالين أو المسيئين، وجعلنا من الموالين العاملين لا القاعدين، وكلّ عام وأنتم بخير في ذكرى الغدير..
والسّلام على عليّ في الكعبة وليداً، ويوم الغدير أميراً، وفي المحراب شهيداً، ويوم يبعث حيّاً.
والحمد لله ربّ العالمين.
الخطبة الثّانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ومن التّقوى أن نستهدي بأمير المؤمنين وإمام المتّقين علي بن أبي طالب(ع)، فالسّيرة تحدّثنا أنَّ امرأةً تدعى سودة بنت عمارة الهمدانيّة، دخلت على معاوية بعد شهادة عليّ(ع)، فجعل يؤنّبها على تحريضها عليه أيّام صفّين، ثم قال لها: "ما حاجتك؟"، قالت: "إنّ الله سائلك عن أمرنا، وما افترض عليك من حقّنا، ولا يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمكانك، ويبطش بقوّة سلطانك، فيحصدنا حصيد السّنبل؛ هذا بشر بن أرطأة قدم علينا، فقتل رجالنا، وأخذ أموالنا، ولولا الطّاعة لكان فينا عزّ ومنعة، فإن عزلته عنّا شكرناك، وإلا كفّرناك". فقال: "إيّاي تهدّدين بقومك يا سودة؟!".
فأطرقت سودة ثم قالت:
صلّى الإله على روح تضمّنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا
حالف الحقّ لا يبغي به بدل فصار بالحقّ والإيمان مقرونا
فقال معاوية: "تقصدين بذلك عليّاً، ألا زلت على ولايته؟"، قالت: "نعم والله، لقد جئته في رجلٍ كان قد ولاّه صدقاتنا فجار علينا، فصادفته قائماً يصلّي، فلمّا رآني، انفتل من صلاته، ثم أقبل عليّ برحمة ورفق ورأفة وتعطّف، وقال لي: ألك حاجة؟ قلت: نعم، وأخبرته الخبر، فبكى، ثم توجَّه إلى ربّه قائلاً: اللّهمّ أنت الشّاهد عليَّ وعليهم، وإنّي لم آمرهم بظلم خلقك. ثم قام عليّ وأخرج قطعة جلد، فكتب فيها: "بسم الله الرّحمن الرّحيم: {قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، فإذا قرأت كتابي هذا، فاحتفظ بما في يديك من عملنا، حتّى يقدم عليك من يقبضه منك، والسَّلام".
ثم دفع الرّقعة إليّ، فجئت بها إلى صاحبها، فانصرف عنَّا معزولاً".
هذا هو عليّ(ع) في عدله ووقوفه مع المظلومين، ونحن علينا أن نلتزم عليّاً، ونلتزم الخطّ الّذي آمن به، وعمل له، وتحمّل كلّ ما تحمّل من أجل صونه، لنكون قوّةً للمظلومين ضدّ الظّالمين، ولنسعى مع المظلوم ضدّ الظّالم، أيّاً كان المظلوم وأيّاً كان الظّالم.
مجلس الأمن: انحياز للعدوّ
ومع انشغال العالم العربي والإسلامي بأزماته، يستمرّ العدوّ الصّهيونيّ بمخطّطه الاستيطاني، للإطباق على القدس والمسجد الأقصى، ويتابع الضّغط على الفلسطينيّين في أرزاقهم وأرواحهم وكلّ أوضاعهم، لدفعهم إلى تقديم المزيد من التّنازلات لحساب الكيان الصّهيوني.
وإذا كان البعض يشعر بالامتعاض من عدم أداء مجلس الأمن دوره، نتيجة تضارب المصالح بين دوله، فإنّ ما يحصل في فلسطين، يبقى الدَّافع الرّئيس للامتعاض من هذا المجلس، الّذي لا يمارس دوره كما يجب، فهو كان ولا يزال يرعى استمرار وجود الكيان الصّهيونيّ اللاشرعيّ في فلسطين، ويتعامى عن أعماله العدوانيّة، ولا يتعامل معها بمسؤوليّة وجدّيّة كما يتعامل مع القضايا الأخرى، فتبقى قرارات إدانة هذا الكيان حبراً على ورق، وغير قابلة للتّنفيذ، لا عاجلاً ولا آجلاً، فيما تُجيَّش الجيوش وتسيّر الأساطيل في مواجهة دول أخرى، لكونها تشكّل أزمة للكيان الصّهيوني.
ولذلك، نحن مع كلّ دعوة لتصويب مسار مجلس الأمن، ليكون في خدمة السَّلام العالمي، بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين، أو تصنيف النَّاس على أساس ابن الستّ وابن الجارية، كما أنّنا نقدّر أيّ موقف يدعو إلى تصويب مسار هيئة الأمم المتّحدة، الّتي ينبغي أن تكون سنداً لكلّ المظلومين، لا أن تكون قوّة للظّالمين وطواغيت العالم.
العالم العربيّ أسير الفوضى
وإلى مصر، حيث لا نزال نعيش الخوف على هذا البلد، بسبب ما يجري على أرضه من أعمال عنف وعمليّات تفجيريّة، وليس آخرها الاعتداء الآثم على كنيسة الورّاق، الّذي أدّى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، ما قد يساهم في إدخال مصر في صراع طائفيّ، إلى جانب الصّراع السياسيّ الدّائر، الأمر الّذي يجعل هذا البلد أسير عدم الاستقرار.
إنَّنا نرى أنَّ المستفيد الأكبر من كلّ ما يحصل في مصر هو العدوّ الصّهيوني، وهذا ينبغي أن يفهمه الجميع، وأن يكون دافعاً لهم للعمل على تهيئة مناخات الوفاق، والتَّحضير لحوار داخليّ يجمع كلّ مكوّنات الشّعب المصريّ، للمحافظة على موقع مصر ودورها، والحؤول دون إغراقها في الفوضى الّتي يراد لها أن تعمّ المنطقة بكاملها.
ونصل إلى العراق، الّذي تستمرّ معاناة شعبه بسبب التَّفجيرات الوحشيّة اليوميّة، والّتي باتت تمثّل المشهد اليوميّ الرّوتينيّ فيه، ما بات يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الوحدة الداخليَّة، والعمل لمحاصرة هذا الوضع أمنيّاً وسياسيّاً، قبل أن يتفاقم ويحصد المزيد من الضَّحايا الأبرياء.
أمّا سوريا، فهي لا تزال تشكّل محور الحركة السياسيَّة والأمنيَّة في هذه الأيَّام، حيث تطوف داخلها وحولها الرّسائل الأمنيَّة والسياسيَّة على السّواء، ونحن لا نزال نرى أنَّ الحلَّ السياسيّ والحوار هما أقرب الطّرق لاختصار الأزمة الرّاهنة، بعدما بات واضحاً عدم إمكان الحسم العسكري لمصلحة هذا الفريق أو ذاك.
ومن هنا، فإنّنا ندعو الجميع مجدّداً إلى اقتناص أيّة فرصة حوار والانطلاق بها، لكي لا يستمرّ نزف الدّم والدّمار، انطلاقاً من قاعدة: "لأسلمنّ ما سلمت أمور شعب هذا البلد ومستقبله، ولو كان الجور فيه على فئة هنا أو هناك"، وإن كنّا نعتقد أنَّ المحاور الدّوليّة تعمل على استنزاف الجميع، قبل أن تدفع الحلّ السياسيّ إلى الأمام.
أمّا البحرين، فإنّنا في الوقت الّذي ننظر بإيجابيّة إلى إطلاق سراح النّاشط خليل المرزوق، نعيد التّشديد على السّلطة الّتي يبدي المسؤولون فيها رغبتهم في الحوار، بأن تسعى لتأمين سبل الوصول إليه بجدّية، وأن لا تكتفي بالتّصريحات الشكليّة والمواقف الاستعراضيّة، فالحوار هو السّبيل الأمثل لإخراج هذا البلد من معاناته، لأنَّ العنف لا ينتج إلا العنف.
لبنان: الأمن النّازف
أمَّا لبنان، فإنَّ بعض السياسيّين فيه لا يزالون ينتظرون حسم الصِّراع في الخارج، ولا سيَّما في سوريا، ما يعطّل تشكيل الحكومة، ويوقف حركة التَّشريع، ويجمِّد العجلة الاقتصاديَّة، ويفاقم الأزمات الكثيرة الّتي يعانيها البلد…
وفي هذا الوقت، يبقى النزيف الأمنيّ مستمرّاً من خلال ما يجري في طرابلس، حيث يستمرّ مسلسل العبث الأمني والقتل المجاني الّذي يطاول هذه المدينة، الّتي أصبحت أسيرة مسؤولي المحاور فيها، ويستمرّ الحديث عن دخول السيّارات المفخّخة إلى لبنان، كما تزداد وتيرة الحوادث الأمنيّة المتنقّلة وعمليّات الخطف، ما بات يشكّل هاجساً لكلّ اللّبنانيّين، ومصدر قلق دائم لهم.
إنَّ كلّ هذا الواقع، ينبغي أن يكون دافعاً للمسؤولين للخروج من حساباتهم الضيّقة، والتّفكير في الوطن والمواطن، وإذا كان البعض يراهن على الخارج، فإنّ عليه أن يعيد النّظر في حساباته، لأنّ هذا الخارج سيعمل لإطالة أمد الأزمة، والحلول الّتي سيطرحها ربما لن تكون لحساب اللّبنانيّين.
ونحن نرى في عودة المحرّرين الّذين اختطفوا في سوريا إلى أهلهم، محطّة من محطّات الوفاق الدّاخليّ الّتي يمكن البناء عليها، بعدما تحرّك مختلف الأطراف لحلّ هذه المشكلة واستقبال العائدين، في عرسٍ وطنيّ نريد له أن يكتمل بعمليّة سياسيّة وفاقيّة وطنيّة شاملة، تعيد الرّوح إلى البلد والمؤسّسات كلّها.
ونحن في هذه المناسبة، ندعو إلى استمرار العمل، وعلى المستويات كافّةً، لإطلاق المطرانين المختطفين وكلّ المخطوفين، لتكتمل الفرحة، ويعود الجميع إلى أهلهم ووطنهم، ويساهموا في إعمار بلدهم.