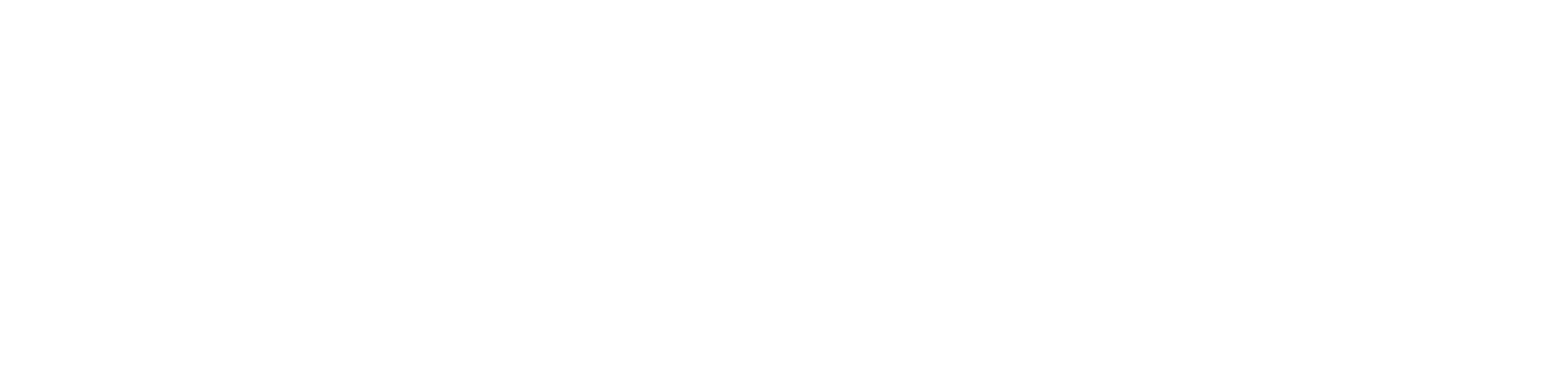كلمة بمناسبة أسبوع جمعيّة المبرات الخيرية
حين نتحدَّث عن جمعية المبرات الخيرية، فإننا نستحضر كلّ القيم الكبيرة الَّتي ترفع من إنسانيَّة الإنسان والمجتمع، ونستحضر ذلك الهم الكبير الذي سكن قلب المرجع المؤسس(قده) وعقله، في تأهيل الجمعيَّة، لتكون المؤسَّسة الَّتي لا يتعلّق وجودها بفرد، مهما علت مكانته وبلغ شأنه.
وقد جاء هذا التوجّه ليربط القول بالفعل، والنَّظرية بالممارسة، على خلفيَّة مشروع انطلق ليكون حرباً على كلّ ألوان الأنانية والفردية والتعصّب والانغلاق، وتطلّع ليؤسّس نموذجاً على قواعد العلم والعطاء والحب والانفتاح والإيثار، في رهان مصيريّ على كلّ ما هو خير في وجدان الإنسان، لنعمل على استخراجه، ثم تعميمه في كلّ الاتجاهات، وبالتكامل مع كلّ الجمعيات والتيارات.
لقد كان هدفنا وسيبقى أن نكوّن المجتمع الَّذي يمارس مسؤولياته بحرية ذاتية، وبفرح روحي، ليسدّ الثغرات هنا، ويلبي الحاجات هناك، في سعي دؤوب ومتواصل للتخفيف من تداعيات مآسي اليتم، والفقر، والإعاقة، والجهل، والحقد، والانقسام، والتعصّب… وقد خضنا هذه العملية الإصلاحية، فكراً وعملاً، ومن دون أن نتّخذ من هذه المآسي مادة دسمة لكيل الاتهامات لهذه الحكومة المتقاعسة أو تلك، أو لهذا العقل العربي أو الديني القاصر، أو ما يسمى بالبنى الاجتماعية المتخلفة، أو لثقل التاريخ وأعبائه، كما يفعل الكثير منا، حين يستعيضون عن العمل بإلقاء اللوم على كلّ ذلك، وكأنَّهم بذلك أدّوا قسطهم، وعملوا ما عليهم، علّ ذلك يكون لهم براءة أمام الله والناس والتاريخ.
أيها الأحبَّة، لم نفهم الإسلام إلا دين انفتاح وتواصل؛ دين حبّ وتسامح، دين عطاء وإيثار، دين حريّة وتحرّر، دين شورى وشراكة، دين علم وعمل، وقد تحركنا في كلّ ما نحمله من رؤى وأفكار وأعمال، من وحي هذا الفهم الإنساني للدين، ولم يكن هذا المسار سهلاً، ولعلّنا واجهنا، وكما يعلم الكثيرون منكم، صعاباً وعقبات قد تنوء بها مؤسَّسات عالميّة، لكنّنا واصلنا المسيرة بالرسالة المنفتحة، والكلمة الأمينة، والعقل الحر، نحمل مبادئ الحوار للتلاقي، والاعتدال قاعدة للاستقرار، والدين جسراً للتواصل والتسامح، والعلم حرباً على الجهل، والرحمة بديلاً عن العصبيَّة، والمواطنة مدخلاً للتفاعل والوحدة، والحرية منطلقاً للإبداع، والتحرر حفظاً للوجود والكرامة، والاستقلالية رفضاً للتبعية، والعطاء اختباراً لإنسانيتنا… ولقد أدرجنا كلّ ذلك في مسيرتنا، تحت عنوان الانفتاح على الخير؛ الخير الإنساني المشترك.
هذا ولم يحدّ من هذا التوجّه الإنساني خصوصيّة انطلقنا منها ولا نتنكّر لها، وظروف موضوعية تضعف قدرتنا على العبور إلى كل المذاهب وتجاوز حدود الطوائف، بل بقي تطلّعنا إلى أن نتفاعل مع الجميع، وفي كل القضايا، وأن نعمل سوياً مع من يشبهنا ونشبهه في مواجهة كل التحديات، ومع من لا يشبهنا أو لا نشبهه، على قواسم مشتركة نلتقي عليها، ولم نعرف أنفسنا إلا متواصلين ومنفتحين.. تجمعنا الإنسانيَّة والإنسان.
ولقد علَّمتنا الحياة والتجربة الكبيرة للمرجع المؤسس، أنَّ في هذا التواصل والتفاعل غنى لعقولنا ولإنسانيتنا، ففيه نستفيد من تجارب بعضنا البعض، ونتكامل في أعمالنا، لنكون معاً في خدمة عباد الله؛ كل عباد الله، إلى أي فئة انتموا، وفي أي منطقة كانوا.
أيها الأحبة:
هذه هي منطلقاتنا وأهدافنا، نعمل على صونها بشغاف القلوب وحدقات العيون.. وكما تعلمون، فإنَّ النوايا الصادقة وحدها لا تكفي لاستمرار المسيرة.. قالها رسول الله(ص): "اعقل وتوكل".. وعلى هذا الأساس، تابعنا مسيرة المأسسة؛ ولو كنا في عالم شرقي يراهن على الفرد كمنقذ للأمة والتاريخ، على أنَّنا ومهما كان إيماننا بدور الفرد المتميز في التاريخ، فإن استمرارية أي جمعية، أو أي عمل، أو أي إطار، رهن في ترسخ قواعد العمل المؤسَّسي فيه، بحيث يمتلك فيه العاملون ذهنية النظام والمؤسَّسة، لا ذهنية الأفراد والشللية، رغم إيماننا الكبير بمواهب الفرد، والفرد القدوة، ولكن تبقى القيمة والفاعلية والاستمرار للنظام وليس للأفراد، ولتداول السلطة لا لجمودها.
أيها الأحبة:
لقد اعتدنا في هذا الشَّرق أن يبدأ صاحب المسؤوليَّة من الصفر، أي من دون أن يراكم جهود من سبقه، أو يستثمر خبراته وتجربته، أو يستفيد من إنجازاته، ويعتبر من إخفاقاته. وهل من خلف أثنى على سلف، أو أكمل من حيث انتهى؟ لذا، ومن أصغر موقع إلى أكبر موقع، كانت تتبدّل الوجوه، ويمر الزمن، ونبقى في المكان نفسه. ومن هنا، فليس صعباً الإجابة عن سؤال: لماذا نحن متخلّفون؟ وفي ضوء ذلك، هل من بديل أمامنا إلا المأسسة؟
ومع المأسسة نتحدَّث عن التطوير. وعندما نتحدَّث عن التّطوير، فإنّنا نلامس أفق المستقبل، فالتطوير ضرورة، لئلا نصبح من الماضي، ونجمد في حدوده، وفي الجمود موت، فيما التطوير حياة وتقدم، والتطوير يبدأ من الإنسان قبل أن يبدأ من أي شيء آخر.
وأن نعمل على تطوير الإنسان، هو أن نعمل على تجديد العقل والقلب والروح، أن نعيش الهاجس الرسالي، أن نحرص على بقاء الوجدان صالحاً ليتحسَّس آلام المجتمع، فلا نتحوّل إلى كائنات باردة إنسانياً، أن نحرص على بقاء جهازنا الإدراكي حساساً، لمعرفة حاجات الواقع وتلمّس الحلول، أن نحرص لتبقى أرواحنا تعيش الأمل والطمأنينة والتوكل الحقيقي على الله، لبناء مستقبل مشرق؛ مستقبل نصنعه بالتخطيط العلمي، بعد أن استهلكتنا الانفعالية والتلقائية، وبالتحصيل الدائم للمعرفة، واستثمار الجديد العلمي في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية، فليس للمعرفة حدود حضاريَّة أو زمنيَّة: "اطلبوا العلم ولو في الصين"، و"اطلب العلم من المهد إلى اللحد".
نعم، لا بدَّ من فحص ما نتلقّاه من معارف في كلّ الميادين التي نحتاجها، فلا معرفة معصومة من الخطأ، ونقاط الضعف. لذا، لا بدَّ من أن نأخذ منها ما يزيدنا قوة وعلماً، على أن يبقى ما نأخذه مدار اختبار وتقييم، فلعلَّ التجربة تثبت عكس ما نتبنّاه. وعلى هذا الأساس، لا بدَّ من أن نمتلك جرأة النقد الذاتي والمراجعة المستمرة، ومن ثم القدرة على تحويل هذه المعارف إلى برامج وسياسات وأنظمة.
إننا نريد لهذه المؤسَّسة، كما لكلِّ المؤسَّسات الاجتماعيَّة الَّتي ينظر إليها المجتمع بأمل، بعد أن فقد ثقته بالدولة ومؤسَّساتها، أن تنتج لمجتمعاتنا إنساناً جديداً في الفكر والممارسة والتطلعات، وفي تحمّل المسؤوليَّة وإدارة الذّات، لنكون لائقين في ممارسة أدوارنا التربويَّة والتعليميَّة والاجتماعيَّة والإنسانيَّة والروحيَّة والأخلاقيَّة في خدمة الإنسان، وفي تقليص مساحات الاستضعاف، وفي تنمية ساحات القوة. وتلك مهمّة جليلة ومسؤولية كبيرة، فهل نكون على قدر هذه المهمة وهذه المسؤولية!؟
ما فعلته المبرات من رصيد إنساني وأخلاقي وعمراني وخدماتي وتربوي كبير، هو ثمرة تجربتها وتجارب الآخرين، وسنؤسّس عليه.. ورهاننا على إنتاج جيل جديد رسالي واعٍ منفتح، نستكمل به هذه المسيرة، الَّتي وإن كانت شاقة للجسد ومتعبة للعقل، فإنَّ فيها من فرح الروح ما قد تهون أمامه كلّ الصّعاب والمشاق.
إنَّ ما نلتقي عليه هو بعض من جهد حرصت عليه المبرات، ونريده أن يساهم في تعزيز تجربة رائدة لن نكون فيها وحدنا، بل نريده أن يتلاقى مع تجارب الآخرين، ونتكامل فيه مع كلّ المؤسَّسات العاملة في خدمة الإنسان والحياة، بعيداً عن كلّ الاعتبارات الطائفيّة والمذهبيّة والسياسيّة، الَّتي باتت تمزّق واقعنا، وتهدّد مستقبلنا جميعاً.