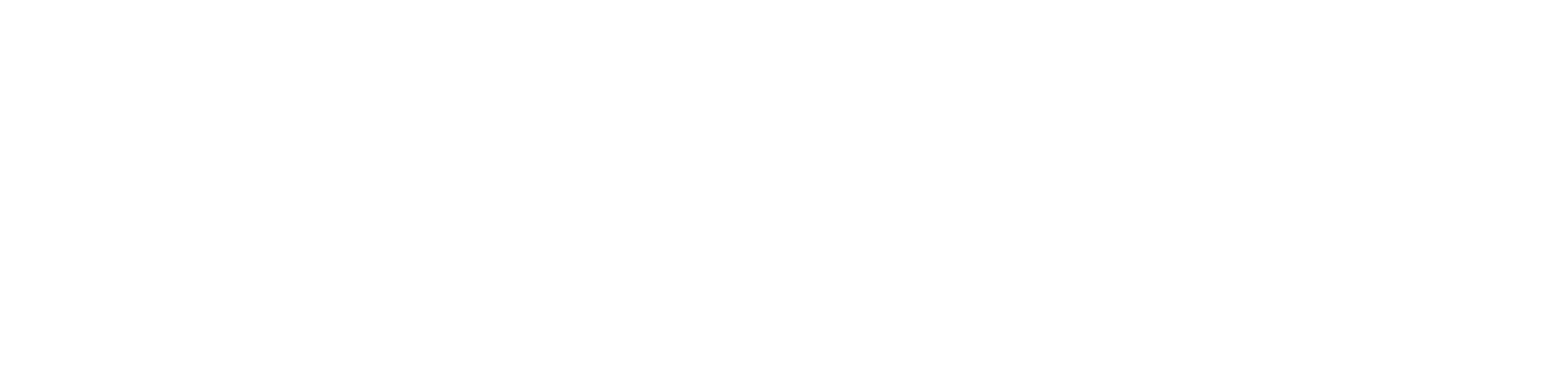الأمن الغذائي في الاسلام
ألقى سماحة العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبتيه:
{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
عندما دعا النبي ابراهيم(ع) ربه بهذا الدعاء، أشار إلى وجود علاقة سببية بين الاخلاص في العبادة والرزق بما له علاقة بالطعام {وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}.
والمتأمل في الرسالات السماوية يرى أنه لا تكتمل دعوة دينية أو إصلاحية أو أي ثورة تغييرية من دون أن تولي الجهد الأكبر من تنظيرها عندما تنظّر واهتمامها إلى الحاجات الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الأمن الغذائي، أن لا يجوع إنسان. وذلك قبل أن تنتقل إلى تحقيق أهدافها، لإدراكهم أن الجوع والفقر هما الباب الذي ينفذ منه الفساد والانحراف، وهو السبب لكثير من الثورات التي قد تتحول إلى فتن ودماء. لذا ذمّوا الفقر، وحاربوه، وسعوا لعلاجه ،وقد ورد عن رسول الله(ص): «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا»، وفي هذا اشارة واضحة الى ان مشروع النبي هو محاربة الفقر كما هو محاربة الكفر. وفي هذا توصيف دقيق ومنصف لأهداف الرسالة التي جاء بها رسول الله(ص) ومعه كل الأنبياء: إزالة الكفر العقيدي من جهة والكفر بكرامة الانسان وحاجاته من جهة اخرى. وواصل الامام علي(ع) هذا النهج فنظر لمحاربة الفقر وقال: «لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلتهُ» وهناك قول لابي ذر الغفاري صوت الفقراء الهادر واللاذع بوجه الحكام المتخمين ممن يأن حولهم الفقراء من الجوع: «عجبت لمن لا يجد قوته في بيته كيف لا يخرج شاهراً سيفه على الناس» ان كل هذا الذم للفقر يقابله عند أهل البيت(ع) حب للفقراء وعطف عليهم والدعوة لصحبتهم. كما هو دعاء الإمام زين العابدين(ع):"اللهم حبب إلي صحبة الفقراء".
أيها الاحبة
إن عظمة أهل البيت(ع) تتمثل في كونهم لم يورثوا وعظاً وتنظيراً لمن حولهم ولنا، بل كانوا التجسيد العملي كما النظري للإسلام بكل جوانبه، فلم يطغ لديهم جانب على جانب، هم صورته الناطقة، جسدوه عبادة وزهدا وتسامحا واستشهادا وكرماً وعطاء..
والإمام علي بن الحسين عليهما السلام، الذي نستعيد في هذه الأيام ذكرى وفاته في الخامس والعشرين من شهر محرم، كان من أبرز من جسد الاسلام في مختلف جوانبه، فمع كونه عرف بالسجاد وزين العابدين وذي الثفنات، مما قد يوحي أن العبادة كانت جل اهتمامه ولكن سيرته(ع) تنقل مظاهر أخرى، فقد كانت شخصيته ذات بعد ثوري وفكري واجتماعي كرسالة الحقوق التي تعد من أهم وثائق حقوق الإنسان، ويستفيد منها الآخرون ولا نستفيد منها نحن. ومن القابه التي لا يتم تداولها بشكل كافٍ هي أنه عرف بصاحب الجراب.
حيث تذكر سيرة هذا الإمام وهو ابن بنت رسول الله ومن كان له شأن وموقع في قلوب الناس ودائماً يذكر قصة عنه عندما جاء هشام هشام بن عبد الملك للحج برفقة حاشيته وقد كان معهم الشاعر الفرزدق وكان البيت الحرام مكتظاً بالحجيج في تلك السنه ولم يفسح له المجال للطواف فجلب له متكأ ينتظر دوره وعندما قدم الإمام علي ابن الحسين زين العابدين (ع) انشقت له صفوف الناس حتى أدرك الحجر الأسود فلم يتمالك الشاعر الفرزدق من كتم تبجيله واحترامه العميقين للإمام السجاد (ع) فقام مرتجلاً أ قصيدته المشهورة متحدياً قائلاً:
يا سائلي أيـــن حل الجود والكرم عــنـــدي بـــــيان إذا طــــلابه قدموا
هذا الذي تعـــرف البطحاء وطأته والبــيت يعــرفه والحــل والحـــــرم
هــذا ابــن خــــير عــباد الله كلهم هــــذا التــــقي النــقي الطاهر العلم
فإذا جنّ الليل، وهدأت العيون قام إلى منزله، فجمع من قوت أهله، وجعله في جرابٍ ورمى به على عاتقه، ثم خرج إلى دور الفقراء وهو متلثّم، ويفرّق عليهم، وكثيرا ما كانوا قياماً على أبوابهم ينتظرونه، فإذا رأوه تباشروا به، وقالوا: جاء صاحب الجراب.
وما كان يقوم به الإمام لم يكن جهداً فردياً أو طارئاً بقدر ما كان له بعدٌ فلسفيٌّ اسلاميْ، ومعادلة واضحة في حركة الإنسان المسلم وبناء شخصيته الإيمانية ، حيث أن عملية الاحساس بجوع الفقراء وتأمين أمنهم الغذائي مدخلٌ الى الجنة وبلوغ رضوان الله والعكس هو صحيح:
فقد اعتبره القرآن الكريم مدخلاً للإنسان ليكون من الأبرار وهو وصف لأهل البيت(ع): {إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبّه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}
ومن جهة أخرى صور القرآن أولئك الذين لا يلتفتون إلى الفقراء والمساكين: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ*إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ*فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ*عَنِ الْمُجْرِمِينَ*مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ*قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ*وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}. حتى أن الله ندد بأولئك الذين يتهربون من هذه المسؤولية ويلقونها على الله فقال عنهم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}.
ومن جهة الاحكام كان موضوع الاطعام محوريا واللافت الذي يقتضي التأمل هو الارتباط العضوي بين الإطعام والعبادات وهذا من شأنه ان يضمن الاطعام أكثر .. كيف؟
خذوا مثلا ارتباط فريضة الصيام بالاحساس بجوع الفقراء وبعدها ارتباط فريضة الحج بالاطعام فكانت الأضاحي: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}.
وقد جعل الله سبحانه الاطعام من كفارات الذنوب، فيه يصل الإنسان ما انقطع في علاقته بربه (كفارة النذر وكفارة العهد وكفارة إفطار العمد من شهر رمضان وكفارة قتل النفس خطأً أو عمداً)
ونأتي إلى الخمس والزكاة بكونها من أركان الإسلام فقد ورد في الحديث: «إنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَاللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ».
ويضاف إلى ذلك العديد من الموارد التي حث فيها الإسلام على الإطعام، وان كان ذلك من باب الاستحباب، وذلك عند الانتقال إلى بيت جديد وعند الزواج، أو عندما يولد ولد حيث ورد استحباب العقيقة.. أو عند قدوم الحاج إلى منزله بعد أدائه فريضة الحج…
أيها الاحبة
عوداً على ما تذكره سيرة الإمام من كونه كان صاحب الجراب فمن نافل القول، أن الجهد الذي كان يقوم به الإمام واسلوبه في الاطعام، كان يلائم وسائل ذلك العصر وطرقه، وهذا الجهد الفردي ينبغي أن يبقى إلا أنه لا يمكن تحقيقه في هذه الأيام حيث كثرت الحاجات وتعددت، وكثر الناس وتباعدوا، فمع أهمية الجهد الفردي والحاجة إليه دائماً إلا أن الحاجة باتت ماسة إلى وجود مؤسسات تلبي كل هذه الاحتياجات وتصل إلى كل الأفراد.. كما يحتاج الأمر الى مخططات ودراسات واحصاءات..
ولعل من نذر الشر والفساد في واقعنا، والسبيل لسقوط المجتمعات، عندما يكون هناك أغنياء متخمون يرمون طعامهم وتكثر نفاياتهم.. فيما هناك فقراء يبحثون فيها(في تلك النفايات) عن لقمة عيشهم وما يؤمن لهم قوت يومهم.. انها لصورة سوريالية مؤلمة الى حد كبير، تعم العالم وتزحف إلى مجتمعاتنا..
فعندما تغيب العدالة الاجتماعية، ما يجعل الإنسان لا سيما الفقير لا يشعر بإنسانيته ولا كرامته، بالرغم من وفرة الموارد والإمكانات التي هي بالعادة تهدر ولا يحسن استثمارها، وإن استثمرت وزاد الإنتاج، عانى الفقراء من الظلم في توزيع الثروة بشكل عادل، لتبقى حكراً على فئة فاسدة.. حتى وان كانت هذه الاستثمارات نفايات كما بتنا نعاني…
ان العديد من الدول وخاصة الاسلامية، تملك موارد ضخمة، تضع أموالها في البنوك، أو تشتري السلاح الذي لا تستخدمه ويصدأ في المخازن، في الوقت الذي نجد فيه يومياً من يهيمون في بلاد الله الواسعة ويخوضون غمار البحر وقد يبتلعهم هرباً من واقعهم السيئ وعجزهم عن تأمين لقمة عيش لهم ولأطفالهم..
وفي الإطار نفسه، تطلق بعض الجماعات بكل خفة أن الإسلام هو الحل ولكن من دون أن تقدم تنظيراً للجانب الإقتصادي المعاشي المعاصر… حيث لا نرى ان إيلاء هم الامن الغذائي في الابحاث والدراسات والخطب والمحاضرات له الاولوية وفي مقدمة الاهتمامات، بل نرى ان الامر هامشي في مقابل المواضيع الأخرى الوعظية. واذا تصدى أحد لهذه الموضوعات فيكون للاسف وقت الازمات والحوادث والصدمات وعند استفحال المشكلات الحياتية.
أيها الأحبة ان الأوضاع الاقتصادية في السياق الذي ذكرنا يزداد تعقيدا يوما بعد يوم ولكن هل نيأس هل نقف مكتوفي الايدي ونقول لا حل والامور أكبر منا؟؟
لمن المؤكد لا.. لا يمكن ولدينا عرق إيمان والتزام. فموضوع الاحساس بجوع الآخرين هو من صلب إيماننا وصلب انتمائنا للاسلام. هو جوهر تعلقنا برسول الله وأهل بيته.. نحن الذين تربينا على: «لا تستح من اعطاء القليل فالحرمان اقل منه».. ونحن الذين تربينا على قول: «ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع».. وتربينا على «ما جاع فقير الا بما متع به غني» .. وعلى قول علي "اابيت مبطانا وحولي بطون غرثى واكباد حرى" ومذ كنا صغارا انغرست صورة صاحب الجراب في أذهاننا وهو يتنقل في الليالي المظلمة باحثا عن الجائعين.. هذا هو ارثنا هذه هي هويتنا وهذا هو الحل بين ايدينا لكثير من مشاكلنا وان ضاقت مساحته وكان كل في دائرته لكفى الله به وبارك فيه.
نعم في واقعنا بحمد الله ما يعبر عن هذا الوعي تجاه الاطعام وتخفيف الام الجوع والتكافل وقد انتقل هذا الارث عمليا من مستوى فردي الى مؤسساتي وقد من الله علينا بسماحة السيد(رض) الذي كان رائدا في هذا المجال ايمانا منه بأن الدين لا ينحصر فهمه بالامن الروحي وبناء العقل دون الامن الغذائي وبناء الجسد.
ولطالما كرر على مسامعنا ان الإنسان في المفهوم الإسلامي إذا بلغ القمة في العبادة فمظهر عبادته ان يصبح مشاءً في حوائج الناس وساعياً إليها. فمن يكون زيناً للعابدين لا بد ان يكون زيناً في خدمة الناس.
أيها الاحبة.. في ذكرى وفاة الامام زين العابدين نستلهم منهجا حدد عنوانه بالدعاء:
«اللَّهم وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْخَيْرَ، وَلا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ».
«اللَّهم وَفِّقْنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا وَلَيْلَتِنَا هَذِهِ وَفِي جَمِيعِ أَيَّامِنَا لِاسْتِعْمَالِ الْخَيْر وَمُعَاوَنَةِ الضَّعِيفِ، وَإِدْرَاكِ اللَّهِيفِ».
وَالْحَمْد لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ
الخطبة الثانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. وحتى نبلغ التَّقوى، لا بدَّ من أن نعرف أنفسنا جيداً، من نحن مِن الله؟ ومن نحن مع الله؟! ولعلَّ أفضل من أوضح لنا هذه الصورة هو الإمام زين العابدين(ع) في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي كان يدعو به ربه.
ما أجرأ الإنسان على ربّه حين يتحبَّب إليه بالنّعم ويعارضه بالذّنوب! فخيره إليه نازل، وشرّه إليه صاعد، لم يزل ولا يزال ملكٌ كريم يأتيه عنه بعملٍ قبيح، فلا يمنعه ذلك من أن يحوطه بعطفه وحنانه ورحمته، ألا يستحي الإنسان من ربّه؟
أيها الأحبة، متى وعى الإنسان أهميَّة علاقته بالله وطاعته له والسير على هداه.. فسيرى الحياة مشرقة مضيئة دائماً بنور ربها.. وسيكون أكثر وعياً وقدرةً على مواجهة تحدياتها وصعوباتها.
لبنان
والبداية من لبنان، الَّذي تستمرّ فيه حالة التردّي السياسيّ، والتي باتت تنعكس على واقعه الاقتصاديّ والاجتماعيّ والأمنيّ والبيئيّ والصحّيّ.. وتؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط بين المواطنين، الذين راحوا يهيمون في بلاد الله الواسعة، ويبحثون عن أرضٍ يشعرون فيها بدفء الدولة وأمانها ورعايتها، حتى لو كان ثمن ذلك أحياناً الغرق في البحار أو التيه في بلاد الله الواسعة.
لم تكن مشكلة النفايات إلا القشّة الّتي قصمت ظهر البعير، وأظهرت مدى عجز هذه الطبقة السياسية وترهّلها وعدم قدرتها على إدارة شؤون البلد ومعالجة مشاكل إنسانه. وحتى لو حُلّت هذه المشكلة، فسرعان ما سوف نصطدم بمشكلة أخرى، لأنَّ هذا النظام القائم، مع الأسف، لا ينتج إلا أزمات جديدة.
لقد كانوا في السابق يتحدثون عن الخارج بأنه السّبب في كل ما يجري وما وصلنا إليه، أما اليوم فلا عذر لهم.. فالخارج هو من يريد للبنان، ورغم كل ما يجري من حوله، الاستقرار والأمان..
ولو سلّمنا أنّ للخارج تأثيراً في المفاصل الأساسيّة للبلد، فهل للخارج تأثير في مسألة النفايات والكهرباء والماء وسلسلة الرتب والرواتب وحل مشكلة الفساد؟ وهل يريد الخارج لمجلس الوزراء أن لا يجتمع إلا للضرورة؟ هل يريد لمجلس النواب أن يبقى مغلقاً إلا للتَّشريعات الضّروريّة للمواطن.
لقد بات الحديث عن الخارج هو الشمّاعة الّتي يعلِّق عليها الكثيرون من هذا النّادي السّياسيّ فشلهم وعدم قيامهم بمسؤوليّاتهم أو عدم رغبتهم بالقيام بها.
إنَّ الحلول لن تأتي من الخارج، فهي في أيدي السّياسيّين الَّذين يديرون شؤون البلد، لكن شرط أن ينزعوا عنهم لباس طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم ومصالحهم وحساسياتهم، ويلبسوا لباس إنسان هذا الوطن، ويفكروا لحسابه، أن يربحوا إن ربح، وأن يسلموا إن سلم، وأن يرتاحوا إن ارتاح، أن يعودوا إلى إنسانيتهم ليعيشوا مع الناس معاناتهم في آلامهم وظروف حياتهم الصعبة التي يواجهونها كل يوم، وعندها ستحلّ مشكلة النفايات، وسيجتمع مجلس الوزراء والمجلس النيابي.. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية، وسيكون الحوار الجاري والذي سيجري فيما بعد منتجاً، وستعالج الكثير من المشكلات.. وعلى الأقل ستوضع على سكَّة العلاج.
ولكن هذا لن يحصل إن لم تجد هذه الطبقة السياسية أمامها شعباً يُراقب ويحاسب وينتقد؛ شعباً يفكّر بمسؤولية تجاه وطنه أكثر مما يفكّر بطائفته وموقعه السّياسيّ؛ شعباً يرفع على الأكتاف أولئك الذين يفكّرون بحجم أوطانهم، شعباً لا يبالي بالَّذين يدغدغون مشاعره الطائفيَّة، بل الَّذين يحركون طاقاتهم وجهودهم من أجل التخفيف من آلامه ومعاناته، والَّذين يريدون للوطن أن يكون قوياً عزيزاً، لا الذين يفكّرون في حجم اللحظة.
إنّنا نريد لكلّ هذا الواقع السياسي أن يكون بمستوى خطورة ما يجري من حوله وفي داخل بلده، ولا سيما في ظلّ ما جرى بالأمس، والتوقيفات اليومية للعناصر الإرهابية، والتي تشير إلى إمكانية أن يكون لبنان ساحة من ساحات التفجير في المنطقة، وإن كان بشكل محدود.
فلسطين
وإلى فلسطين التي استعادت الذكرى الثامنة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم. وللذاكرة، فإن هذا الوعد حصل في 2 تشرين الثاني من العام 1917، عندما منحت بريطانيا التي كانت تنتدب فلسطين، الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم على حساب الشعب الفلسطيني، والذي كان فاتحةً لمعاناة هذا الشعب المستمرة. وفي الوقت نفسه، شكّل هذا الوعد انطلاقةً للشَّعب الفلسطينيّ في جهاده المستمرّ، والذي يتجلّى في هذه الأيام في الانتفاضة المباركة التي لا بد من أن تؤتي أكلها، مهما غلت التضحيات والأثمان.. ففجر فلسطين بدأ يصنعه شبابها، بكل طهارتهم وأصالتهم، وسيصل هؤلاء الشباب بإذن الله لتحقيق أمانيهم..
عدم تقبل النقد
ونتوقّف أخيراً عند ظاهرةٍ باتت تحكم الكثير من واقعنا، وهي عدم تقبّل النّقد على مستوى الأفراد، وعلى الصّعيد الدينيّ أو السياسيّ، وعلى مستوى الدول، حيث تُغلق فضائيات ووسائل إعلام بحجّة أنها تمارس بعض أنواع النقد، ويسارع البعض إلى إدخال ذلك في إطار التجريح والعدوان، أو تمزيق الصّفّ، أو بثّ الفتن، وكأنّ بقاء الأوطان والحافظ على وحدتها وقوّتها، يقوم في ظلّ الأخطاء والعيوب ونقاط الضّعف! حيث لم يعد لدينا منطق "رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي"، أو منطق رسول الله(ص) عندما وقف أمام النّاس في آخر حياته طالباً منهم أن يأخذوا بحقّهم منه إذا كان لهم حقّ عنده، ليؤسّس لمنطق النّقد والمحاسبة حتى في علاقة الناس بالأنبياء، والأمر نفسه عند علي(ع) عندما قال: "فلاَ تُكَلِّمُونِي بَمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلاَ تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلاَ تُخَالِطُونِي بالْمُصَانَعَةِ، وَلاَ تَظُنّوا بِيَ اسْتِثْقَالاً فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَلاَ التمَاسَ إِعْظَام لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ".
أيها الأحبَّة، إنَّنا لا نستطيع أن نتجاوز أخطاء واقعنا أو نزيل ما يتهدّدنا من أزمات، إلا عندما نعيش، أفراداً وأمةً، ثقافة النقد البنّاء والواعي والهادئ، مع أيٍّ كان، ما دام بإمكاننا أن نخطئ أو أن يشتبه علينا الأمر.
المكتب الإعلامي لسماحة العلامة السيد علي فضل الله