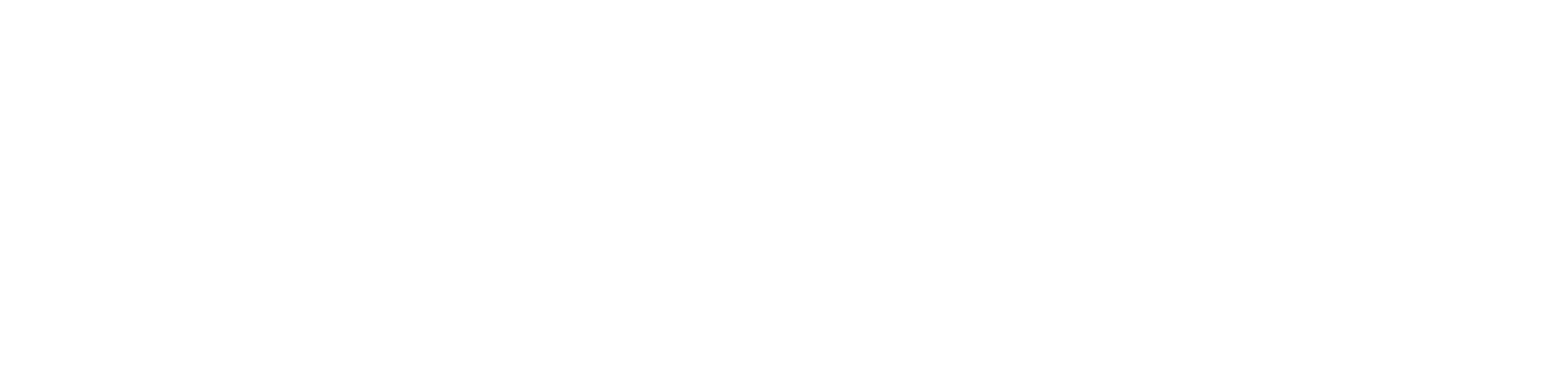الاستقامة من أهم ميزات الشخصية الإسلامية
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ألقى سماحة العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبتيه:
الخطبة الأولى
{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} (فصلت: ٣٠).
الاستقامة نهج، هو ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ الثابت، وتتمثّل في ابتعاد المسلم عن المعصية في كلّ أمر يقدم عليه بناء لما دعا اليه الله: {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ}. لذلك كانت الاستقامة من أهم ميزات الشخصية الإسلامية.
إن الإيمان المؤقت، غير الثابت، والذي يُعبر عنه بالايمان المستودع مقابل الايمان المستقر، هذا الايمان لا يمكن أن يؤسّس لاستقامة وازعة، ولا يمكن أن يكون حصناً آمناً، فقد يهتزّ ويتداعى عند أوّل مواجهة.
هل يمكن للإنسان المؤمن أن ينحرف؟
الوقائع تقول نعم، خصوصاً في مثل هذا العصر.
والوقائع تقول إنّنا نعيش عصر جاهلية جديدة، لها أصنامها، وأساليبها و كهانها ومروجوها الذين يدافعون عن آلهتها.
أليس هذا ما يحدث في العالم من حولنا؟ ونحن لسنا بمنأى عن هذا الطوفان، فقد باتت الأفكار والعادات والثقافات كما السلع الأخرى، بضائع عابرة للقارات، تُعلّب هي الأخرى، وتُصدّر، فلا حواجز جمركية تحول دون مرورها، ولا قيود تُفرض لمنع دخولها.
ما دُمتَ تملك التلفاز أو الهاتف المحمول، فالعالم ملك يديك، فالتسهيلات مُتاحة للجميع وبأرخص الأسعار: نشرات أخبار، وصفات جاهزة لتطويع العقول والقلوب وإماتة الوجدان والروح.
فبصحن لاقط على السطح، وجهاز إلى جانب التلفاز يصبح بمتناول يديك وأيدي العائلة ما بين ٥٠٠ وألف قناة فضائية معظمها يعمل ليل نهار، ولكلّ فرد من أفراد العائلة برامجه، فإن تُرك الأمرُ على غاربه فإنّ من بين البرامج وصفات جاهزة، لا تخطئ في مهمات زرع المجون والفساد، على الأقل في نفوس الأطفال والفتيان والفتيات والشباب.
أمّا الحديث عمّا يقدّمه الإنترنت في هذا المجال، فحدّث ولا حرج.
هذه الرؤية تدفع إلى السؤال: هل من الممكن الحد من أضرار هذا الانفتاح على العالم او ما يسمونه الغزو ولا بل هو الاجتياح بعينه. هل نستطيع أن نقاوم وصفات الفساد التي تتسلل إلى أسواقنا بضائع وسلعاً وأفكاراً؟
اليائسون يجيبون على ذلك بالنفي ويقولون: من المستحيل وقف هذا الطوفان. نحن لا نستطيع أن نقاوم فيستسلمون ولا يقاومون.نحن ندرك ايها الاحبة: ان العالم بات مثل قرية صغيرة، والدعوة إلى الانعزال والتقوقع معناها الموت أو الجمود حيث أنت.
أيضاً إنّ مقولة كلّ ما يأتينا فاسد أو فيه مفسدة ليست صحيحة، فالضلالة ليس لها وطن، وتستوطن وتقيم وتُفرّخ حيث تجد التربة المناسبة. اذا مطلوب اخذ القرار وبذل الجهد و الوعي ثم الوعي.
ما يصلنا فيه الغثّ والسمين، والصالح والطالح، وليس المعيار من أين مصدر هذه البضاعة أو الأفكار. المهم أن نختار المناسب،والصالح. كيف؟ تلك هي المسألة.
وان لم يفعل الانسان سحبته الدنيا بمغرياتها ومفاتنها ومفاسدها ليرى نفسه أصبح في عالم بعيد تماما عن الخط الذي ارتضاه لنفسه. وهنا كانت الحاجة إلى الاستقامة التي نحصلها عندما نفهم موقعنا من هذه الدنيا أو تلك.
البعض يسأل ونحن تحدثنا بهذا مرارا ونعيد التوضيح،عن علاقة الانسان الذي قرر ان يلتزم خط الايمان بالدنيا.
بكل بساطة لقد أوجد الله الإنسان على الأرض ليستثمرها ويُعمّرها، وسخّر له ما عليها، لكنّه عزّ وجل جعل دنيا الإنسان مزرعة لآخرته. لذلك للإنسان حق مشروع من الدنيا حتّى آخر شبر من الحلال المسموح به، مقابل عملية تطبيع علاقته بين الدنيا والآخرة.
صحيح أنّ القرآن ذمّ الدنيا، لكن ليس أي دنيا. ذم الدنيا التي تقود إلى الانحراف، والدنيا التي تندرج قولاً وفعلاً في دائرة المحرمات والمنكرات وخاصة تلك التي تتعلق بالفساد والافساد وبالاذى والاذية ..
مثل هذه الدنيا تطمس على القلب، تُصبح غاية وهدفاً وصنماً يُعبد.
مثل هذه الدنيا تسلب الإنسان إرادته ووعيه، وتجرّده من البصيرة، وهي التي ذمّها القرآن ووصفها بأنّها لعب ولهو ومتاع الغرور، ومائدة شهوات، وسوق لبيع الآخرة بحفنة من مال أو لحظة متعة، أو منصب أو جاه.
إنّ الله سبحانه لم يستخلف الإنسان في الأرض ليهجر دنياه، ولم يسخّر له الجمال، والطيبات والمتع كي يرى فيها أشياء ملعونة أو يجب معاداتها، فالقرآن واضح: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا…} (القصص: ٧٧)، ولكن شرط ألا تنال ذلك بالفسق والانحراف والبغي والفساد.
في الكثير من اللحظات في هذه الحياة يكون الإنسان كمن يقف على حافة منزلق انها لحظة الموازنة بين الأرباح والخسائر، بين الدنيا والآخرة، بين الاستقامة والانحراف.
من هنا نفهم لماذا يطلب الله عزّ وجل منّا أن ندعوه في كلّ صلاة: {اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (الفاتحة: ٦).
فعندما يكون الإنسان أمام عدد من الخيارات، في قضية أو مسألة، أو موقف، فأحد هذه الخيارات يكون الصراط المستقيم لأنّ فيه مرضاة الله، بينما الخيارات الأخرى هي طرق ملتوية ومنحرفة، بعضها تزيّنها النفس، وأخرى يدعو إليها الشيطان. هي السبل التي أشار اليها الله {وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}
هذه الموازنة، والمفاضلة لأخذ الخيار مسألة تخصّ الإنسان، وتخصّ إرادته، وليست أمراً مفروضاً عليه من الخارج. فإذا فضّل الهداية على الضلالة، وتقوى الله على المعصية، فإنّ الله ييسّر له سبل نجاح هذا الخيار. واذا رفض واختار العكس أيضا فإن الله يقول له انت حر ويعطيه ما طلب: {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ} لهذا سيواجه مصيره وحده وسيحاسبه الله.
اختر ايا شئت واسلك ما شئت ولكن عليك ان تكون حاضرا للاستجواب والمحاكمة امام الله، وان تتحمل نتيجة افعالك وسلوكك بميزان الله وحده {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا}.
أيها الاحبة، إن تكرار الطلب أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم، في قولنا اهدنا الصراط المستقيم، ليس الهدف منه هدايتنا إلى الخيار الصحيح، إلى الطريق الصحيح فحسب، بل أن ييسّر لنا استقامة مسيرتنا والاستمرار فيها، بعيداً عن أحابيل الشيطان من الانس والجان. المهم أن نبدأ صحيح ، ولكن الاهم هو كيف نكمل، الثبات وعدم زغزغة النية ولا الافعال "رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني".. اذا احتمال ان تنحرف بعد الهداية امر وارد وبشدة.
ومن هذا الموقع موقع السير بخطى ثابتة في الطريق الذي بدأناه وارتضيناه، تصبح الاستقامة أمراً ممكناً، وفعلاً مُتاحاً أمام أي مؤمن، ولو كان الانحراف في كلّ مكان من حولك يطل عليك من البرامج او الاعلام او الشبكة او التطبيقات .
وفي هذا قول رائع عن الإمام الصادق (ع): "ما ضَعُف بدن عمّا قويت عليه النية"
فالنية أساس العمل، والأعمال ثمار النيات، وصاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم، كما يقول الصادق(ع): «لأنّ سلامة القلب من هواجس المحذورات بتخليص النية لله في الأمور كلّها".
نعم الامور كلها وليس فقط في أوقات العبادات والدعاء للحاجات.. بل في باقي حياتنا وشؤون معيشتنا علينا أن نسأل عن رأي الله في هذا او ذاك،وفي كل أمر، ان يكون الله مرجعك في الامور كلها، علينا ان نعلم أجيالنا كيف يكون الله هو مرجعهم في كل شاردة وواردة ليسألوا ان كان ما يقومون به يرضي الله او يسخطه، فيصبح رضا الله هما وفي رأس الاولوية وليس رضى الجماعة أو النفس أو السائد أو الدارج او الموضة في المظهر وفي السلوكيات والعادات التي تفرض نفسها في كل لحظة ويعمل بها بدون تفكير او تدبر او مراعاة لشخصية ايمانية أو لاقتراب من الحرام كذلك يجب ان يكون الله المرجع عندما تجرنا هذه السلوكيات إلى أن نبذر وقتا او نثرثر او نغتاب او نشتم او نسب والى ما هنالك.
ان هذا الموضوع تحديدا.. كيفية جعل الله هو المرجع لدى أجيالنا هو قضية ملحة وعلاجها ليس بالسهل ويحتاج لمزيد من الحديث حولها قد نخصص له خطبة خاصة فيما بعد ..
ونختم بقول علي عليه السلام إمام الثبات والاستقامة:
«العمل العمل ثم النهاية النهاية، والاستقامة الاستقامة ثم الصبر الصبر، والورع الورع، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم»
والحمد لله رب العالمين.
الخطبة الثانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فهي خير الزاد، وتعني أن يكون الله حاضراً في عقلنا وقلبنا وكلّ كياننا. ولبلوغ التقوى، علينا أن نستعيد مسيرة السبايا بعد كربلاء، والّتي أرادها يزيد أن تكون مسيرة إذلال وهزيمة وتشهير بأهل البيت(ع)، ولكنّهم حولوها إلى محطةٍ لبثّ بذور الوعي، وإزالة الغشاوة عن العقول، وتحفيز الهمم، وإلى مظهر من مظاهر العزة والصلابة والقوة، الّتي عبرت عنها السيدة زينب(ع)، وعبَّر عنها الإمام زين العابدين في الكوفة وفي مجلس يزيد.
أيها الأحبَّة، بهذه الروح الَّتي عاشتها زينب بصبرها وصلابتها، ومعها الإمام زين العابدين(ع)، وكلّ السبايا، رُدَّ التّحدي، وأُحبط مشروع يزيد الَّذي كان يسعى إلى أن يدفن مشروع الحسين في صحراء كربلاء، وباستلهامنا لها، نواجه التحديات، وهي كثيرة.
لقد انتهى موسم عاشوراء، ولكن عاشوراء لم تنته، بل ستبقى حية تتجدَّد كلّ سنة، وعلى مر الزمن، لتعطي أكلها كل حين، عزةً، وعنفواناً، وإباءً، واستعداداً للتضحية بالغالي والنفيس.
ونحن هنا، لا بدّ من أن نشعر بالاعتزاز بهذه الأمة التي خرجت لتحيي مجالس عاشوراء، رغم الظروف الصعبة والتحديات الأمنية، لتعبّر بذلك عن عمق حبها وولائها للحسين(ع)، ولكلّ الدماء الزكية التي نزفت في كربلاء، ولتؤكّد مجدداً التزامها بالأهداف والقيم التي انطلق الحسين من أجل تثبيتها؛ والتي لم تكن يوماً أهدافاً مذهبية، أو طائفية، أو لشد العصب، بل هي كما حددها الحسين(ع): "خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر".. فالهدف كان واضحاً، أن يبقى الإسلام نقياً صافياً حاضراً في ساحة الحياة، وأن لا يبقى هناك فساد، أن لا تعطّل القوانين على الكبار، فيما تطبق على الضعفاء، أن لا يهدر المال العام، أن لا يظلم إنسان.
إنَّ الهدف من إحياء ذكرى عاشوراء، يتحقق عندما نبادر أفراداً ومجتمعاً وأمة، إلى القيام بورشة إصلاح لواقعنا، وعندما نقف مع كلّ مظلوم في مواجهة الظالم، ولا نؤيده.. وعندما لا نبايع مفسداً أو نؤيّده.. وعندما يكون الحقّ ميزاناً لأعمالنا ومواقفنا، حتى لو كان ذلك على حسابنا.
وعند الحديث عن مجالس عاشوراء، لا بدّ من أن نستنكر، وبشدة، ما تعرَّضت له بعض مجالس عاشوراء، وفي أكثر من بلد، ونحن نستطيع أن نؤكّد أنَّ الهوية الحقيقية للذين قاموا بهذا العمل الإجرامي، لا يمكن أن تكون إسلامية، فلا يمكن لمسلم أن يتعرض لمجلس يذكر فيه الحسين(ع)، الذي هو ابن بنت رسول الله، وهو إمام قام أو قعد، وسيد شباب أهل الجنة، ولا يمكن لهؤلاء أن يحملوا صفة الإنسانية، لما تحمله هذه المجالس من بعد إنساني، ولا يمكن أن يكونوا أتباع دين، والحسين هو وارث كل الأنبياء والرسالات..
إنّ هؤلاء صناع فتنة، وهذا ما عبرنا عنه عندما قيَّمنا حادثة الأحساء في المنطقة الشرقية للسعودية، فقد اعتبرنا ما جرى فيها مشروع فتنة، ومحاولة لتهيئة مناخ لإحداث شرخ داخل المجتمع الإسلاميّ في تلك المنطقة.
وهنا، نقدّر وعي أهل الأحساء وصبرهم، وعدم قيامهم بردود فعل كان يريدها الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي، في الوقت الذي ننوّه بمسارعة السلطات هناك إلى الإطباق على الجناة وملاحقتهم.. وندعو إلى معالجة حاسمة، وبالعمق، لكل ما قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية.
كذلك، فإنَّنا ننوّه بإيقاف السعودية فضائية من الفضائيات التي كانت تعمل على إثارة الحساسيات المذهبية والطائفية، ونأمل أن تواكب هذه المبادرة بمبادرات مماثلة، ونعيد دعوة العلماء، والقيادات، والواعين، والحريصين على سلامة العالم العربي والإسلامي، إلى إعادة النظر في الخطاب الموتر الَّذي يسمح لكلّ الساعين إلى الفتنة، بأن يجدوا جمهوراً لهم، ومشاركين في أعمالهم، فلا يكفي في هذه المرحلة، توصيف الصّراع بأنه صراع سياسي، بل لا بدَّ من معالجة كلّ المفردات التي تستثمر في السياسة، لإثارة الحساسيات المذهبية والطائفية لحساب مشاريع البعض ومخططاتهم.
ونحيي كلّ الأصوات التي انطلقت في عاشوراء، والتي تدعو إلى الوحدة، ومد اليد إلى الآخرين، وندعو إلى أن تقابل بدعوات مماثلة، فنحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى هذا الجهد، لمواجهة سياسية الاستنزاف التي يراد لها أن تستمر في سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا والبحرين، تحت عناوين مختلفة، حتى لا يبقى أيّ موقع من مواقع القوة في هذا العالم العربي والإسلامي.. ولتضيع فلسطين وسط كلّ ذلك، ولتضيع القدس، وكلّنا يشاهد ما جرى ويجري في القدس، حيث وصل الأمر إلى أن يدنّس العدو الصهيوني المسجد الأقصى، ويدخل إلى باحاته وساحاته، فضلاً عن استمراره في مشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية وفي القدس المحاصرة. ومع الأسف، كلّ ذلك يجري على مرأى الدول والشّعوب العربيّة والإسلاميّة ومسمعها، ولا نسمع مواقف بمستوى هذا الحدث.. وهنا، لا بدَّ من أن ننوّه بالروح الجهاديّة والاستشهاديّة لدى الشّعب الفلسطينيّ، الَّذي بات يبتدع وسائل جديدة لمقاومة هذا العدو، والرد على تدنيسه المقدسات.
ونصل إلى لبنان، الَّذي تستمر معاناته على مختلف الأصعدة، وقد كنا نتمنى أن ينعم في هذه المرحلة الصعبة بتجديد في الحياة السياسية، تساهم بالنهوض فيه، ولا سيما في الموقع الأهم المتمثل بالمجلس النيابي، وأن تجرى الانتخابات، كما هو مطلوب. ولكن يبدو أن حال المجلس النيابي كحال بقية المؤسسات في هذا البلد، التي يندرج وضعها تحت القاعدة التي تقول: ابق ما كان على ما كان، حتى يأتيك قاطع البرهان…
وعلى كلٍّ، فإننا نأمل أن يكون التَّمديد للتفعيل لا للتعطيل، ولا سيما في ظلّ الملفات المتعدّدة العالقة، سواء على مستوى قانون الانتخاب، أو الملفات الاجتماعيَّة والمعيشيَّة، ومواكبة ما يجري في هذا البلد الذي سيبقى في العناية الفائقة، إلى أن يقرر السياسيون أن يخرجوه منها، آملين أن يكون ذلك قريباً.
المكتب الإعلامي لسماحة العلامة السيد علي فضل الله