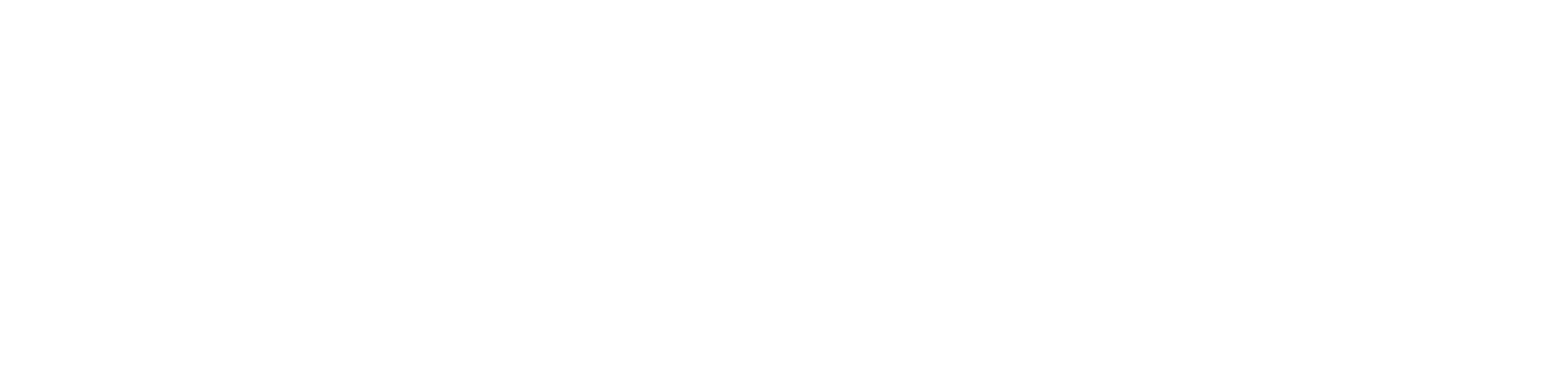نعمةُ السَّكينةِ في مواجهةِ الضّغوطِ وشدائدِ الحياة
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَللهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيم}[الفتح: 4]. صدق الله العظيم.
نعمةُ السَّكينة
أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، إلى واحدة من أبرز النِّعم التي أنزلها الله على عباده المؤمنين واختصَّهم بها، وهي نعمة السَّكينة.
فالمؤمنون طوال تاريخهم نعموا بالسَّكينة عندما كانت تشتدّ عليهم الضغوط، وتعصف بهم الأزمات، وتواجههم التحدّيات. والسَّكينة هي من السكون، وتعني الثبات والطمأنينة وهدوء النفس، وعدم التوتر والشَّعور بالخوف والقلق والاضطراب، وهم متى بلغوا هذه الحالة، سوف يكونون قادرين على التفكير السَّليم والقدرة على اتخاذ القرار النَّابع من إيمانهم وثقتهم بربّهم، لا من خوفهم وقلقهم.
وقد بيَّن الله سبحانه أنَّ شرط حصولهم على السَّكينة ومدّهم به هو الإيمان؛ الإيمان الَّذي لا يقف عند حدود اللّسان، بل الإيمان الذي يبلغ أعماق القلب، وينعكس على الآخرين محبة وبذلاً وعطاءً وجهاداً وتضحية.
فالإيمان هو ما خلص في القلب وصدَّقه العمل، هذا الإيمان الذي أشار الله سبحانه إلى سماته، عندما قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}[الأنفال: 2].
فالمؤمنون في حسابات الله هم الَّذين يعرفون الله حقَّ معرفته، ويشعرون بعظمته وعلوّه، ويرون فيه سنداً ومعيناً عندما تواجههم التحدّيات والأزمات والضّغوط، وينعكس هذا الشّعور في صلاتهم وبذلهم وعطائهم للآخرين.
من مظاهرِ السَّكينة
وقد تحدَّث القرآن الكريم عن العديد من مظاهر السَّكينة التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل والمؤمنين، فأشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها نزلت على نبيِّه إبراهيم (ع)، عندما ترك زوجته وولده الرَّضيع في الصّحراء القاحلة في موقع البيت الحرام قبل أن يأمره ببنائه، حيث لم يكن هناك ماء ولا طعام ولا بشر، من دون أن يشعر بالقلق عليهم في ذلك المكان، اكتفى يومها بأن توجه إلى الله في طريق عودته إلى فلسطين حيث كان يسكن، بالقول: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ}[إبراهيم: 37].
وهذه السّكينة أودعها الله عزَّ وجلَّ أيضاً في قلب زوجته هاجر، لذا قالت بعدما أخبرها إبراهيم (ع) بأنّه سيتركها: “إنَّ الله لن يضيِّعنا”، وكان لها ما تمنَّت.
والسَّكينة هي التي أنزلها الله عزَّ وجلَّ على النبيّ موسى (ع)، وجعلته لا يخشى فرعون وجيشه عندما لاحقهم، وكاد يصل إليه وإلى قومه بعدما بلغوا شاطئ البحر، يوم قرَّر أن يخرج بهم من تحت نير سلطة فرعون وبطشه، وقالوا له: {إِنَّا لَمُدْرَكُونَ}[الشّعراء: 61]، فقال لهم بلسان السَّكينة التي كانت في قلبه: {كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}[الشّعراء: 62].
وهذه السَّكينة كانت حال رسول الله محمَّد (ص)، حين تعرّض إلى ما تعرَّض له من شدائد ومحن، ونال ما ناله من الأذى من حصار وضغوط واتهامات بأنّه ساحر ومجنون، وأنّه يفرّق بين المرء وزوجه… ولم يضطرب آنذاك، ولم يتوتّر ولم يتراجع، بل اكتفى بأن يقول لعمِّه بلسان السَّكينة التي كانت تملأ كيانه: “يا عمّ، والله لو وضعوا الشَّمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه”.
وقد أشار القرآن إلى السكينة التي أنزلها على قلب رسول الله يوم لاحقته قريش، بعدما علمت بهجرته من مكَّة إلى المدينة، وقرَّرت القبض عليه لقتله، ووصل يومها رجالها إلى فم غار ثور، حيث تخفَّى عنهم مع صاحبه، وقد أشار الله سبحانه إلى هذه السَّكينة بقوله: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَ}[التّوبة: 40].
وهو أشار إلى هذه السَّكينة التي ملأت قلوب المسلمين بعد معركة أحد، عندما جاءهم من يخبرهم أنَّ قريشاً قرَّرت أن تغزو المدينة، وهي التي جعلتهم لا يخشون قريشاً رغم جبروتها، ورغم كلّ الآلام التي أصابتهم، ويقرِّرون الصمود والمواجهة، ما دفعها إلى أن تتراجع عمّا كانت ستقدم عليه. وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ الله وَالله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}[آل عمران: 173 – 174].
وتجلَّت السَّكينة في معركة الأحزاب عندما قدم المشركون بعشرة آلاف فارس، وحاصروا المدينة من كلِّ جانب، والتي أشار إليها الله سبحانه إليها، عندما قال: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً}[الأحزاب: 10 – 11]، وقد عبَّر المؤمنون عنها: {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً}[الأحزاب: 22]. وهي تجلَّت في معركة حنين، يوم تعرَّض المسلمون لكمين محكم من المشركين، والَّذي أدَّى إلى أن تتفرَّق صفوفهم بسببه. يومها، أنزل الله السَّكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وتحوَّلت المعركة من هزيمة كادت تلحق بالمسلمين إلى نصر، والّذي أشار إليه الله سبحانه: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ* ثُمَّ أَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}[التّوبة: 25 – 26].
السّكينةُ مظهرُ الإيمان
أيّها الأحبَّة: في زمن القلق والتوتّرات والانفعالات والعصبيّات، وزمن التحدّيات والشَّدائد، نحن أحوج ما نكون إلى هذا الهدوء النّفسيّ، إلى السَّكينة والوقار، وإلى طمأنينة القلب والتفكير البعيد عن الانفعال والتوتر، حتّى نقدر على التّعامل مع كلّ هذه الأجواء القاسية، وعلى النّجاح في تجاوزها.
نحن قادرون أن نحصل عليها عندما نعيش الإيمان عميقاً في قلوبنا، الإيمان الَّذي يجعلنا نشعر بالله سبحانه حاضراً في ساحة الحياة، وأنَّه قريب منا، يسمع نداءنا إن ناديناه، واستغاثتنا إن استغثناه، وينصرنا إن استنصرناه، ويمدّ لنا يد العون إن توكَّلنا عليه، وعندما يرانا قد أخلصنا القول والعمل، ووقفنا حيث يريدنا أن نقف.
والسَّكينة، أيُّها الأحبّة، هي مظهر لإيماننا وعلامة له، بها نقيس إيماننا، فلا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمناً، إلّا إذا كان رابط الجأش في الشَّدائد والصّعوبات، حافظاً لسكونه ووقاره عند الزّلازل والهزّات، غير خاضع للانفعالات والحساسيّات، وغير مهتزّ أمام البلاء والآلام… فالمؤمن في كلِّ هذه الحالات، يبقى صابراً ثابتاً واعياً حكيماً.
وقد ورد في صفات المؤمن: “في الزّلازل وقور، وفي المكاره صبور”. وقد سئل الإمام الصّادق (ع): بأيّ شيء يعلم المؤمن أنّه مؤمن؟ قال: “بالتّسليم لله، والرّضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط”.
ومتى بلغنا ذلك، فإنَّ نفوسنا ستبلغ القمَّة الّتي لا قمَّة بعدها، وستكون لنا نفوس لا تكسرها العواصف، ولا تهزّها زلازل الحياة، ولا ظروف الواقع السياسي أو الاقتصادي أو الأمني القاسية، نفوس اطمأنّت بذكر الله، وينطبق عليها قوله سبحانه: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله أَلَا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}[الرعد: 28].
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الخطبة الثّانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بما ورد عن الإمام الصَّادق (ع) حين قال: “أوحَى اللهُ تعالى إلى داوودَ: أنَّ خَلّادةَ بنتَ أوسٍ بَشِّرْها بِالجَنَّةِ، وأعلِمْها أنَّها قَرِينَتُكَ في الجَنَّةِ. فَانطَلَقَ إلَيها، فَقَرَعَ البابَ عَلَيها، فَخَرَجَت وقالَت: هَل نَزَلَ فِيَّ شَيءٌ؟ قالَ: نَعَم، قالَت: وما هُو؟ قالَ: إنَّ اللهَ تعالى أوحَى إلَيَّ وأخبَرَني أنّكِ قَرِينَتي في الجَنَّةِ، وأن اُبَشِّرَكِ بالجَنَّةِ، قالَت: أوَيَكونُ اسمٌ وافَقَ اسمي؟! قالَ: إنّكِ لأنتِ هِي! قالَت: يا نَبِيَّ اللهِ، ما أكَذِّبُكَ، ولا واللهِ ما أعرِفُ مِن نَفسِي ما وَصَفتَني بهِ.
قالَ داوودُ: أخبِرِيني عن ضَمِيرِكِ وسَرِيرَتِكِ ما هُو؟ قالَت: أمّا هذا فَسَأخبِرُكَ بهِ، أخبِرُكَ أنّهُ لَم يُصِبْني وَجَعٌ قَطُّ نَزَلَ بي كائناً ما كانَ، ولا نَزَلَ بي ضُرٌّ وحاجَةٌ وجُوعٌ كائناً ما كانَ، إلّا صَبَرتُ علَيهِ، ولَم أسألِ اللهَ كَشفَهُ عَنّي حتّى يُحَوِّلَهُ هو عنّي إلى العافيَةِ والسَّعَةِ، ولَم أطلُبْ بَدَلاً، وشَكَرتُ اللهَ علَيها وحَمِدتُهُ، فأنا راضية بقضائه. فقالَ داوودُ (ع): فبِهذا بَلَغتِ ما بَلَغتِ”.
أيُّها الأحبَّة: نحن أحوج ما نكون إلى الصَّبر؛ أن نصبر على البلاء ونرى فيه نعمة، فقد ورد في الحديث: “ما من بليَّة إلا ولله فيها نعمة تحيط بها”، وبها نواجه التحديات.
وقد ورد في الحديث: “ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ من عبدي المؤمن، وانّي إنَّما أبتليه لما هو خير له، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليرض بقضائي”.
الصّمودُ الفلسطينيّ
والبداية من فلسطين، حيث يستمرّ الشعب الفلسطيني بالصّمود رغم الفظائع التي يرتكبها العدوّ الصهيوني بحقّ الآمنين في بيوتهم وأماكن لجوئهم، والتَّدمير الممنهج للمباني والمؤسَّسات التربوية والتعليمية، والمستشفيات والمؤسَّسات الإنسانية، والحصار الذي يفرضه على القطاع، ومنع وصول المؤن والوقود حتى إلى المستشفيات.
ولعلَّ ما يدمي القلب، ويشعرنا بالخوف على المستقبل، أن يشهد العالم كلَّ هذه الصّور المؤلمة والفظيعة، ولا يتحرَّك ضميره، بل يزداد إمعاناً في مساعدة العدوّ على الاستمرار فيها.
لقد أصبح من الواضح أنَّ العدوَّ يستهدف من وراء ذلك كسر إرادة هذا الشَّعب، وسلب قراره، وفرض خياراته عليه، وإعادة الاعتبار إلى جيشه المهزوم.
يجري كلّ ذلك في ظلّ استمرار الدعم الغربي الكامل والمطلق لهذا الكيان والتبرير لجرائمه، وعدم السَّماح بأيّ قرارات تدين ارتكاباته ومجازره، أو تؤدّي إلى إيقاف هذا النزف، ما عرّى الغرب، وأظهر عدم جديَّة الشِّعارات التي كان يطلقها حول حقوق الإنسان، ومواجهة الإرهاب، وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، عندما تمسّ هذه الشعارات مصالحه أو مصالح هذا الكيان، وسوف تبقى هذه المواقف وصمة عار لن تزول عن جبين هذه الدّول.
وإن كنَّا بدأنا نشهد أصواتاً بدأت تنطلق من الغرب، والتي عبَّرت عنها مواقف بعض دوله، أو في المسيرات الحاشدة التي انطلقت في أغلب عواصمه، والتي تعلن عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ورفضها لممارسات هذا الكيان، والصّورة التي يقدِّمها العدوّ عن نفسه بأنَّه الضحيَّة والمعتدَى عليه، وأنه إنما يقف في وجه الإرهاب.
إنَّنا أمام كلِّ الذي يجري، نجدِّد التحايا إلى الشَّعب الفلسطيني في غزّة والضفَّة الغربيَّة، الَّذين أصبحوا أنموذجاً يحتذَى به في البطولة والفداء، ويقدّمون كلَّ يوم دليلاً إضافياً على عنفوانهم وتشبّثهم بأرضهم، واستعدادهم لبذل أقصى التَّضحيات للدّفاع عنها وتحريرها من مغتصبيها، رغم ضعف الإمكانات والقدرات، ما يجعله مؤهَّلاً لتحقيق ما يصبو إليه من حقِّه بالحياة العزيزة الكريمة والحرَّة، والتي لا بدَّ أن يصل إليها.
وهنا نجدِّد دعوتنا لتوحيد كلّ جهود الشعب الفلسطيني، بكلِّ تنوعاته السياسية والجهادية، حتى لا تظهر الصّورة بأنّ ما يتمّ استهدافه هو فريق من هذا الشَّعب، بل شعب بأكمله، وبعدما أثبتت كلّ الوقائع أنَّ هذا العدوّ لا يستهدف فصيلاً بعينه، بل القضيَّة كلّها.
مسؤوليّةُ الدّولِ العربيّة
ونحن في الوقت نفسه، نجدِّد دعوتنا للدول العربيَّة والإسلاميَّة، أن تتحمَّل مسؤوليَّتها تجاه الله والحاضر والتَّاريخ، في الوقوف مع بلد عربي وإسلامي يعاني ويتألم، وأن تتجاوز في ذلك أيّ حسابات واعتبارات قد تدعوها إلى التلكّؤ في نجدته والوقوف معه، فليس الوقت وقت تصفية حسابات ولا ردّ اعتبار، وأن تعي أنَّها تقوى إن صمد هذا الشَّعب وثبت، الأمر الذي سوف يجعل لها حضوراً في هذا العالم الَّذي لا يحترم إلا الأقوياء، فيما الويل، كلّ الويل، لهذه المنطقة إن استطاع هذا العدوّ أن يحقِّق هدفه من المجازر، إذ ستمتدّ يد هذا الكيان إلى أيّ بلد عربي يريد أن يقوى، أو يريد تحقيق طموحاته أسوةً ببقية بلدان العالم.
إنَّ هذا الكيان وجد على حساب العرب والمسلمين وحساب استقرارهم وأمنهم، فهو وحده في هذه المنطقة يمنع وحدتها وتكاتفها وتآلفها، ويمنع أيَّ بلد أن يفكِّر أن يكون حراً في أرضه وقراره وثرواته، وأن يكون نداً في هذا العالم.
وهنا ننوِّه بكلّ الدول والشعوب التي عبَّرت وتعبِّر عن تضامنها مع هذا الشَّعب في معاناته، والذي عبَّرت عنه التظاهرات الحاشدة التي شهدناها في اليمن والعراق وإيران وسوريا والكويت، وقرار البرلمان التونسي بتجريم التّطبيع مع العدوّ، فضلاً عمّا حصل في الأردن من استدعاء السّفير الأردنيّ من إسرائيل، والطّلب من إسرائيل عدم إعادة سفيرها إلى الأردن.
الوحدةُ في مواجهةِ العدوّ
ونعود إلى هذا البلد، لنؤكِّد أهميَّة الحفاظ على الوحدة الداخليَّة وتعزيزها في مواجهة هذا الكيان.
إننا لا نريد أن نهوِّن من قدرات هذا العدوّ وما قد يقوم به عند مواجهته، وهو مما خبرناه وعرفناه، ولكنَّنا ينبغي أن نأخذ في الاعتبار نقاط ضعفه، وأن لا ننسى عناصر القوَّة التي يمتلكها هذا البلد، والتي كانت وستبقى تجعل هذا العدوّ يخشى الدخول في حرب معه، والعدوّ هو أكثر من يعي ذلك، ونرى أننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى بذل كلّ الجهود التي تضمن التحصين الداخلي لهذا البلد وتعزيز مقوِّمات صموده. ويبقى الأساس في ذلك، هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، من خلال إنجاز الاستحقاق الرئاسي والحكومي، وملء الشغور في المؤسَّسة العسكرية، وذلك بالعمل الجادّ على إزالة كلّ الحواجز الداخلية والخارجية التي لا تزال تقف عائقاً أمام هذه الاستحقاقات، والمعالجة الجادَّة للأزمات الضاغطة على أمن اللبنانيّين الغذائي والمعيشي، وقدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء ومدارس أولادهم وجامعاتهم، ما بات يثقل حياة المواطنين، ويهدِّد استقرارهم في هذا البلد، حيث لا يمكن لهذا البلد أن يواجه التحدي الماثل أمامه، أو التَّداعيات التي قد تحصل، بهذا الترهّل الذي نعيشه، ونحن قادرون بوحدتنا على إيجاد الحلول له…