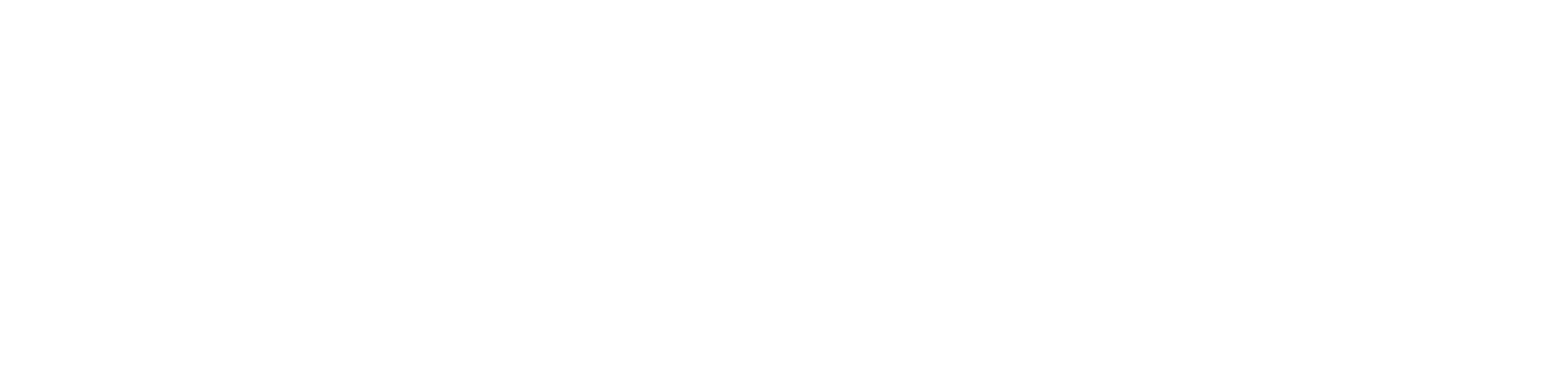نعم الله لا تحصى
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ألقى سماحة العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبتيه:
الخطبة الأولى
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}…وقال {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}
ما من إنسان على وجه الارض إلا ويسعى الى السعادة يجعلها هدفا ويطرق أبوابها سعياً للوصول إليها..
فلأجل السعادة يسهر الناس الليالي، يكدّون ويتعبون، ويهاجرون إلى بلاد الله الواسعة..
ولكن هل يبلغون السعادة، هل يصلون إليها؟ ثم ما هي الابواب الموصلة للسعادة؟ سؤال يطرح نفسه دائما ويشغل الكثير من المفكرين والعلماء وعلماء النفس والاجتماع..
للإسلام نظرته في ذلك.. وهي تأخذ بعداً أوسع مما يطرحه الآخرون.. وتنطلق من نظرة الإسلام للإنسان، ودوره، في هذه الحياة..
والفرق في النظريتين يكمن في الجواب عن هذا السؤال: بلوغ السعادة والامتنان والرضا يكون بالحصول على المال والجاه والموقع، أم ان ممارسة الامتنان والحمد والشكر هو الذي يؤدي إلى السعادة؟
مما لا شك فيه ان الشعور بالامتنان والحمد هو ما يجلب السعادة وليس العكس.. وإلا بماذا نفسر ان اناسا يحصلون على كل ما يريدونه من هذه الدنيا، ويحيون حياة بذخ وترف، ولكنهم يظلون تعساء ولا ينفكون يبحثون عن السعادة التي يسعون وراءها كسراب ووهم.. في حين أن هناك من هو فقير الحال، ممتن للنعم اليسيرة التي هو فيها ويشعر بالسعادة وينام قرير العين لماذا؟
لإن السعادة هي شعورك بالامتنان، وتعريف الامتنان هو ذلك الشعور الذي يفيض من قلب الانسان، عندما يحصل على هدية مجانية.. هبة تأتيه من دون تعب او مشقة. هي له خالصة ولم يسع اليها او يطلبها اويدفع ثمنها.
وكل انسان كائناً من كان وأينما كان اذا بحث يجد ان أبواب الامتنان حوله متوفرة وكثيرة.. ولبلوغ ذلك ما عليه الا ان يدقق، يفتح عينه، يستشعرها بقلبه فلا يمر عليها مرور الكرام بل يقف تماما كالذي يقف امام الاشارة لكي يعبر.. اولا عليه ان يدقق النظر ليبحث عن مواطن النعم، وكلما تأمل وتفكر تحسسها اكثر، وجعل لحياته معنى.
قد يسأل سائل أضناه طلب لقمة العيش: أين هي النعم؟
أيها الأحبة:
الواقع أننا محاطون بالنعم التي لا تحصى، وكلها تستوجب منا هذا الإحساس بالشكر والامتنان.. ففي كل تفصيل في وجودنا نعمة.. والمشكلة اننا دائماً نهرب من الجلوس مع أنفسنا كي نتأمل. دائما نحن مستعجلون ومسرعون.. ولا نصمم محطات لقطار حياتنا، ولو فعلنا ذلك لصار الهواء الذي نتنفسه مصدر سعادة لنا، نعرف قيمته فنشكر الله على ما أعطانا مجانا. وقد ورد عن علي عليه السلام: يا كميل "أنه لا تخلو من نعمة الله عزّ وجلّ عندك وعافيته، فلا تَخْلُ من تحميده وتمجيده، وتسبيحه، وتقديسه، وشكره، وذكره على كلّ حال" ….
ومن هنا ورد إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فاغمض عينيك.. وكلنا مررنا بتجربة الصوم الذي من أهدافه أن يشعرنا بالقيمة الكبيرة لنعمة الطعام والشراب ونعمة اللذات الأخرى التي أراد الله أن نلتفت إليها ونعرف أهميتها عندما أمرنا بتركها….
المشكلة هي في النعم المجهولة التي نغيبها كما قال علي(ع) "نعمتان مجهولتان الصحة والامان" اننا قد لا نلتفت أو ندقق بنعمة البصر إلا عندما نرى مكفوفاً، في حين يجب ان نفعل ذلك كلما نظرنا في المرآة.. وعادة لا نلتفت الى قيمة الصحة، إلا عندما نذهب إلى مستشفى او نرى مريضا..، أو قيمة النعم التي أغدقها الله علينا إلا عندما نشاهد جائعين أو عطاشى..
نحن غالباً لا نلتفت إلى هذه النعم، لأننا نقيم واقعنا على أساس ما نفقده، لا على أساس ما نملكه، ولذلك نعيش دوماً الألم والحسرة والتأفف والتضجر، ولا نرضى بما نحن عليه، فيما الصحيح أن نجمع أجزاء الصورة حتى نشاهدها كاملة، وبذلك تتبدل الصورة القاتمة بالسعادة المشرقة لما نملك .. وما أعمق كلمة المسيح(ع) عندما مر بجيفة كلب نتنة.. فقال أصحابه: ما أشدّ نتن رائحته! لكنّ السيّد المسيح قال: "ما أشدّ بياض أسنانه".
ايها الاحبة
إن من أهم النعم التي لا يتلفت إليها الكثيرون، رغم أنها تُعطى مجاناً هي نعمة العمر او الوجود. فنحن لم ندفع مقابل العمر أي قرش، ولم نبذل للحصول عليه أي جهد، فمن يضمن عمره؟ لا أحد، لهذا كل دقيقة تعطى لك هي نعمة يجب ان تشعر بأهميتها، ويجب ان تشعر بداخلك بالامتنان لأجلها، هي لك ولا تدري ان كنت ستحصل على غيرها..
فالعمر منحة وهبها الله لنا وأعطانا إياها، من دون أن يطلب منا مقابلاً.. وإذا كان البعض يتحدث عما فرضه الله علينا من عبادات، فهي ليست مقابل نعمه، فالله غني عن عباده، فما فرضه الله علينا من واجبات فلأجل صالحنا، وخيرنا ..
وحتى لو لم نجد في العمر ما نرغب فيه.. أو نستطيع أن نبلغ به أحلامنا، بل حتى لو ابتلينا بأمراض وهموم ومشاكل، وحتى لو كانت الحياة شاقة وصعبة فحتى في الابتلاء عندما يقع، هناك نعمة يجب ان تتحسسها.. والنعمة هي انك تتعلم من الابتلاء.. انت تحولها بارادتك ووعيك الى فرصة للتعلم وللتطور وللتغيير وفرصة لتفهم الحياة وتختبرها ..
فمن الألم والمرض والمعاناة نتعلم الصبر، والقدرة على التحمل، ونتعلم منها أن نعرف قيمة الصحة ولذتها.. قيمة ما كنا نعيشه من طمأنينة وراحة..
ان الابتلاءات هي فرصة يجب ان ننظر اليها بالامتنان "نحمد الله في السراء والضراء واليسر والعسر" فتخف حينها وطأة الشعور بالاسى والتذمر والشكوى وعدم الرضا.
ففي الحديث القدسي: "ما خلقت خلقاً أحب إلي من عبدي المؤمن، وإني إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا اعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، و"ليشكر نعمائي"، وليرض بقضائي، اكتبه في الصديقين عندي، إذا عمل برضاي وأطاع أمري".
هذه هي مدرسة الاسلام مدرسة الباحثين عن السعادة الحقة، هي منهج حياة "ليشكر نعمائي" هذا تدريب عملي لكل انسان ومعادلة الامتنان هنا والشعور بالنعم باب مضمون للوصول للسعادة وليس العكس.
هذا هو باب السعادة الحمدلله : الحمدلله على كل حال قناعة ورضى، ولنتذكر دائما أن سعادتنا لا تكتمل الا بسعادة الاخرين: بإسعادهم وهذا سبب لزيادة سعادتنا.. فقيمة السعادة أيها الأحبة أن تشعر أنك لست سعيداً وحدك، بل أنك سعيد مع الآخرين، وأنك السبب في بلوغهم للسعادة.. فلا تفوت فرصة أن تسعد الآخرين الذين يرسلهم الله لك ويجعلهم من حولك.
إسعاد الآخر نعمة فلا تدعها تمر.. هي نعمة تصب في دنياك وآخرتك..
أيها الأحبة:
نحن بحاجة إلى أن نعيش الإحساس بالنعم وإلى إشاعة جو الامتنان والشكر.. فهذا الجو يبدل من فهمنا لحياتنا، ويساعدنا لتغيير واقعنا ولجعل العالم الذي نعيشه أفضل.. أن نعيش الامتنان والحمد يعني أن نعيش القناعة التي تبعدنا عن التنازع المدمر، والعداوات الواسعة، وما يجر ذلك من أحقاد… لأنك بالامتنان ستكون مكتفياً راضياً بما عندك وستشارك الناس من حولك..
ولهذا يريدنا الله أن نحمده في صلاتنا وأدعيتنا، ان يكون حمدنا حياة لقلوبنا، وبوصلة توجهنا نحو الله.. لا ان تُقال كلمات الحمد محط كلام، او تكملة حديث، أو الحمدلله التي تدل على عدم الرضا ماشي الحال، يقولها أحدهم وكأنها آخر قارب نجاه لديه قبل أن يستسلم لليأس.
ان الحمدلله الواعية هي علاج للنفوس التي أتعبها القلق، هي مدخل للامتنان والسعادة .. وعظمة "الحمدلله" انه كلما قالها الانسان وجب عليه حمد جديد "فكلما قلت لك يا رب الحمد وجب علي لذلك أن أقول الحمد"
ان الحديث عن النعم {وأما بنعمة ربك فحدث} هو ليس لأجل الله فهو غني عن شكرنا.. بل لأجلنا نحن.. ان احصاءنا للنعم التي يجد كل واحد نفسه محاطاً بها كفيل ان يولّد له سروراً وسعادة في الدنيا، من جهة وهي فرصته لبلوغ المرتبة التي يبلغها الشاكرون الحامدون {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً}.. {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد} فطوبى للشاكرين الحامدين.
والحمدلله رب العالمين
الخطبة الثانية
عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فتزوَّدوا منها، فإنها خير الزاد في الدنيا والآخرة. ومن التقوى، الاستهداء بما ورد عن أحد العباد المعروفين في البصرة، الّذي اجتمع عليه الناس، وشكوا إليه غلاء اللحم، وطلبوا منه الدعاء، فقال لهم: "إني لعجب من أمركم، تشكون من غلاء اللحم، وبإمكانكم أن ترخّصوه"، فقالوا: "كيف؟"، قال: "اتركوه، وازهدوا فيه، فإنه يرخُص"، ثم أنشد:
وإذا غلا شيء عليّ تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا
فأخذ الناس بقوله، وتركوا شراء اللحم، فبقي مكدّساً في جوانب القصابين، فاضطروا إلى ترخيصه، وعاد الناس إلى شرائه.
أيها الأحبَّة، قد لا يكون المقصود بطرح هذه الفكرة توضيح الطريق الذي ينبغي سلوكه، والذي نحتاجه لترخيص الأسعار، وإن كنا قد نحتاج إليه في مواجهة الغلاء المستشري في اللحم أو في غيره من السلع المتداولة، فغالباً ما يكون طلبنا وإلحاحنا، وحتى جشعنا، هو الذي يؤدي إلى غلاء أسعار السلع التي نشتريها، والزهد فيها قد يكون هو الحل لتحسين أسعارها. إنّ المقصود من القصة هو أن يكون لنا دور في تغيير الواقع المعيشي والاقتصادي، كما الواقع السياسي، فلا نكون على هامشه.
فلنتعوَّد على أن نقلع شوكنا بأظافرنا، ولا ننتظر أن يأتي الآخرون ليقلعوا أشواكنا. وبذلك، بُنيت المؤسسات التي ترفد المجتمع، وانطلقت مبادرات الخير، وواجهنا التحديات، وحققنا الانتصارات، ومنها الانتصار الذي تحقق في العام 2006، والذي نستعيده هذه الأيام، فنحن نعيش الذكرى الثامنة للانتصار الذي حققه اللبنانيون بفعل التعاون الذي تم بين المقاومة التي أعدّت العدة لمواجهة العدوّ، والجيش الذي آزر وضحّى، والشعب الذي صمد وصبر وتوحّد.
لقد أكَّد هذا الانتصار قدرة اللبنانيين على دحر أعتى قوة في المنطقة وهزيمتها، بعد أن توحدت جهودهم، ولم يتفرقوا بفعل الفتن الطائفية والمذهبية والسياسية، وبذلك، كانت الوحدة هي السلاح الأمضى لمواجهة هذا الكيان.
وفي الوقت الّذي نجدِّد التهنئة للبنانيين والعرب والمسلمين وكل المستضعفين، بذكرى الانتصار، ولا سيما أولئك الّذين قدموا أغلى التضحيات في هذا الطريق، وأغلاها تضحية الدم، ندعو اللبنانيين إلى حفظ هذا الانتصار والإنجازات، عبر المزيد من التكاتف، وتراص الصفوف فيما بينهم، وتعزيز الوحدة، وحفظ المقاومة الّتي أعزتهم، وعدم إدخالها في الحسابات الطائفيّة والمذهبيّة والحرتقات السياسيّة.
إنَّ المقاومة ستبقى سنداً للجيش اللبناني وقوة له، ولن تكون بديلاً عنه، فالمسؤولية الأساس في حفظ حدود الوطن تبقى عليه، وستكون المقاومة ممتنّة إذا كان الجيش قادراً على القيام بمسؤولية مواجهة العدو الصهيوني وخطره؛ فالعدو الصهيوني لن يكلَّ ولن يملّ حتى يثأر لهزيمته، ويعيد الاعتبار لمعنويات جيشه، بعد أن أذلته المقاومة، ومرّغت أنفه بالتراب على أرض جبل عامل والبقاع وبيروت وكل الوطن، وأنهت مقولة الجيش الذي لا يُقهر، رغم التضحيات الجسام والأثمان التي قدِّمت ولا تزال تقدَّم.
إنّ المطلوب في هذه المرحلة، هو تثبيت السّاحة الداخليّة والأرض التي نقف عليها، والّتي ينبغي أن تبقى قويّة صلبة في مواجهة هذا التّحدي المستمر، وكلّ التّحديات، ومن ذلك، التّحدي الّذي برز على الحدود الشرقية مع سوريا، والذي نأمل أن يكون قد انتهى بدخول الجيش اللبناني إلى عرسال، وأن يستكمل بعودة الجنود المخطوفين من الجيش اللبناني، فلا بد من أن تبذل كل الجهود لإعادتهم إلى موقعهم ودورهم وإلى عائلاتهم، ويبقى الحذر والتنبُّه مطلوبين، في ظلّ الخوف ممن يسعون إلى تكرار تجربة العراق في لبنان.
ومن هنا، لا بدّ من أن نقدّر كل المواقف الأخيرة من بعض القيادات السياسيّة والدينية، التي دعت إلى تكريس خطّ الاعتدال في مواجهة التكفير، وتعميق ذهنية الوحدة في مواجهة الانقسام، وتعزيز منطق الدولة على حساب منطق الدويلات، ونأمل أن تترجم هذه المواقف بالعمل الجدي في معالجة المشكلات الأمنية، ودعم الجيش وتقويته، لحفظ الاستقرار والسيادة، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتحريك عجلة المؤسسات الدستورية، ولا سيما المجلس النيابي، بأدواره التشريعية والرقابية، وحل المشكلات الاجتماعية، انطلاقاً من سلسلة الرتب والرواتب، بطريقة تؤمن حاجات المواطن، ولا تخل بالتوازن الاقتصادي، وصولاً إلى حل أزمة الكهرباء والماء والنفط وغير ذلك، مما هو عالق وينتظر المعالجة.
ولا بد لنا، وفي إطار الحديث عن المؤسسات، من أن نطالب بعدم استمرار العبث بها، ولا سيما المجلس النيابي، لكونه مؤسّسة المؤسّسات، من خلال فرض منطق التمديد لمجلس هو في الأصل لا يجتمع.
إننا ندعو الحكومة التي تتمثل فيها كل القوى السياسية الفعالة، إلى دراسة كل السبل التي تساهم في إجراء الانتخابات النيابية، التي نرى أن بالإمكان إجراءها، فقد جرت الانتخابات في أكثر من بلد من حولنا، كانت ظروفه الأمنية أصعب من الظروف التي نعيشها.
وطبعاً، لا يعني ذلك التخلّي عن الدعوة إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وإزالة كل الحواجز التي تحول دون إتمام هذا الاستحقاق، وهذا ما نراه ضرورياً، وإن كان بحاجة إلى توافق بين الدول الفاعلة في لبنان، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.
ومن لبنان، نطل على العراق الذي استطاع، وبوعي قياداته، أن يتجاوز القطوع الذي مرّ به في موضوع تعيين رئيس لمجلس الوزراء. لقد أكَّد العراق وجود رجال فيه يتعالون على الجراح وعلى ما يعتبرونه غدراً وخيانة، وعلى كل الحسابات والمصالح الذاتية، وينطلقون من القاعدة التي أرساها أمير المؤمنين(ع) حين قال: "لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين"، ليقولوا: لأسلمن ما سلمت أمور العراقيين.
إننا نريد للعراق أن يبقى ساحة للوحدة؛ الوحدة الإسلامية والوطنية، والوحدة بين كل مكوناته. إن كل المكونات العراقية، بوحدتها وتآلفها في حكومة جامعة، هي الضمانة لخروج العراق من أية فتنة يراد لها أن تصيب هذا البلد في الصميم، وخصوصاً في مواجهة كل أولئك الذين يريدون توجيه السهام إلى الداخل، بدلاً من أن توجه إلى العدو الخارجي؛ عدو جميع العراقيين.
إننا نرى أنّ التغيير في العراق لا يتحقق فقط بتغيير الحكومة، كما يتحدث البعض، بل بتغيير الذهنية في إدارة الحكم، والخروج بالعراق من كونه دولةً تمثل تجمّعاً للقوى السياسية وللطوائف والمذاهب، إلى دولة يلتقي الجميع على بنائها، لتكون دولة عادلة تحتضن كل العراقيين، ويكون عنوانها: "القوي العزيز عندي ضعيف ذليل حتى آخذ منه الحق، والضعيف الذليل عندي قوي عزيز حتى آخذ له بحقه".
ونعود إلى فلسطين، التي نرى في كل يوم صمودها وثباتها، في مواجهة غطرسة العدو وآلته العسكرية، سواء في غزة، أو على المستوى السياسي، في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى عدم إعطاء الفلسطينيين أي مكسب، ويراهن على القبول بشروطه، نتيجة ما حصل من دمار، أو على التهويل الإعلامي والعسكري، والحديث عن استدعاء الاحتياط.
إننا نشدّ على أيدي أهلنا الصّابرين في غزة، ونقول لهم: إنّ العدو الذي أربكتموه في ساحة الميدان، هو مربك في السياسة أيضاً، ومن الطبيعي أن لا يأخذ في السياسة ما عجز عنه في المعركة، فحافظوا على وحدتكم وتماسككم وبقائكم، و{اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
المكتب الإعلامي لسماحة العلامة السيد علي فضل الله